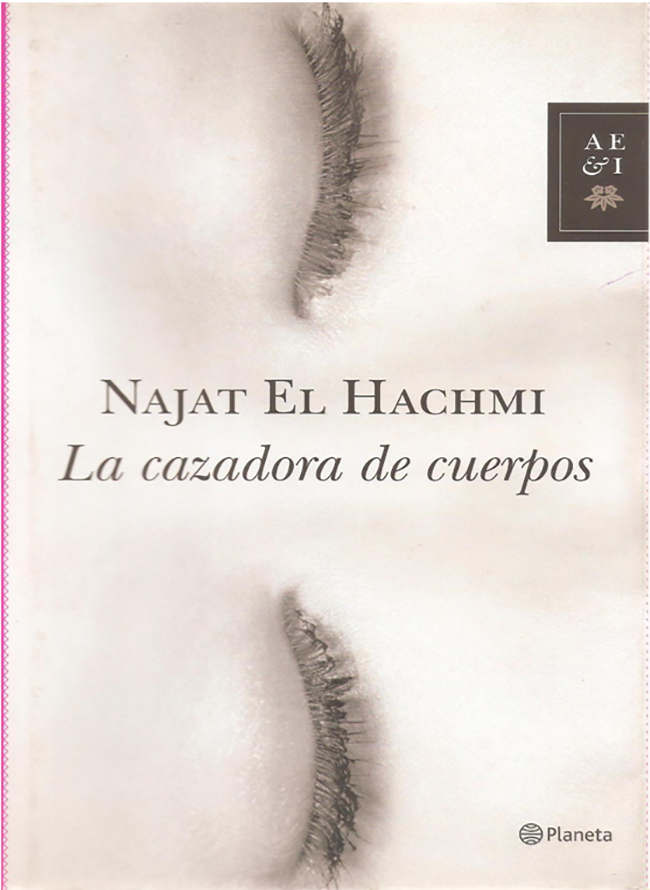كان لون المغربي أزرق. نعم، أعرف أنه من المضحك أن يتذكر المرء أشخاصا بحسب ألوانهم. لكن هكذا كان يبدو لي الأمر. لا، لم يكن مبقرعا بالأزرق ولا شبيها برجال الصحراء. كل ما في الأمر أنني كلما حاولت أن أتذكره يحضرني هذا اللون. ربما يعود ذلك إلى الظرف الذي عرفته فيه؛ يمشي بين حشد من البشر بأحد أزقة المدينة، وقد كانت السماء شديدة الزرقة، ومزركشة بسحاب شديد البياض يشبه لون السكر. ظهر يتعثر الخطوات وهو ينظر إلي بنظرات قوية شبيهة بلون السماء. نظرت إليه وابتسمت فقط لأني فتنت بعيونه التي أثارت انتباهي وسط حشد من معاطف يملأها السواد… ابتسمت بصدق، كما لو أنه لم يسبق لي أن تعرفت في حياتي على رجل يملك كل هذه الثقة الزائدة بالنفس.. ثقة تجعلك تبتسم دون خوف أو ارتياب.. وبعد برهة من الزمن، وأنا أتابع سيري منتشية بالأزرق، سمعت صوتا يناديني ويلح علي بالانتظار: “انتظري، انتظري.. لا تسرعي”. وبما أنني لست غريبة عن المكان، فقد فاجأني أن يطاردني صاحب هذا الصوت. لأن المعروف عندنا أن الأجانب هم وحدهم من يتحرشون بالنساء في الأزقة والشوارع.. فلم أتصور على الإطلاق أن يكون هو نفسه؛ بلون جلده الذي يشبه جلدي، وعيونه التي ليست بالغريبة عني، وشعر أشقر يميل إلى السواد، جعله يختلف عن الآخرين.. أحسست بشيء من الغبن أن تفوتني، وأنا المتخصصة في ذلك، معرفة هذا النوع من الرجال، وعدم تمييزه من بين هذا الحشد من الناس. تابعت سيري بخطى سريعة كما لو أنهم سيلقون علي القبض، ولذت بالفرار. وهو ما حصل بشكل من الأشكال.. بعد ذلك تذكرت حوارا جرى بيني وبينه بإحدى مقاهي المدينة. تساءلت كيف أمكن لهذا الحوار أن يتوقف هناك؟ تابعت خطواتي، وقد هجرتني الابتسامة، وأنا أتساءل كيف أمكن لي أن أقول له، وقد ناداني، إن الموضوع ليس موضوعه. اقترب مني وقال لي بقليل من التملق أنه ظل يتعقبني مدة ليست بالقصيرة؛ وهو ما جعلني أقبل للتو دعوته لاحتساء فنجان قهوة معا بأحد مقاهي المدينة. أتذكر أني كنت أضحك كثيرا. لكن الخطأ، كما أشرت، خطأ هذه السماء…
تذكرت أيضا تلك الملعقة الصغيرة التي كنت أحركها داخل فنجان القهوة لخلط الحليب. تذكرته وهو يتحدث إلي بشكل بارع. تحدث عن أشياء كثيرة؛ تحدث عن حياته وعن عائلته وعن رحلاته.. كان يبدو في هيئة أنيقة. لكن في تلك اللحظة لم يتبد لي منه غير جبهته البارزة، التي جعلتني أفقد قدرتي على الابتسامة. كنت ساعتها لم أر بعد عيونه الزرقاء، فقط جبهته البارزة التي غطت كل جسده.. أولد هكذا، بهذه العيون الزرقاء؟ وكيف فاتني أن أراه من قبل؟ لم يتوقف عن الكلام لمدة طويلة. وضع يده فوق يدي، وضغط عليها بقوة وهو ينظر إلي في صمت. لم أستطع أن أتمالك نفسي من الضحك بسبب هذا المشهد المسرحي، الذي يشبه تماما تلك المسلسلات الغرامية التي يقضي فيها العشيقان زمنا طويلا، قبل أن يجد أحدهما نفسه، وبشكل فجائي، مرغم على البوح بحبه للطرف الآخر. ظلت نظراتنا تتقاطع إلى بعضها البعض بشكل مثير، على إيقاع موسيقى منفرة وأزيز ضوء خافت يمنع من أن يستمر المرء في إخفاء أحاسيسه. أحسست أن الدقائق القليلة التي قضيناها معا وكأنها صارت أياما أو أسابيع أو شهور، بل وسنوات. لكن مع ذلك، انتهيت إلى أن أعرف مواطني المغربي، وأن المدة القصيرة التي قضيناها معا كانت مدة حقيقية، بسبب المجهود الشخصي الكبير الذي بذلته لتحويلها إلى لحظات بيضاوية الشكل.
دعاني لزيارته في بيته الذي لا أعرف في أي مدينة أو قرية يوجد. فاعتذرت له، لأن ظروف العمل لا تسمح لي بذلك. “هل تعرف أنني أشتغل طيل الليل؟ أرى من الأفضل أن نبقى أصدقاء، وأن أراك مرة ثانية وثاثة …”. فأنا من طبعي أن يفقدني الإلحاح الكبير كل الاهتمام. وأعرف أن مجرد التفكير فيه قد يجعله يسكن قلبي مدى الحياة، مما يصعب تفكيك ما بنيناه معا حتى الآن. أعي ذلك جيدا؛ لأنه سبق لي أن اشتغلت في فتق الملابس، ووجدت أن فتق الملابس أصعب من خياطتها. رافقني حتى المحطة. وبينما نحن ننتظر القطار أمسكني من يدي وهو يعبر لي عن سعادته بهذا اللقاء. بالنسبة لي، فإمساكي من يدي يعطيني دائما إحساسا بالخوف، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بشخص غريب عني. وعلى وقع رائحة الحديد التي تنبعث من اسلاك السكة الحديدية بفعل الاحتكاك، أمسكني من خصري وسألني: متى أراك؟ لا أدري، أجبته. أحسست بشيء من الغثيان، وانكفأت بعض الشيء على نفسي وتساءلت: لماذا يحسن الكلام بهذا الشكل المثير؟ فلو لم أر وجهه عن قرب لظننت أنه مختلف عن الآخرين.. عزيزتي يجب أن نفكر في مستقبلنا. عزيزتي؟! مستقبلنا؟! أحسست أن الوصول إلى هذا المستوى من الخطاب يفرض علي أن أسارع الخطى، لولا أن يده التي تحاصر جسدي فرضت علي شيئا من الحذر…
ألح علي كثيرا، وكان يهاتفني في كل وقت وحين، مما جعلني أقرر زيارته في بيته ذات سبت. ركبت القطار ووصلت المحطة التي أشار علي أن أنتظره بها. كانت محطة متهالكة، غير مبلطة الجدران ويغطي “الغرافيت” واجهتها الأمامية بشكل أرعن. وقفت أنتظر قدومه لوحدي في مكان خال ومعزول، خاصة وأن المحطة بعيدة عن القرية التي يقيم بها. كان اليوم نهارا، والسماء لا تشبه البتة سماء ذلك اليوم الذي تعرفت فيه عليه أول مرة.
وصل متأخرا بعض الشيء وهو يركب سيارة صغيرة ذات لون رمادي. وأذكر أننا ذهبنا مباشرة إلى الدار، دون أخذ قسط من الراحة بأحد المقاهي المجاورة أو القيام بجولة صغيرة بالقرية، أو على الأقل الحديث في أمور عامة.. كانت هناك دور متزاحمة فيما بينها، ملأى بأدراج كثيرة هي نفسها التي يستعملها السكان كأزقة للعبور إلى سكناهم. لا أعرف إسم القرية. كل ما أعرفه أنها تقع محادية لجبال غريبة لم تتوقف عن النظر إلينا. البناية ليست قديمة ولا هي جديدة؛ هي نفسها ترتبط بأدراج توصلك مباشرة إلى شقة مواطني المغربي. شقة تنبعث منها رائحة، لا هي برائحة الطعام ولا رائحة العفونة أو تفوهات النائمين، ولاهي برائحة العطور. وللأسف الشديد، فأنا دائمة الخوف من الروائح التي لا أستطيع تحديد كنهها. ورائحة المغربي، كما سبق أن لاحظت على ثيابه حينما ركن السيارة وشرع بعجالة يقبلني وهو يحدثني بلسان لا أعرفه كثيرا، ويمرر يداه على كل جسدي، أنها رائحة غير مفهومة. وصلت إلى شقته وأنا أحس بنوع من الإرتباك، زيادة على الإزعاج الكبير الذي بدأت تسببه لي هذه الرائحة. بدا لي أنه يقتسم الشقة مع أناس آخرين، يظهر أنهم قد انتهوا للتو من تناول وجبة الفطور. وبما أن بيته كان أول ما يصادفك على اليمين بفناء الشقة فقد كان لزاما علينا توجيه التحية لزملائه، وذلك قبل أن نتسلل إلى غرفة نومه. كانت الغرفة مكدسة بالأثاث، لدرجة لم يدع معها فرصة لانبعاث أي نوع من الروائح بسبب عامل الرطوبة التي تجتاح المكان: بطانية رمادية، لا شك أنها من أغطية العسكر، وسرير مسنود إلى ركن الغرفة، تجاوره طاولة تنوء بحمل أشياء كثيرة. وملابس متسخة منتشرة في كل مكان. تساءلت: ما دام يعرف أنني سأزوره في بيته فلماذا لم يقم، على الأقل، بإخفاء هذه الملابس المتسخة؟ ألا ترى، سألته، أنه ينبغي على الرجال أن يظهروا شيئا من الاهتمام ولو بتلطيف الجو بمسحوق عادي؟ جلست فوق سرير لا يتوقف عن الحركة والأزيز، بينما مواطني المغربي يحاول بيديه المرتعشتين وعينيه البارزتين،وقد تحول لونهما إلى لون رمادي غامق، خلع قميصي على وجه السرعة. طرحني فوق السرير، وقد بدأت تتناهى إلى سمعي أصوات الرجال وهم يتحدثون بلغة لا أعرفها. هل يصلهم صوت هذا السرير الصدئ؟ وهل يعلمون أن صديقهم يوجد مع فتاة بغرفة نومه؟ ثم لماذا صارت هذه الأمور،وبشكل فجائي، تشغلني إلى هذا الحد؟ انقض علي مواطني المغربي بقوة حتى ارتطم رأسي بالجدار. وحتى أشغل نفسي عما يجري، انتقلت بعناي أنظر إلى جورب كستنائي اللون، تتخلله بعض الثقب، وتبابين بيضاء مبقعة، وأوراق مكومة فوق ركام من الملابس، وحيطان بيضاء تتخللها مساحات تساقط منها الطلاء حتى بدا الإسمنت للعيان. لقد أحزنني ألا أكون ببيتي في هذه الساعة، خاصة عندما صرخ مواطني المغربي صرخة قوية سقطت معها قطرة من عرقه على عيني. إنك لا تتصور مدى الاشمئزاز الذي يمكن أن تسببه مثل هذه القطرات من العرق. صحيح أن هناك قطرات أخرى يمكن أن تستقبلها كهدية.. لكن في حالة مواطني المغربي بدا الأمر مختلفا تماما.
أتذكر نهاية هذه القصة. عدت مرة واحدة لا أكثر؛ لأني كنت أود القيام بجولة لسوق أسبوعي يوم الأحد، يقع على سفح صخور كنا نتأملها تحت غيوم رمادية تنذر بالعاصفة. قلت له إن الوقت جد متأخر، وينبغي أن أغادر، فأنت تعرف أنه ينبغي علي ركوب قطارين للوصول إلى بيتي. لابد، قلت مع نفسي، أن تنتهي هذه القصة كما باقي القصص الأخرى. هاتفني أكثر من مرة فلم أجبه، حتى تيقنت أن التعب قد ناله.
ترجمه عن الإسبانية: أحمد بومقاصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ مقطع من رواية “صيادة الأجساد” للروائية المغربية نجاة الهاشمي المقيمة بإسبانيا