بهذه الحكاية الصغيرة، أفتتح الكاتب الروسي ” أندريه سينيافسكي” مقالته ” أنا وهم” ممهداً بذلك إعادة طرح مفهوم “الاتصال ومعنوياته الدلالية” لدى المساجين في تجربتهم مع السجن أو (المعتقل). ومن خلال تجربته كمعتقل سياسي سابق في الإتحاد السوفياتي قبل انهياره، أستطاع ” أندريه سينافسكي” أن يثير من جديد إشكالية الاتصال هذه الخاصية- التي تميز النوع البشري ومقوماته الحضارية ليبين لنا إلى أي مدى يعاني هؤلاء المساجين أو المعتقلين من مشكلة الاتصال مع الآخر.
الإتصال ومعنوياته الدلالية
حين نتحدث عن الاتصال، فإننا نعني مباشرة تلك الأفعال المادية، الإيمائية منها واللغوية وغيرها التي تشغل وظيفة الوسيط بين ” الأنا” و ” الآخر” في المجتمع البشري.
فالمجتمع البشري لم يحقق تطوره التاريخي والمجتمعي، إلا بفعل تقريب وتطوير وسائل الاتصال وأدواتها، وكانت النتيجة أن اتخذت هذه الوسائل والأدوات معنويات دلالية اصطلاحية عن طريق “التصويت – اللغة” من أجل تطوير قدرة الإنسان وكفاءته على الاتصال، فالتنظيم داخل وحدة اجتماعية مميزة بطابعها “السوسيو ثقافي”. وإذا كنت قد آثرت إشكالية الاتصال هذه، فلهدف واحد فقط، وهو التركيز على طابع الاتصال العام ألا وهو ” اللغة” وعلاقتها بالكائن البشري.
مما لا جدال حوله، أن اللغة بنوعيها: (الشفهي والكتابي) تحتل الوسيط الاتصالي الأسمى في مجتمعاتنا الحالية، إلا أننا كثيراً ما نعجز أمام اللغة وباللغة عن التعبير عن مقاصدنا، رغباتنا وإرادتنا. وكثيراً أيضاً ما تحمل اللغة ونقصد “القرينة الباطنية “، مفاهيم دلالية محتجبة تختلف اختلافاً تاماً عن سطح التعبير اللغوي “plan de l’expression linguistique” بنوعيه. وحول هذا المحتجب الذي أدعوه بـ “القرينة أو السياق الباطني – contexte intérieur”، أريد أن أعيد قراءة مقال (أندريه سينيافسكي). لأن السياق أو القرينة الباطنية، تساعدنا في فهم الرسالة الدلالية التي نتلقاها من الأنا الذي يتألم. أي من الآخر الذي بعد فترة اعتقال طويلة، يكون قد فقد الوسائل الدلالية المعتادة لديه، بسبب الوحدة والعزلة الإجبارية، وأتجه لاستنزاف ما تبقى من ذاته في سبيل قول شيء ما.. ! نجهله أو نتجاهله حين نرفض خصوصيات اتصاله بنا. وهكذا نكون قد عدنا إلى إعادة طرح التساؤل نفسه الذي سبق وطرحه “أندريه سينيافسكي”: “ترى ماذا كان يود قوله بكل هذا ؟”
أزمة المكان و أزمة الحوار:
أريد أن أخصص هذا السؤال المتسائل عن السجين وعلاقته بالسجن، خصوصاً المعتقل السياسي أو السجين السياسي. إن أول ما يعصف بالسجين هو هذا الانقلاب الفجائي الذي يعصف بحياته. فالمكان بكل جمالياته النسبية يصبح ذو طابع جمالي مغاير، وإن يتحدد مكان السجين مقيدا، بعد ما كان حراً طليقاً بأربعة جدران ضيقة، تشكل لديه كل ما تبقى من حياته. أو كما يقول سجين أفريقيا الجنوبية الشهير، (برايتن برايتنياخ)، تحت حكم “الأبارتايد” العنصري: “حجرتي لا تتجاوز المترين عرضاً، وبإمكاني لمس الجدران أذا فتحت ساعدي، وهي لا تتجاوز ثلاثة أمطار طولاً، والذي كان ينقصها نجده حتما في الإرتفاع الذي يقاس بخمسة امتار تقريبا “. إذاً فمفهوم الأتصال هنا لدى (برايتن برايتنباخ)، قد أتخذ شكلاً جديداً في التعبير عن المستويات القياسية لزنزانته. وهذه الجزئيات المكانية التي يقصها لنا السجين، تقدم لنا مفهوماً جديداً للمكان الخالي من أية جمالية تذكر، لأن الإنسان عادة، ومن خلال تجربته مع المكان، يدخل في علاقة نفسية معه ويصبح بعد مرحلة معينة من حياته، مرجعه الجمالي الأساسي. والدليل على هذا، مفهوم الحنين لدى الكائن البشري. والذي غالباً ما يتمثل لديه في بيت طفولته أو وطنه أو أي مكان آخر ذا قيمة لديه. ولكن السجين بحكم فرض المكان المقيد عليه، تصبح حالته النفسية أيضا محكومة بهذا الإطار المكاني. لذلك يسعى السجناء عموما إلى الإتصال بنا عبر طريق أسلوب مفصل يحسب لكل ظاهرة أو جزئية حسابها. ولنعد إلى مقال “أندريه سينيافسكي” لنوضح وسائل الإتصال الإستفزازية أو المستفزة عن طريق السياق الباطني. يرى “أندريه س” أنه من خلال وجهة نظر معينة، أن طريقة الإنسان المعاشية في المجتمع، ليست إلا إحدى وسائل الإتصال مع الآخر. ولكن هذا الأسلوب المعاشي العادي، قد يتخذ له شكلا اتصاليا جديدا لدى السجين. خاصة حين يشعر هذا الأخير، بأن فترة سجنه قد تطول إلى أمد غير محدد، فيقوم حينها بممارسة وسائل عنيفة على ذاته. كأن يلتهم معلقة أو يدسها في مؤخرته، أو أن يشرب دمه أو يأكل لحمه. أو كما يروي الكاتب نفسه، عن هذه الحالة الغريبة التي شاهدها: “كان ثمة في السجن رجلان: أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد ومصاب بمرض “اضطراب الشخصية psychopathie ” يقيم مع سجين آخر اسمه “موش” يقوم معه بدور العشيقة. وكان الإثنان حين حلول عيد ميلاد رأس السنة، يحتفلان بدورهما، إذ يفرغ المريض سائله المنوي بصحن ويرش عليه دما. وبهذه الطريقة يقتسمان هذا النبيذ “الميثولوجي” بمناسبة إعلان مشاركتهما في الإحتفال. وبهذا الأسلوب الذي يمارسه هذان السجينان، تختفي اللغة وتتوارى، بل تفقد قيمتها الدلالية ويحل محلها الجسد، ليصبح الملكية الذاتية الوحيدة التي تبقى في متناول يد السجين كآخر ما تبقى. والقرينة الباطنية في هذه الحادثة، تعلن لنا عن الرسالة الأخيرة التي يحتج بها هذان الأخيران. إن الجسد يصبح لدى السجين، مكانه الوحيد الذي يستقر فيه بعدما ينزع الآخر منه حريته. ويصبح أيضا، الواجهة التي من خلالها يتوجه السجين بخطابه الرمزي إلى الآخر، ليعلن له رفضه للوضع الذي يعيشه. وثمة بعض ظواهر احتجاج أخرى، تحمل دلالات عميقة في رسائلها المحتجبة ضمن السياق الداخلي. ويروي لنا “أندريه سينيافسكي” بهذا الخصوص قائلا: “لنأخذ مثلا، ظاهرة معروفة لدينا بشكليها الفردي والجماعي منذ مدة طويلة، ألا وهي ظاهرة الإضراب عن الطعام. هذه الظاهرة هي الرمز المباشر للموت متمثلة في حدودها القصوى أمام الآخر أيضاً، وللمرة الأخيرة يعلن السجين عن رفضه القاطع لمواصلة الأتصال مع الآخر الذي يفرض نفسه عليه في علاقته معه، ويعلن أيضاً عن رفضه للنظام المفروض عليه ولطريقة الأتصال المبتذلة .
إذن، فالسجين مبدئياً لا يرفض الطعام من أجل الطعام، وإنما يحاول أن يحتج بطريقة اتصال جديدة، يتخذ فيها جسده الإطار الذاتي المباشر، ومثلما يضرب هؤلاء عن الطعام، يعتمد آخرون إلى استحداث وسائل أخرى. فظاهرة الإضراب عن الكلام مثلاً، حين يكف السجين عن الكلام مع المشرفين أو الجواب عن الأسئلة التي يوجهها له المسئولون. وبشكل عام، الكف عن الكلام قطعياً دونما تلفظ بأية كلمة، ومع ذلك يتابع الحفاظ على عمله وكل المهام المتعلقة به داخل السجن.
ويرى (أندريه- س): ” أن الذي لا ينبس ببنت شفة، إنما يرمز بالمقابل إلى الرفض المطلق والاحتقار الكلي للغير، للآخر الشبيه (الإنسان) كمقابل. والصمت احتجاج أفظع من الإضراب عن الطعام وأفظع مع الانتحار. لأن الصمت يولد شبهة كئيبة لا يمكن إيصالها عن طريق اللغة، وكل هذا إلى جانب افتراس الذات “autocannibalisme”. فعبر الإضراب عن الطعام والكف عن الكلام، تتخذ وسائل الأتصال لدى السجناء شكلاً دلالياً جديداً، ويصبح “الأنا” الذي يعاني، متميزاً بوسائل اتصاله مع “الآخر” الذي يستهين بوجوده ، يستصغره ويتجاهله.
والقرينة الباطنية تكمن هنا، في إمكانية تفسير هذا الحقل الدلالي الذي يستحدثه السجين. لأن كل الوسائل التقليدية تصبح غير ذات قيمة لديه. لذلك لا نستغرب هذا التوجه الذاتي الذي يمكن أن يمارسه السجين على نفسه. وفي إطار غياب الآخر كمحاور ومشارك في الحوار، يتراجع السجين إلى أقصى حدود عزلته ليجعل من جسده نافذتين: واحدة للموت والثانية للإنتقام من الجنس البشري.
برايتن برايتن باخ أو العائد من مقبرة الموتى
ما تزال طاحونة السجن تصنع من المساجين مجرد خرق هيكلية تصدرها تارة إلى المقبرة وتارة إلى الألم الأقصى، ومع ذلك لم يعمل الرأي العام أو الحكومات المعنية إلا على تعميق ألم هؤلاء، دونما أية محاولة اتصال جادة للتعامل مع المساجين. إن الإنسان يزج به في السجن لمجرد إفصاحه عن رأي سياسي معين، لعمري تلك بداية اللعنة وخاتمتها على النوع البشري.
ولننتقل إلى المعتقل السياسي سابقا “برايتن برايتن باخ”، في أفريقيا الجنوبية تحت إدارة حكومة التمييز العنصري ” ألأبارتايد” “Apartheid”. لنرى إلى أي مدى، تتداخل، تتشابه وتتقارب تجربته مع “أندريه سينيافسكي”، علما بأنهما تجربتان مختلفان في المكان والزمان. والحديث بالمناسبة، عن تجربة سجين بعدما وصل إلى قمة معنوياته وسخطه مع “أندريه سينيافسكي” فإنه مع “برايتن برايتن باخ” قد اتخذ له طابعا سرديا هادئا ومؤثرا في الوقت نفسه.
وتشكل ظاهرة العزلة، المحور الأساسي لتجربة “برايتن برايتن باخ” إذ يقول: “كنت في عزلة تامة، والعزلة تعني، أن لا أرى وأن لا أتصل بأي سجين آخر. فقط، حين يمررونني بالممر فأصادف أحد المساجين مشتغلا بتنظيف البلاط”. إن اتباع هذه السياسة القمعية، هي بالدرجة الأولى نفي لخصوصيات الآخر (السجين)، الإتصالية. وبالمناسبة، قتل غير معلن لعاداته المكتسبة. وكما يصرح “برايتن برايتن باخ”: ” خلال هذه الليلة الأولى شعرت – وهذا تأكد لي فيما بعد – بأن هذا المكان، هو مكان للموت نفسه. إنه المكان الخفي، حيث يقاد الناس من أجل أن تقتلهم السلطة ببرودة أعصاب. إنها حقيقة الحراسة العليا – terminus- ببيت الموتى”. إن هذه العبارة الأخيرة، تذكرني بالكاتب الروائي “دوستويفسكي” حين الإفراج عنه في اللحظة الأخيرة بعدما كان حكم الإعدام قد صدر بحقه. ويروي “دوستويفسكي” بأن هذه الفترة الزمنية التي عاش تجربتها خلالها بين أعواد المقصلة وبعدها، قد غيرت من مجرى حياته كليا. وأنه أصبح إنسانا آخرا، غير ذاك الذي أعدم في نظره وذهب إلى المزبلة التي ندعوها “إنسانية”.
إن الوسائل القمعية التي تخولها السلطة – كيفما كان نوعها – للمسؤولين والمشرفين عن حياة المساجين، تضرا ضررا كبيرا بالنوع البشري. خاصة وان السجين بمجرد ما يدخل السجن، يجرد من جميع خصوصياته الإجتماعية، باستثناء جسده الذي يبقى خشبة مسرحه الأخير للإنتقام من الآخر بطريقة معنوية. فانطلاقا من حلق الرأس بطريقة عنجهية، إلى تثبيت الرقم الرسمي على ياقة قميص السجين. يتحول هذا الأخير إلى مجرد رقم لا غير. عليه أن يستجيب إلى كل الأوامر المرتبطة بأخلاقية السجن الرسمية – التي برمجها الوصي المكبوت- له. علما بأن السجين بصلابته وصموده، يبتكر وسائله الفنية الخاصة به للإتصال بالسجين الآخر أو القيام بعرقلة أخلاقيات المراقبين الرسميين له. فمثلا، إن عملية الدق على الصحون بطريقة معينة، هي عمليا أسلوب حوار مع الآخر الذي يتواجد في الزنزانة المجاورة له. وظاهرة الإنتحار أو ما شابهها، هي رد فعل إيجابي للسجين على أخلاقيات المراقبين الرسميين الذين يرفضون أو يتجاهلون الإعتراف بالجنس البشري، ويعتبرون هؤلاء المساجين مجرد حيوانات غير مؤدبة (بلغتهم الرسمية). وكما يقول “برايتن برايتن باخ” متابعا: “ينكت السجين بسخرية متعالية عن الحراس. مثل نكتة ذلك الطفل الصغير الذي يسأل أباه عن هل بإمكان الذكور أن ينجبوا أطفالا؟ والأب الذي يجيبه ” بالطبع… من أين تعتقد جاء حراس سجن بوتا… !” فمثل هذه السخرية، تعد كظاهرة من ظواهر أدبيات السجن التي يجد فيها السجين متنفسا عن حالته النفسية.
وكما يتخذ المرجع المكاني تصورا جديدا في حياة المساجين، كذلك يصبح العامل الزمني مجرد فترات متقطعة ومنفصلة عن العامل التاريخي الطبيعي. فهنالك من يصبح الزمن لديه، مجرد لحظة مختطفة من شهر، حين يسمح له بمقابلة أحد زواره من وراء زجاج فاصل. وكما يقول “برايتن براين باخ” : “كان الشهر لدي معلما بثلاثة عناصر مهمة، لأنها كانت تخول لي الإتصال بالعالم الخارجي: مرة في الشهر كان يسمح لي بتلقي رسالة أو بعث رسالة واحدة. وبالطبع كان يسمح لي أيضا بتلقي زيارة نصف شهرية، هذه الزيارة التي كانت تتم في حجرة صغيرة تفصلك عن زائرك بزجاج سميك”. وهنالك أيضا من يصبح الزمن لديه، عبارة عن انتظار تلك اللحظة التي قد يغادر فيها السجن. وهنالك من يفقد الزمن السّجني بالنسبة له، كل قيمة زمنية تذكر. وأتذكر بأنني رأيت أحد المساجين يتقدم بشكوى إلى أحد المختصين بشؤون السجن والسجناء (عبر ندوة تلفزيونية)، عن تجربته في أحد سجون بلجيكا. وقد بدى جد متأثر بظاهرة الزجاج الفاصل بين السجين وزائره، حين قال: “كيف يمكنكم أن تتصوروا أبا بحاجة إلى تقبيل طفله من وراء زجاج عازل لهما.. إنها لعمري أقصى ما عانيته في سجني.. ! “. ومما لا شك فيه، أن هذا السجين من خلال تجربته القاسية، يسعى أن ينقل للآخر، التساؤل نفسه الذي سبق وطرحه “أندريه سينيافسكي”: ” ترى ماذا كان يود قوله بكل هذا..؟”
النقمة وأدب السجن (جان جنيه، محمد الأشعري، ريجيس دوبريه وأنجيلا ديفس)
بالرغم من هذه النقمة العامة على ظاهرة السجن، فأن ثمة بعض المساجين الذين استطاعوا أن يبلوروا من داخل الزنزانة أدباً ذا طابع إنساني عالمي، فالكاتب الفرنسي (جان جنيه) الذي رفضه المجتمع كلقيط لا جذور له، ورفضه السجن كحيوان غير مرغوب فيه، أستطاع أن يقدم للعالم البشري الخارجي الذي يتمتع بحدية مزاجه ونظمه التعسفية، ملامح إنسانية عميقة في دلالاتها ومعنوياتها. ولم يكن الفيلسوف الفرنسي (جان بول سارتر) ونخبة من الكتاب الفرنسيين، ليتقدموا إلى المحكمة العليا بطلب العفو عن السجين (جان جنيه)، لولا أنه قدم لهم أدباً مسرحياً وشعرياً وروائيا واقعياً في معاناته ودلالاته.
وقد عاش التجربة نفسها، كل من أنجيلا ديفيس من “يومياتها العادية”، والشاعر المغربي محمد الأشعري من ديونه “عينان بسعة الحلم”، ورجل الثورة ومنظرها (روجيه دو بريه) من كتابه “بين نارين وأربعة جدران”، والشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي من روايته “مجنون الأمل”. وثمة آخرون كمحمود درويش من يومياته “أثر الفراشة” وغيره، قد أدهشوا العالم حقا بصراحتهم وقدراتهم الأدبية المتميزة. ولنستمع إلى هذه الصرخة التي كان يصرخها “روجيه دوبريه” في وجه العالم، حين نفذت قضبان السجن عميقة ومؤلمة في ألم عزلته: “إن العالم هو كوكبة من الخلايا صغيرة مقفل عليها مع سجين خلف الباب… هناك دائماً في مكان ما في أعماق قلبك، كلمة تترقب بانتظار أن تطلق سراح سجين انتفض وأيقظها…”.
– ترى.. ماذا كان يود قوله بكل هذا؟
إن الإتصال بالآخر عن طريق أدبيات السجن، هي الوسيلة الوحيدة والسلاح المعنوي الوحيد لمواجهته على حلبة ثقافته. ولئن كانت ثقافة السجن تأتي في غالب الأحيان، مطبوعة بطابع النقمة والتمرد والتجاوز، إلا أنها تظل مع ذلك أدبا متميزا من بين الأدبيات العالمية. وخاصية هذا الدب الآسر/ المأسور، أنه يستطيع أن ينفذ إلى ما وراء الكلمات إلى الحقل الباطني ليعريه من كل قشور الإلتباس والغموض، فيأتي المعنى الدلالي واضحا وصافيا وخاليا من كل تقرير وصفي، وحاملا بكل زخات ومعاناة الشاعرية البشرية. وكما ينشدنا محمد الأشعري” من قصيدته “التفاصيل” :
“سبعة عشر حولا
والفارس يقهر القلعة الإسمنتية باطمئنانه
الصاخب
ويستمع بكامل وعيه لأهازيج الرحل تخرج من
عمق الصخور
الرصاصية
من عمق
لحظات الغضب الخيرة”.
في هذا المقطع الشعري الحر، نصادف كل معاني الحياة، إذ تتحول الصخور الرصاصية إلى نافورة أهازيج، تحمل إلى السجين ثقته بجماليات الأشياء التي قد يمر بها الآخر مرور الكرام. وهذا الإحساس الشعري المنفرد والمباشر، يغني السياق الباطني للنص الشعري ويفضي عليه مسحة جمالية ذات ملامح إنسانية مؤثرة. فيأتي كذلك، كأسمى “وسيلة سلمية” من وسائل الإتصال مع الآخر.
وأخيراً وفي انتظار توطيد أسلوب اتصالي واقعي مع هؤلاء المعذبين في الأرض أترك الكلمة الأخيرة للمناضلة البولونية (روزا لكسمبورغ): “عنف الصدمة الأولى يخبو حين تصبح الصدمات يومية” .
بقلم فؤاد اليزيد السني – بروكسيل – بلجيكا 15-08-2019
هذه الدراسة قد سبق ونشرتها باللغة الفرنسية في مجلة ” L’alternative” التي كانت تصدر بفرنسا وقد نشرت تحت عنوان “La parole bâillonnée”. وارتأيت إعادة نشرها باللغة العربية بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها.
المراجع:
– Messieurs, la Cour, 1956
– Lioubimov, 1963
– Une voix dans le chœur, Seuil, 1974. L’ouvrage est une chronique de ses années de détention.
– André Siniavdki, Moi et Eux, sur quelques formes de la communication dans les conditions de solitude. La Reloi, 37. 13 septembre 75.
– Document, dans les prisons d’Afrique du Sud, Breyten Breyten Bach, J.A.M.numéro 6. Juin 1984. P8.
– L’Œil se noie, Les Mains parallèles et La Conspiration, trois pièces de théâtres inédites écrites entre 1949 et 1950
– Peau noire, masques blancs, 1952, rééd., Le Seuil, col. « Points », 2001
– L’An V de la révolution algérienne, 1959, rééd., La Découverte, 2011
– Les Damnés de la Terre, 1961, rééd., La Découverte, 2002
– Pour la révolution africaine. Écrits politiques, 1964, rééd., La Découverte, 2006
– Œuvres, La Découverte, 2011.
– Écrits sur l’aliénation et la liberté, La Découverte, 2015. Recueil d’écrits psychiatriques : articles scientifiques, thèse, articles du journal intérieur du pavillon de l’hôpital de Blida-Joinville de 1953 à 1956, deux pièces de théâtre écrites à Lyon durant ses études de médecine (L’Œil se noie et Les Mains parallèles), correspondance et textes publiés dans El Moudjahid après 1958, non repris dans Pour la révolution africaine.
– Écrits sur l’aliénation et la liberté. Œuvres II, La Découverte, 2018.
• Reason and Revolution (1941) : ouvrage tentant d’expliquer le fascisme à partir de l’évolution du capitalisme, et prenant appui sur le concept wébérien de rationalisation de la société
• Eros and Civilization (1955). Trad. fr. 1958 : Éros et civilisation : ouvrage engagé pour une société non répressive. De nombreuses formes de travail sont aujourd’hui obsolètes, ce qui crée les conditions de nouveaux modes de liberté.
• Soviet Marxism. A Critical Analysis. Trad. fr. : Le marxisme soviétique (1958)
• Reason and Revolution (1941) : ouvrage tentant d’expliquer le fascisme à partir de l’évolution du capitalisme, et prenant appui sur le concept wébérien de rationalisation de la société
• Eros and Civilization (1955). Trad. fr. 1958 : Éros et civilisation : ouvrage engagé pour une société non répressive. De nombreuses formes de travail sont aujourd’hui obsolètes, ce qui crée les conditions de nouveaux modes de liberté.
• Soviet Marxism. A Critical Analysis. Trad. fr. : Le marxisme soviétique (1958)
La Frontière suivi de Un jeune homme à la page, Paris, Le Seuil, 1967 (ASIN B003X1XOYW)
Révolution dans la révolution ? : Lutte armée et lutte politique en Amérique latine [essai], Paris, Maspero, 1967 (ASIN B0000DP0JI)
Nous les Tupamaros suivi de Apprendre d’eux, (collectif), Paris, Maspero, 1971 (ASIN B0000DOHE9)
La Guérilla du Che, Paris, Le Seuil, 1974 (ISBN 978-2-020-02320-7)
L’Indésirable, Paris, Le Seuil, 1975 (ISBN 978-2-020-04220-8)
– محمد الأشعري، عينان بسعة الحلم، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، بيروت. ط1. 1981
– جاك ووديس، الثورة والطبقات، مدخل لقراءة نظريات فانون، دوبريه ، هربرت ماركيوز.


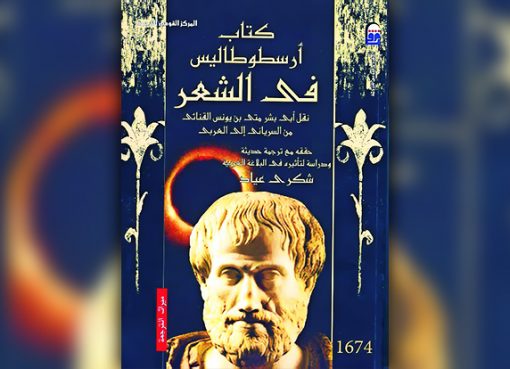

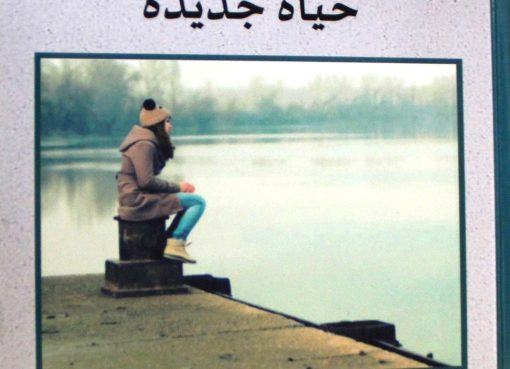
Yes! Finally someone writes about hgf.