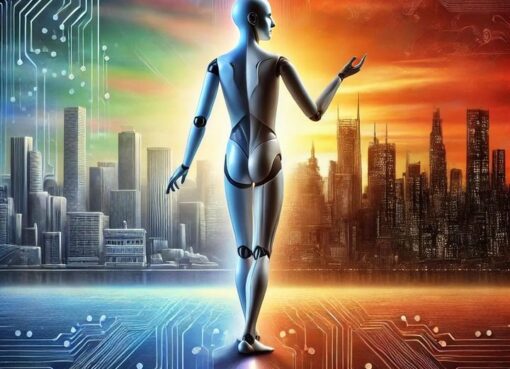لن تدرك قيمة الحياة حتى تصبح في موطن اغتراب خالي الوفاض.
كان والده قبل وفاته يردد هذه العبارة كلما سمعه يفتي في شأن من شؤون الدنيا، فتاوى الشباب المتعلم المتعامل مع الحاسوب والجريدة والكتاب. وبعد وفاته ورث عنه أكثر بكثير مما كان يتصور.
إذ حرص والده على أن لا يبدي له ما أصاب من الغنى حتى لا يجعله يتواكل. فيضيع ما جمعه طوال سنين من الكد والحرص.
وهو قيد حياته كان ممنوعا عليه أن يقرب الكثير والعديد من الأشياء التي يفتخر ويزهو أمام بعض معارفه بأنهم عاشوها.
عاشها مثلما عاشوها. وعاش ما نجم عنها. ثم ضاق المعيش وارتد إلى ما كان عليه. نقر على فأرة الحاسوب وتصفح الجرائد. قراءة لدراسات وكتب، متاجرة واتصالات وسفريات خلف البضائع، استقبال وتصدير لها. مداعبة للأولاد. مغازلات للزوجة.
كانت هذه الأشياء تكاد تملأ يومه وتغطيه أيضا. ويبدو له أنه لا يصنع شيئا دقيقا في هذه الحياة، وأنه ليس إلا امتداد لوالده الذي صنع كل شيء مما يرفل فيه من النعم والقيم. يتذكر مقولة والده: لن تدرك ماهية الحياة حتى تصبح في موطن اغتراب”. يتصور رجلا على الشاكلة الذي حدد والده.
ليس التصور ضربا من الظن الذي فيه ما هو مصيب ومخطئ. كما أنه حين يسترجع العديد من التصورات التي تشكلت لديه، عبر حياته، يجد نفسه مخطئا طولا وعرضا.
قلب نظره بين من يعبر تحت بصره، وبين من يعرف، وسأل من يعرف عن معيار والده المعرفي، فوجدهم كلهم يستعيذون بالله من مثل هذا الوضع. كما أن الذين لا يعرفهم لا يعرف منهم من عاش معيار والده.
بدأ بطرح التساؤلات فتناسلت أسئلة تلو أخرى. ولماذا لا يتساءل المتسائلون؟ وهل نوى أن يصبح في موطن اغتراب خالي الوفاض، كما نصحه بذلك والده.
هذه الليلة هي الليلة الفيصل. اقتطع تذكرة ذهاب إلى أبعد مدينة من مدينته، وجدها طنجة. دس التذكرة في جيبه. الثانية عشر ليلا والنصف موعد الانطلاق. لعل هذا السفر أن يضعه في قلب موطن اغتراب خالي الوفاض. عاد إلى بيته، داعب أولاده، غازل زوجته، أدى واجب الفراش بهمة عالية. وأكثر من ذلك أنه حطم رقمه القياسي الشخصي الذي حققه في أولى شهور زواجه. استغربت زوجته. بل ضاقت به من فرط الشبق المنبثق هكذا على حين غرة.
غادر الفراش… اغتسل، عاد إليها، جلس إلى جانبها. سلمها مفاتيح سيارته.
– ستجدينها مركونة قرب باب محطة المسافرين، قال:
سأسافر ليس من أجل بضاعة. سأسافر من أجل أن أعرف ما عرفه والدي.
تحدث إليها عن نصيحة والده وإشاراته، وحديثه عن موطن اغتراب خالي الوفاض. مقولة الأب تلك أفسدت عليه حياته، وجعلتنه لا يطمئن… وهو لن يهدأ له بال حتى يعرف سر حديث والده عن الاغتراب خالي الوفاض.
سأذهب ولا أعرف متى سأعود، يمكن أن أعرف بمنتهى السرعة، وأعود غدا، و يمكن أن أغيب إلى أن تضطروا إلى إعلان وفاتي.
داهمه الوقت فأسرع، أزفت ساعة السفر، وبدأت الرحلة.
الحافلة تنهب الطريق، وفي البال يتردد الاعتراض المنكسر الذي أبدته زوجته، حين تذرعت بالعيال.
أكدت له أنها لم تعرف في حياتها من يعرف أكثر منه.
انكسرت، لأنها تعرف أن مسألة المعرفة بالنسبة إليه خط أحمر، لا يجوز أن يتعداه أحد.
ينتابه خوف مبهم، خوف لا شكل له ولا موضع
من خلو الوفاض، ومن الاغتراب، يمازجه شغف وإثارة جارفان. إثارة ليست بغريبة عنه، عايشها مع العديد من المواقف الروائية تحديدا.
بدا له ذات لحظة أنه نال أول درس من معرفة والده، درس الخوف من الغد.
كان الغد بالنسبة إليه دائما موعد استلام وتسليم واجبات اجتماعية، وما شابه.
هذا الغد الذي تنهب الحافلة إليه الطريق، غد مختلف تمام الاختلاف.
– هل هذا ما كان يريد الوالد أن أعرفه، الخوف من الغد.
– بقي علي الآن أن أعرف ما الذي ينبغي أن أخافه.
لا أستطيع أن أعرف الآن. كل ذلك لم يحدث بعد، ولن أعرف حتى يحدث.
الخامسة صباحا، وصلت الحافلة إلى موطن الاغتراب. وبقوة العادة اتجه إلى المقهى ليتناول وجبة الفطور.
وهو يهم بالدخول، تذكر أنه لم يحمل في جيبه درهما واحدا. عاد لتوه بطريقة من تذكر أمرا أهم من قعدة المقهى.
إنه لا يشعر بكامل الجوع، بل لا يعرف ما معنى الجوع، ولا الإحساس به، كل ما يتذكره عن الجوع هو أن له مواعد.
تذكر أنه كان يأكل ليس لأنه جاع، بل لأن موعد الغداء حل. وهو موعد إغماض الجفن لساعة ، وليس للأكل في الدرجة الأولى. هل هو جائع الآن.
إنه في حاجة لأن يأكل فقط.
– أين ركنتها، تساءل، يقصد سيارته.
تذكر أنه تركها عند باب محطة المسافرين في أكادير.
– هل ما كان يريده الوالد هو أن أتفقد ما أملك، وأن أولي ما أملك قيمة واهتماما.
– العمر كله مضى بلا مشي.
– العمر كله، وأنا أمشي على أربع، والآن لا أملك إلا قدمين لم يتعودا على المشي.
– نعم، هذا ما يريد الوالد، أن أدرك قيمة ما أملك.
يمشي ولا يعرف أين يمشي.
قدماه تؤلمانه. وفي لحظة اشتد الألم حتى لم يعد يقوى على المشي، فاضطر لأن يقعد على عتبة بيت.
إنه مبتل عن آخره، تحت يديه، وبين فخدهن، وفي خاصرته… فكر في أنه ليس الموعد الملائم لمثل هذه الرحلة .
هل هو الشتاء، أم الخريف أم الربيع؟ الشتاء أسوأ… تصور ليلة قارسة في العراء، كما هو الآن على موعد مع ليلة في العراء، ليعرف قيمة البيت الذي يأويه.
– بالعكس هذا الصيف الحارق هو الموعد الملائم لهكذا رحلة.
هل هذا ما كان الوالد يريد أن أعرفه، قيمة السقف الذي يظللني، والفراش الذي أضطجع عليه، والسيدة التي تشاركينه، وأطفالي الذين يحلمون في حجرتهم.
في أوقات الذروة من العم، كان لا يجد الوقت ليعد كل النقود المنهمرة، والآن من سيسلفه درهما واحدا.
غرغرت بطنه، وبدا له صوت غريب كأنه يصدر من خلفه. التفت، لا شيء بينه وبين الباب الموصد، ولا شيء بجانبه.
ثم غرغرت مرة أخرى.
إنه الجوع، وهذا صوته، وهو في أمس الحاجة لأن يأكل، هذه حقيقة لا مفر منها.
استأنف المشي…
قدماه ليستا على ما يرام. ليست هذه مشيته، بل متى مشى… عليه أن يتعود.
عليه الآن أن يتدبر مسألة الأكل. كيف لم يفكر لما عزم على مسألة الاغتراب الخالي الوفاض في مسألة بديهية مثل الأكل. كان عليه أن يدس في جيبه رزمة مال ليتدبر، على الأقل، أيام الاغتراب خالي الوفاض. لكن، كيف كان سيعرف قيمة الأكل وهو عامر الوفاض؟ هل هذا هو الدرس التالي: قيمة الأكل.
الناس يختفون من الشوارع شيئا فشيئا.
في حي لم يعرفه، هل هو منتصفه أم نهايته، جلس عند عتبة بيت.
بطنه لم تعد تغرغر، إنها تؤلمه. تذكر أن الجوعى كانوا يشدون على بطونهم، ليجرب إن كانت المعلومة كلام كتب، أم حقيقة يعيشها الآن.
أخد في البحث عن حجر، لم يحتج لأن يرخي حزامه، احتاج لأن يشده إلى الحجر. استرخى ليستشعر نجاعة الشد. أتت المعلومة أكلها، أربعة وعشرون ساعة الأولى جوعا على وشك الانتهاء، شعر بعذاب الجوع. إنها أطول فترة صوم في الحياة.
وبينما هو يفكر في قيمة الجوع التي أراد والده أن يعرفها حق المعرفة، انفتح باب من أبواب دور الحي الذي لا يعرف اسمه. خرج رجل وفي يده كيس قمامة وفي يده الأخرى كيس ببقايا الخبز اليابس.
ألقى الرجل بالقمامة في حاويتها المستطيلة. وعلق كيس الخبز على حاشيتها. وعاد الرجل إلى بيته بعدما ألقى نظرة غير متفحصة عليه.
أصبح وجها لوجه أمام كيس الخبز المعلق على حاشية حاوية القمامة.
بعد صراع مرير، أيقن أن ما تخلى الناس عنه من فتات الطعام، وما فَضُلَ عنهم من خبز طعامهم هو السبيل أمامه للبقاء، وأن عليه أن يدرك قيمة البقاء.
الكاتب المغربي – نزار القريشي