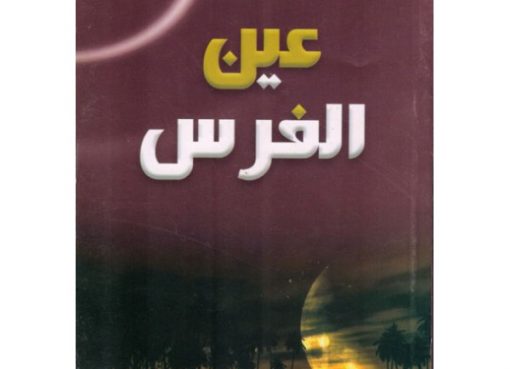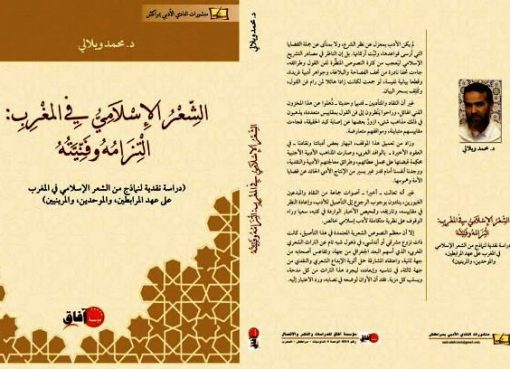حين تدركُ أنك تتقدّم في العُمر قليلا، عليك بالسّفر، زُر ما لم تزُره في وطنك، وفي العالم من حَولك. هكذا، سافرتُ من فاس إلى العُيون، في رحلة صحراوية شاقّة ومُتعِبة، ولكنها جدُّ مُمتعة. كان من المفروض أن تتمّ هذه الرّحلة قبل أربعين عامًا، ولكنها توقفت في طانطان سنة 1984م. قالوا لي هناك: “انتظر أن تكتمل الكُوفَة“، لم أكن أعرف ما معنى “الكُوفَة“، كنت أعرف البصرة والكوفة مدينتين في العراق. وحين سألت أحد العارفين، قال لي أنهم يقصدون الـ“convoi“، قافلة من عشر سيارات لاند روفر تنطلق مُجتمعة، ويكون في مقدمها سيارة عسكرية مُجهزّة لتأمين الحماية، كان المسافرون يتعرّضون من حين لآخر إلى هجمات مُرتزقة البوليساريو. انتظرت خمسة أيام في طانطان دون تكتمل “الكُوفَة“، ولم يكن أمامي غير العَودة خائبًا مُنكسِرًا إلى أكادير.
اليوم، وبعدَ مُرور أربعة عقودٍ من الزّمن، لم أعُد في حاجة إلى اكتمال “الكوفة“، لأن “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس“. أصبحت الطريق إلى الصحراء المغربية آمنة، مفتوحة أمام المسافرين ومختلف وسائل النقل عبر طريق سريع من تزنيت إلى العيون، بوجدور، الداخلة وإلى حدود معبر الكَركَرات الحدودي مرورا إلى دولة موريتانيا وبعض دول إفريقيا. بدأت الرّحلة مُبكّرًا من فاس، وانتهت في مدينة العيون بالسّاقية الحَمراء. كنت أعلمُ أن الرّحلة لن تكون سهلة، وأنه عليّ أن أنسى نُعومَة الأطلس واخضراره، بعد تَخطّي نخيل مراكش وزيتون شيشاوة، لأنني أعرف استبداد الصحراء وجبروتها، لا هضاب فيها، لا تلال أو جبال، مشاهد قاسية على العين والإحساس، ولكن لها جمالها الخاصّ. ما أن غادرتُ شيشاوة، حتى بدأت تبدو لي الأرض حمراء جرداء، وأنا في الطريق إلى أكادير، لا تصلح إلا لتمثيل أفلام رُعاة البقر، ولكن فرحي كان شديدا برُؤية الطريق السّيار مراكش أكادير، أنساني تعَبَ المُنعرجات في الأطلس الكبير. إنجاز مغربي كبير، من حقنا أن نفتخر به كمغاربة، حتى لو حرَمني من مُعانقة مدينة إمِنتانُوت الجميلة، وقد غبت عنها أزيدَ من ثلاثة عقود.
لم يكن سهلا على دولة نامية مثل المغرب أن تشق طريقا سيّارًا في جبال الأطلس الكبير، بتعقيداته الجيولوجية وجبروته، عُلوّه ووُعورَة تضاريسه، ولكن فعلها المغرب. كنتُ أتعقب الطريق الوطنية من حين لآخر، عزّ علي أن أراه قزَمًا أمام الطريق السّيار، وقد كان بيننا طعامٌ وملح لأكثر من ثلاث سنوات قضيتها في سُوس. صعُب عليّ أن أرى تراجع اخضرار شجر غابات الأركان، وقد ألفت رُؤيتها يانعة، اخضرارها يُبهج النّفس والعَين. الوصول إلى مدينة إنزكان ذكّرني بزحامه المُزمن منذ أربعين سنة، ولا عجب في ذلك، هو مدارُ المغرب الراّابط بين الشمال والجنوب، عكس ما رأيته في مراكش، كل شيء مُرتب فيها بإحكام. في الطريق إلى تزنيت، وجدت امتدادًا عُمرانيا رهيبًا، أغلب الدّواوير التي كنت أعرفها أصبحت مراكز حضرية. أصبح المُرور منها في جوّ حارّ وسُرعة محدودة، هو الجحيمٌ بعَينه، ولكن قد يخفّف منه افتتاح المَقطع الطرقي السّريع تزنيت كلميم، كي تتفادى السيارات تثاقل الشاحنات الثقيلة وبُطؤها في المُنعرجات الخطيرة بين بويزاكارن وثلاثاء الأخْصَاص.
بعد قضاء ليلة مَبيت اضطراري في طانطان، تابعت المَسير إلى طرفاية ثم العُيون. بدأت أحسبُ المسافات بالعَين وليس بالكيلومتر، أربع ساعات من السّير في طريق سريع، مع توقف قصير في مركز أخفنّير، قضيناها حُبُسًا على مقاعد السيارة، قبل وصولنا إلى مدينة العيون. مَرَرنا على الوَطية الشّاطئية، مصبُّ وادي الشبيكة في ابن خليل القريب من زُرقة البحر، وادي لعكيك، وادي أمّ فاطمة، وادي الواعر، وادي أودري ثم مُتنزَه خْنِيفيس الوطني بالقرب من النّعيلة، قبل الوُصول إلى وادي السّاقية الحَمراء. أسماءٌ قرَأتها على لوحات معدنية، ولم أكن أسمعُ بها من قبل، طرقٌ وقناطر بعشرات الأمتار، بدءا من قنطرة وادي درعة الطويلة، ومشاريع مهمّة أنجزَت في الصحراء المغربية، بنية تحية تجعلك تفتخرُ أنك مغربي.
مرَرنا وسط امتداد لا مُتناهي من صُفرة الرّمال. أحسَستُ لأوّل مرّة بضعفي أمام جبروت الصحراء، صمتها وامتداد انبساطها على مدّ البَصر. لا شيء يعلو فوق الصَّمت، وهدير مُحرّك السّيارة. الرّكاب استكانوا إلى تأمّل الوُجود وعظمة الخالق من حولهم، بدأوا يتودّدون إلى صمتهم، ويمعنون في الاستماع إلى الأصوات التي بداخلهم، وقد أثخنوا في الكلام والضّجيج والثرثرة في بداية الرّحلة. أصبحوا أشباه نيام، لا أحد منهم يكلم أحدًا، كأنهم كرهوا بعضهم البعض. هكذا هو سحرُ الصحراء وعظمتها، فعلا وقولا، لا طير يطير، ولا وحش يسير، إلا من جمال ضعيفة تصادفها من حين لآخر، ومُهاجرون أفارقة قدموا من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تعبت خطواتهم وتثاقلت أرجلهم من كثرة المشي في رحلة طويلة، عيونهم على سبتة ومليلية المُحتلتين، لا شيء أمامهم، سوى صُفرة رمال على الأرض وزُرقة السماء فوقها، في انتظار العُبور إلى الحلم الأوروبي.
شواطئ رملية جميلة تتراءى غيرَ بعيدٍ على طول الطريق إلى حدود طرفاية وما بعدها، تنتظر من ينتشلها من عطالتها المُزمنة، يلزمها بناء موانئ ترفيهية وفنادق، كافيهات وشقق للكراء، لكي تكون جاهزة لاستقبال مُصطافي المستقبل. عند مرورنا ببلدة الطّاح الصغيرة، استحضرتُ رمزيّتها التاريخية، يقف في وسطها نصبٌ تذكاريٌّ يخلد زيارة السلطان المولى الحسن الأول إلى الصحراء المغربية عام 1886م، ومنها اخترق مُتطوّعو المسيرة الخضراء السّياج الحُدودي الوهمي، ونزع أحد المتطوعين الشجعان في المسيرة راية إسبانيا الاستعمارية، وثبّتَ مكانها الرّاية المغربية الحمراء بنجمتها الخماسية سنة 1975م، هي التي لا زالت ترفرف عالية إلى اليوم، وفيها أيضًا صلى الملك الرّاحل الحسن الثاني طيّب الله ثراه ركعتي النّصر شُكرًا لله تعالى.
في مركز الدَّورة، تظهر بقايا إسفلتِ طريقٍ قديم، يبدو بئيسًا إلى جانب معالم الطريق السريع. صادفنا كثبان رملية كبيرة على جانب الطريق السريع قريبًا من العُيون، كثبان رملية بحجم هضاب صغيرة تهجم على الطريق، يكاد يختفي في بعض المقاطع ويتوارى تحت صفرة الرّمال، لولا يقظة سائقي آليات كبيرة. سألت السّائق، وقد أعياني طول السّفر: “هل اقتربنا…؟ “. قال لي، وقد بدا عليه التعب بدوره: “اسْتَعِدْ للنّزول، أنت الآن في عيون وادي الساقية الحمراء“. يا ألله، استحضرت فجأة أغنية “العُيون عينيَّا، والسّاقيَا الحَمْرَا ليَّا“. فرحتُ وانتشيت كثيرا، وأنا أضع قدميَّ لأول مرّة فوق رصيف مدينة العُيون عاصمة الصحراء المغربية. أحسست بفخر الانتماء وبقوّة المغرب حين يُريد: حدائق خضراء، ساحات جميلة، نوَافير تُزيّن الشوارع، نظافة لا تخطئها العَين، أضواء نافورَات تنيرُ ليل الصحراء في المدينة، مطار عصريّ، مركّب رياضي دولي وغيرها من المنشآت. إنها مدينة العيون، كما تصوّرتها، جنّة خضراء في قلب الصحراء المغربية.
رجعت بي ذاكرتي إلى مُراهقتي الصغرى، وإلى عامي الأول في الدراسة بالإعدادي، تذكرت كيف استقبلنا مُتطوّعي المسيرة الخضراء ذات صباح باكر في حماسة بالغة، ونحن نردّد معهم كلمات ذات الأغنية: “العُيون عَيْنِيَّا“، وها اليوم أرى بأمّ العَين وادي “السّاقية الحمراء“، هو الذي طالما تغنّى به جميع المغاربة، وأتجوّل في مدينة العيون التي كنت أتمنى زيارتها، وها قد فعلت أخيرًا، ولو بعد أربعين عامًا من التأخير.
ومن الأشياء الطريفة التي صادفتني هناك، وأنا في طريق العودة من مدينة العُيون، استوقفنا أحد سكان البادية، ركب معنا لمسافة قصيرة، وحين نزل من السيارة، دعانا إلى شرب الشاي قائلا باللهجة الحسّانية: “مرحبًا بكم تْيِّيوْ عَندي(تشربون الشّاي)”. سألت السائق، ولم يظهر لي قريبًا أو بعيدًا مقهى أو دارًا، قلت له: “أينَ سنشرب الشاي؟“. أشار بيده إلى بيوتٍ قصيرة بالكاد تظهر فوق الأرض، وهي تقنية صحراوية في بناء المنازل من أجل تفادي حرّ صيف الصحراء. قلت مع نفسي: “سبحان الله، ما أكرم الإنسان في الصحراء المغربية“، ولو أنني أعرف أن الكرم متأصل في الإنسان المغربي، حتى وهو مُقيم في أقاصي الصحراء. أن تكون كريمًا، ليس بالضرورة أن تملك دارًا أو مالا، الكرم من الإيمان، وهو حالة اجتماعية وإنسانية متأصلة فينا نحن المغاربة، لولا أن اكتسحنا هذا التّحَضُّر المَغشوش، وأفسد كل شيء جميل فينا، وأصبح ما نعيشه من مظاهر حضارية، أو هكذا نزعم، مُجرّد وَهم خادع.
في طريق العودة، مررنا بمدينة طرفاية، حيث تكثر محطات وحقول ريحية، لا تكف أجنحتها عن الدوران. كان الطريق طويلا ومنبسطا، لا شيء يشغلك فيه سوى امتداده الطويل، سراب يحسبه الظمآن ماء، وسوادُ إسفلتٍ اختلط بزُرقة السماء. كانت رحلتي مُبرمجة إلى مدينة الداخلة وما بعدها، ولكن لأسباب ذاتية ومالية توقفت في مدينة العيون. تمنيت لو أنه كان في الإمكان زيارة مدن أخرى: الداخلة، السّمارة، بوجدور، أوسرد، كلتة زمور وغيرها من مدن الصحراء المغربية، ولكن ما باليد حيلة. لم أقصّر فيما قمت به، ولم يكن في الإمكان، أكثر مِمّا كان…
إدريس الواغيش