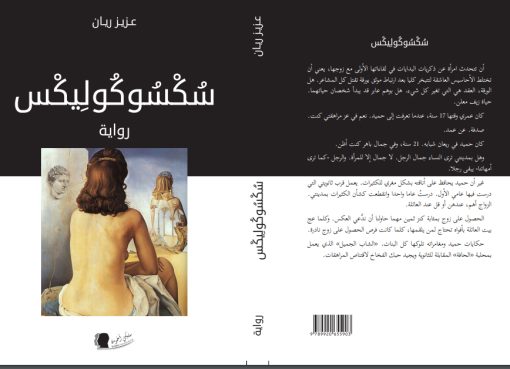وصل إلى علمي أن جمعية “أصدقاء المُعتمد” في شفشاون قرّرت تأجيل مهرجانها الشعري هذه السنة، (وقيل لي كذلك) أن السبب يعود إلى عدم حُصولها على الدّعم المالي “الكافي”. هذا القرار في حدّ ذاته أزعجني، وهو يُعطي الانطباع بأنّ الدّعم المالي و”الكافي” كان أكثر أهمية للجهة المنظمة من الشعر والمهرجان، وإن كان الأمر في حد ذاته مُؤسفًا ومُدانًا من حيث المبدأ. وأنا بصفتي شاعر مغربي، لن أتردّد في إدانة الجهات المانحة والداعمة، من حيث عدم التزامها بدعم مهرجان شعري مغربي أصيل، كان من مُؤسّسيه شاعران مغربيان رائدان، هما: عبد الكريم الطبال والراحل محمد الميموني.
وليس غريبا أيضا، في هذه المرحلة بالذات، أن تنحاز ميزانيات الجهات الداعمة في ربوع المملكة إلى تمويل ودعم مهرجانات التفاهة. ولا عجب في ذلك، لأن الهم الأكبر لهذه الجهات “المانحة” من أموال الشعب والأطراف “الداعمة” من أموال الدولة في الوقت الراهن، هو الانتخابات وعدد أصواتها، والاستوزار في الحكومة المقبلة، ولا شيء غيرها…!!
وما دام الشيء بالشيء يذكر، دعونا نرى الأشياء من زاوية أخرى إيجابية، مختلفة ونبيلة، وأنا أستحضر ما رأته عينيّ في مهرجان بلقصيري الأخير للقصة القصيرة من عزيمة وصبر بالغين لدى أعضاء وعضوات الجمعية المنظمة، وإصرار كبير على إنجاح أشهر وأقدم مهرجان قصصي بالمغرب، رغم غياب “الدعم المالي”، حتى لا أقول داءَ هذا “الكافي”.
القصة القصيرة في أولها وآخرها عُمرٌ، والعُمر مُجرّد رقم، ليس بالضرورة أن يكون دعمًا ماليا، ولا “كافيًا” وربما “سمينا” كذلك، تتقلص أو تتمدّد أرقامه. ولأن فعل السّرد ربما مختلف عن كلام الشعر، يتوق دائما إلى نهايات قصص خيالية أو واقعية، واضحة أو ملتبسة، تطول أو تقصر. كما أعمارنا التي بدورها لا تختلف في شيء عن قصصنا، تركض لاهثة وراءها في نوع من العبث بصفته نظرية فلسفية، تحتار بين حسن النية وحتمية النتيجة.
أذكر أنه ذات سنة بعد الأربعين بقليل، كنت هناك في بلقصيري من بين أصغر القصّاصين، وها أنا اليوم أحضره، وقد تجاوزت الستين سنة من عمري، ولولا أنقذني حضور صديقي الجميل القاص الفيلسوف عبد السلام الجُباري، لكنت هناك أكبر من اعتلى منصّة مهرجان هذه السنة، لكي يقرأ قصته القصيرة. وبين أول مهرجان وطني حضرته في بلقصيري، وآخر مهرجان ودّعته فيها، رحلة عُمر ليست بالقصيرة. حضرت فيها عدّة أسماء وازنة وغابت عنّا أخرى، لم يعد لها وجود في عالمنا ودنيانا.
بعد الانتهاء من فعاليات مهرجان بلقصيري القصصي، يبدأ على الطرف الآخر، تفكير في تصريف ما تبقى عالقًا من فائض شعوري أو لا شعوري، وترتيب كتلة من الأحاسيس المُبعثرة، بقيت عالقة في الذهن. أحاسيس فوضوية الملامح، تنبجس عادة في مكان مختلف، بعيدًا عن ضوضاء القصة أو صمتها في مشرع بلقصيري، وهو ما حدث معي في خلوة رفيعة، وأنا جالس وحيدا خلف فنجان قهوتي، أرتب أموري والمنفلت من تلك اللحظات الهاربة أو الغير مرغوب فيها في ركن بأحد المقاهي.
“القصّة نَبتة الظّل”، كما وصفها القاص الزّاهد في عشق القصة أحمد بوزفور، يسطحها الغرور ويزعزعها الانصياع للثّوابت واليقينيات، ولولا واقعيتها وتواضع أهلها والمنتسبين إليها، لما استطاعت أن تزهر في حرارة قاربت الخمسين درجة هذه السنة. ولأن القصة فعل عابر لتاريخية الأزمنة ورمزية الأمكنة أيضا، بحجّة وغرض التأثير في مُجريات التاريخ، ولولا وجود هذه القصص القرآنية والإنسانية، لما كنا عرفنا شيئا عن التاريخ الإنساني.
القصة عُمرٌ مُحاصرٌ بالجبهات، والعمرُ مُجرّد رقم يوقعك في شراكه المنصوبة، وفعل انفلت من الماضي، يتوق أحيانا إلى نهايات قصص ملتبسة المعاني في المستقبل، بين واقعية سحرية وخيال يتماوج بين الاستعارة والمجاز. أعمارنا هي الأخرى، لا تختلف في شيء عن قصصنا في طولها وقصرها، تهرول بنوع من العبث إلى ما بعد الأربعين. أذكر أنني كنت يوما هناك يوما أصغر القصاصين، وها أنا أحضر في يوم مختلف، وقد تجاوزت الستين، لولا أنقذتني فلسفة صديقي القاص الجباري، وأنا أستمع إلى واحدة من أجمل قصصه.
قال لنا الدكتور علي القاسمي الأستاذ الجامعي والكاتب والمترجم العراقي المقيم بالمغرب، ونحن جلوس معه يوما في أحد أماسي فاس الصيفية الجميلة، نستمع إلى حكمه ونستمتع بظرافته على رصيف الشارع ذات سنة: “حضرت مرة صالون أدبي مغربي، دأبت على تنظيمه الأديبة والفنانة التشكيلية الزهرة الزّيراوي في منزلها بالدار البيضاء، وإذا بي أرى شبّانًا وشابّات يخدموننا بخفّة النحل ودقة حركية النمل. وحين سألت عنهم، قيل لي أنهم مهندسون وأطباء أبناء الزّهرة..”، وأضاف في فخر واعتزاز وذهول، قال لي أحد هؤلاء البرَرة:” لنا كل الفخر سيدي الفاضل أن نكون في خدمة الأدباء والأديبات، أنتم ضيوف وضيفات أمنا الزهرة..”.
استحضرت بدوري كلام علي القاسمي، وأنا أرى بعينيّ عبد الجليل الشافعي، جمال الفقير، بنعيسى الشايب، عبد الهادي حسني، محمد الشايب، محمد الحاضي، وغيرهم ممن لا تحضرني الآن أسماؤهم، وأنا أستسمح منهم، يخدمون القصاصين والقصاصات في المهرجان بكل تفان وتواضع، وهم إما رجال أعمال أو طلاب وأساتذة جامعيون وقصاصون مبدعون ونقاد أدب. والأكثر من ذلك، كثير منهم يحمل معه درجة دكتوراه في تخصص مُعَيّن من إحدى الجامعات المغربية. وكم أخجلتني الصديقة المبدعة والأستاذة الجامعية ثورية بدوي، رئيسة جمعية النجم الأحمر، وهي تتفانى في خدمة ضيوف المهرجان بنفسها، وتقول لضيوف وضيفات المهرجان بكل صدق: نحن هنا في خدمتكم، ماذا يلزمنا فعله من أجلكم…؟
هذه الأسباب وغيرها، جعلت من مهرجان مشرع بلقصيري للقصة القصيرة كعبة ومِحجًّا للقصاصين والقصاصات المغاربة والعرب على السّواء، بالرغم من غياب “الإمكانيات” وتلك “الكافية” اللعينة. وتحوّلت القصة القصيرة فيه من “نبتة الظل” هذه، كما وصفها القاص السي أحمد بوزفور، إلى عشبة القبّار أو الكبّار ( Copparis Spinosa) التي تنمو عادة في البيئة الرّطبة، ولكنها “شَعْشعت” وأينعت هذه السنة، وأصبحت” حَرْشة” في درجة حرارة فاقت ال47 درجة…!!
إدريس الواغيش – المغرب