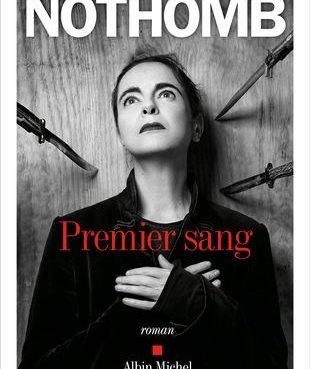أجمع المشاركون في ندوة “الجوائز الثقافية في العالم العربي” على قيمة هذه الجوائز ودورها في الرقي بالأعمال الأدبية والفنية، قبل عرضها على لجان التحكيم وبعد تتويجها، وترويجها وتداولها. وقدم المشاركون في الندوة التي نظمتها دار الشعر في تطوان، تصورات ومقترحات من شأنها أن تغني عمل هذه الجوائز وطرق اشتغالها، كما توقفوا عند نماذج عربية ناجحة، جعلت من الجائزة آلية للتحفيز على القراءة وتلقي الأعمال الأدبية والفكرية والفنية.
“فز بجائزة لأراك! فز بجائزة لأقرأ لك وأقرأ عنك!”، تلك هي العبارة التي نحتها عبد اللطيف البازي وعدها منطلقا لمداخلته، معتبرا أنها المبدأ الموجه لقرار إحداث جائزة ما والمتحكم في مجموع الحركية المرافقة لهذا الإحداث. ذلك أن “كل جائزة هي في العمق اعتراف بتميز عمل، أو تحفيز على مواصلة مشروع ثقافي، وغالبا ما تكون ضمانة على جودة المتوج”. الكاتب والمترجم المغربي يرى أن رسالة أي جائزة “موجهة إلى المبدع نفسه، حين تؤكد له أن إنتاجه ذو قيمة وأننا ننتظر منه المزيد، بقدر ما هي رسالة موجهة إلى المتلقي، إذ تحثه على اكتشاف العمل المحتفى به”. وإذا ما كان الأمر يتعلق بجوائز مخصصة لدعم الكتب، فالرسالة تكون موجهة كذلك إلى دور النشر لتثير اهتمامها إلى ضرورة احتضان أسماء بعينها والمراهنة.
وعاد البازي إلى بدايات علاقة الثقافة العربية بالجوائز، حيث استوقفنا عند سنة 1988 وهي السنة التي نال فيها نجيب محفوظ جائزة نوبل للآداب. وبحسب المتحدث، “كان الأمر حدثا ثقافيا وحضاريا رفيعا، وشعر العرب، بمعنى من المعاني، بأنهم التحقوا بركب الثقافة الكونية. من هنا، بدأت العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في التفكير في إحداث جوائز للإبداع العربي لاستثمار المناخ الإيجابي والمتفائل الذي خلقه حدث فوز نجيب محفوظ”. بعدها مباشرة، سوف يتركز الاهتمام بالأساس على الرواية العربية، في سعي حالم لأن تصبح لها القدرة على منافسة نظيراتها على المستوى العالمي. والآن يأتي الحديث عن جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، لتسليط الأضواء على جنس الشعر أيضا والعودة إلى الاحتفاء به إبداعا ونقدا. ومن يومها، رأت النور العديد من الجوائز، وكانت لكل جائزة معاييرها وخطها التحريري ولجان تحكيمها ومردوديتها المادية بالنسبة إلى الكاتب ودار النشر. وهكذا أحدثت جائزة نجيب محفوظ وجائزة البوكر العربية وجائزة الشيخ زايد للكتاب وجائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة باسم الطيب صالح، وجائزة يمنحها رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس وجائزة باسم مؤسسة بنكية أردنية، وجائزة باسم سلطان العويس، وجائزة المغرب للكتاب…
وانتهى البازي إلى أن الجوائز ينبغي أن تراجع مسلماتها ومنطلقاتها وآليات اشتغالها خاصة بعد هذه الرجة الكونية التي نعيشها بسبب عدو غير مرئي وقاتل ولقيط اسمه فيروس كورونا، رجة سوف تدفعنا حتما إلى إعادة النظر في تصوراتنا للحياة.
فما المعنى الذي يمكننا أن نمنحه للجوائز الثقافية في العالم العربي؟ انطلاقا من هذا السؤال، جاءت مداخلة الدكتور يوسف الريحاني، والذي توقف لدى الجدل الذي يرافق كل الجوائز الثقافية غداة الإعلان عن نتائجها، معتبرا إياه من صميم الترويج لهذه الجوائز التي تظل في النهاية تثمينا للإبداع الأدبي والفني، وركنا جوهريا في السياسات الثقافية داخل مجتمع الشبكات. وقد استدل المتدخل بالمقارنة بين وضع الثقافة العربية قبل سياسة الجوائز وما بعدها، حيث أشار إلى أن الجوائز الثقافية قد “أفرزت جيلا جديدا من المبدعين العرب الذين صارت لهم الكلمة على مستوى الإبداع والتواصل”. وكما تحدث الريحاني عن الجوائز التي كرمت وكرست أسماء لها حضورها الثقافي المشهود في العالم العربي، ركز المتحدث على الجوائز الخاصة بالكتاب الأول، في مختلف المجالات، والتي تظل موعدا سنويا لاكتشاف أسماء باحثين ومبدعين كان يتعذر علينا التعرف إليهم، والعلم باجتهاداتهم ومواهبهم، لولا هذه الجوائز. وهنا، دعا الريحاني إلى ضرورة إحداث جائزة خاصة بالكتاب الأول في المغرب، تكشف لنا كل سنة عن أسماء جديدة في مختلف المجالات المعرفية والفنية، نقدا وإبداعا.
في هذا السياق، استحضر المتدخل موقع إمارة الشارقة في خريطة الجوائز العربية، باعتبارها “عاصمة الجوائز الثقافية في العالم العربي، حيث تتميز سياسة الجوائز التي تشرف عليها دائرة الإعلام والثقافة بالشارقة بالتنوع الذي يشمل كل ميادين الإبداع، من تشكيل ومسرح وآداب وفنون…) وأيضا مختلف الفئات (شبابا ومحترفين وروادا).
وقد شدد الناقد الفني والمسرحي المغربي على قيمة هذه السياسات التي تواكب تحولات مجتمع ما بعد التصنيع، الذي صارت فيه الثقافة جزءا من سياسات التنمية المستدامة.
وختم يوسف الريحاني مداخلته بالوقوف عند دلالة إطلاق “جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي”، والتي جاءت بمثابة “تثمين لمكون جوهري من مكونات الحضارة العربية ألا وهو الشعر ديوان العرب، وأيضا تفعيلا لأهداف شبكة بيوت ودور الشعر عبر ربوع الوطن العربي”، معبرا عن تقديره لهذه الخطوة، وعن يقينه من أنها “سوف تتربع على عرش الجوائز الثقافية والنقدية القيمة في العالم العربي”.
وشارك الشاعر والروائي والإعلامي ياسين عدنان عن بعد في هذه الندوة التي أقامتها دار الشعر في مقرها بتطوان. ياسين عدنان، الذي حل ضيفا على الندوة، يرى أن سؤال الجوائز يستحق منا أن نعطيه العناية اللازمة، لأننا غالبا ما لا نتحدث عن الجوائز إلا حين يتم الإعلان عنها، وذكر أسماء المتوجين بها، لكن قلما نتأمل في الجوائز الأدبية كظاهرة ثقافية، وقلما نتساءل عن القيمة المضافة لهذه الجوائز؟ وكيف تساهم في الرفع من سوية الإنتاج الأدبي.
هكذا، يتصور ضيفنا أن المدخل الأساس هو أن نعتبر الجائزة الأدبية آلية من ضمن الآليات التي لا غنى عنها في صناعة الكتاب، الذي يؤلف ويطبع ويوزع ويقرأ… هذه الدائرة التي تحتاج، بحسب المتدخل، “إلى عناصر تقوم بالتحفيز والدعم لعملية التأليف والقراءة. فمثلما تشجع الصحافة الثقافية على القراءة وعلى خلق تقاليد للقراءة، وتداول الكتاب في عالمنا العربي، تأتي الجائزة بوصفها آلية لها دور أساسي وجوهري في هذا المجال”. وقد أحصى ياسين عدنان أصنافا من الجوائز في عالمنا العربي، “بدءا بجوائز دعم الأدباء الشباب، على غرار جائزة الشارقة للكتاب الأول، والتي تكون حافزا للملتحق حديثا بمجال التأليف، في بداية مشواره الأدبي، لتكون حافزا له كيما ينطلق بشكل جديد، وحتى تحضنه وتخرجه من تلك الحيرة التي يعيشها المبدع الشاب، حين يبدع عملا أدبيا ولا يجد له ناشرا”. إنها جوائز أساسية، ودورها مهم في ممارسة نوع من الغربلة منذ البداية.
كما تحدث ياسين عدنان عن عدد من الجوائز القطرية التي تضمن بشكل سنوي نوعا من التحفيز للفضل والأجود، على غرار جائزة المغرب للكتاب، وجوائز مماثلة في أكثر من بلد عربي. جوائز “تتوج أفضل الإنتاجات في مختلف مجالات الإنتاج نقدا وشعرا وسردا وفكرا وترجمة… وهي حسب المتحدث “آلية تشتغل بشكل سنوي وترفع من سوية الإنتاج في هذا القطر أو ذاك”. قبل أن يصل إلى الحديث عن جوائز التكريم والتشريف والتقدير لمسار كامل، على غرار جائزة العويس، ومنها جوائز تمنح لكتاب راكموا حضورا لافتا للنظر يستدعي التكريم.
من جهة أخرى، يرى عدنان أنه “لا بد للكل جائزة أن تلزم حدودها، فلا يحصل التداخل بين الجوائز مثلا”. ويستحضر عضو مجلس أمناء جائزة العالمية للرواية “البوكر” تجربته في هذه الجائزة المرموقة. ففي البوكر، يقول عدنان، “لا يمكن أن تمنح الجائزة بسبب سطوة اسم صاحبها، أو أن تمنح له اللجنة الجائزة وهي تفكر في باقي منجزه الأدبي على مدى ربع قرن مثلا. ونحن في مجلس الأمناء نصر، دائما، على أن الجائزة للنص وليس للشخص”. من هنا، يجب أن تتعامل اللجان مع الأعمال التي أمامها، وأن تشتغل على المدونة المقدمة في هذه السنة دون غيرها، ومن بينها يتم اختيار النص الأفضل بغض النظر عن كل التأثيرات. كذلك، “لا بد من الانتباه إلى إعمال حد أدنى من الصرامة والجدية والمسؤولية، ومراعاة أدنى من المعايير لكي نحافظ لهذه الجوائز على مصداقيتها”.
لأن الجائزة في النهاية “آلية للتحفيز على القراءة، تدعم القراءة وتوسع من مدارها”. لهذا، ولكي يثق القراء في الجائزة “يجب أن تكون لها مصداقية”. وهنا تأتي مهمة مجالس الأمناء في كل الجوائز. “فمسؤوليتهم كبيرة في اختيار لجان التحكيم، والعثور على الأسماء الجادة والرصينة، التي يمكن أن تأتلف داخل مجموعة عمل على مدار سنة بكاملها، وأن يكون لها تجرد حقيقي من الانتماءات القطرية والمجالية والطائفية، وأن تكون اختياراتها خالصة لوجه الأدب”.
وحكاية الجائزة، حسب الشاعر والروائي صاحب “هوت ماروك”، هي أن “القارئ العام ليس له الوقت والأهلية ليقوم بنفسه بنخل كل ما يعرض عليه من أعمال، ولذلك فهو يحتاج إلى تلك السبابة الحكيمة لكي تدله على الأعمال الجديرة بالقراءة”. وخلص المتحدث إلى أن قيمة الجوائز إنما تكمن في تأثيرها على المجال السوسيوثقافي لصناعة الكتاب. “فالجوائز تفيد حتى في آلية النشر ذاتها، حيث تتعدد طبعات الروايات التي تصل القائمة الطويلة وخاصة القصيرة في جائزة البوكر مثلا. وحتى الناشرون صاروا يشكلون لجانا ويتقرحونها على مصحيين، قبل تقديم إصداراتهم للجائزة، وهذا كله يساهم في الرفع من سوية الكتاب”. والخلاصة عند ياسين عدنان هي أن الجائزة آلية ساهمت في الرقي بالكتاب العربي، على مستوى الطباعة والتحرير والشكل والقيمة الأدبية. وحتى الكتاب الذين يتطلعون إلى هذه الجوائز صاروا يعكفون بجدية أكبر على أعمالهم ويجودون نصوصهم حتى تكون جديرة بهذه الجوائز.
طنجة الأدبية