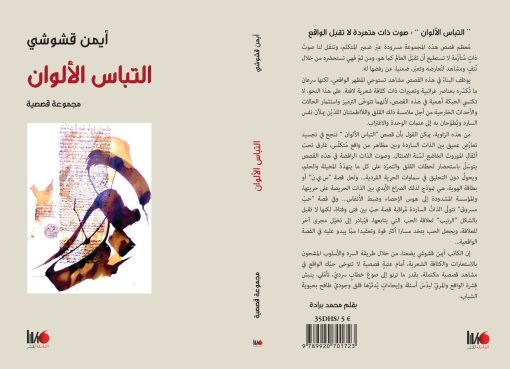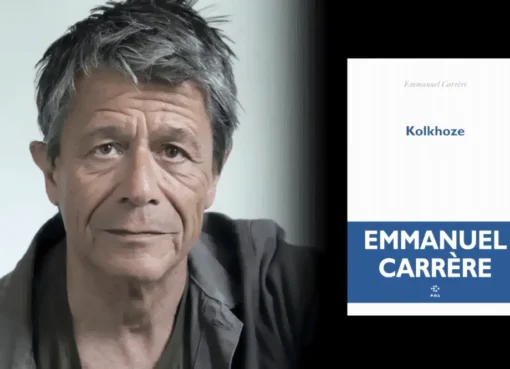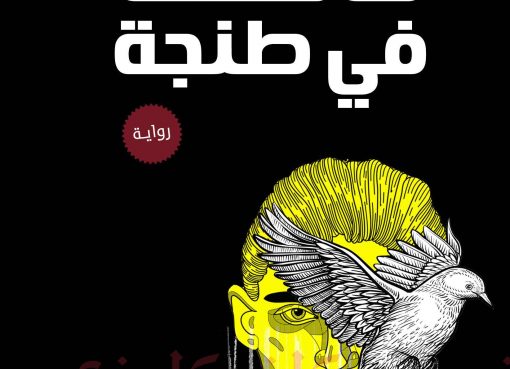احتضنت مدينة القنيطرة فعاليات مهرجان حلالة العربي الثاني لفنون القول في دورة خصصت للشاعرة مليكة العاصمي تحت شعار: كلام الغيوان جدبة وميزان.
وعرفت هذه التظاهرة الثقافية برنامجاً غنياً تنوع بين ندوات فكرية ومشاركات شعرية بمساهمة نخبة من الأدباء والشعراء والفنانين المتميزين، الذين أغنوا النقاش حول قضايا فنون القول وتجلياتها الجمالية والثقافية.
ويسعى المهرجان إلى ترسيخ مكانة فنون القول والزجل باعتبارهما تعبيراً فنياً أصيلاً ذا قيمة ثقافية واجتماعية، كما يهدف إلى حماية الذاكرة الشفوية وصون الزجل المغربي بوصفه حاملاً للوجدان الجماعي ومرآة نابضة للتحولات الاجتماعية والإنسانية.
شارك الدكتور. مصطفى يعلى ضمن فعاليات المهرجان بمداخلة في الندوة العلمية حول تجربة القاص إدريس الصغير السردية، موسومة ب
“إدريس الصغير إنسان يسمي الأشياء بأسمائها”
أ.د. مصطفى يعلى
بداية، أود قبل حديثي عن الصديق إدريس الصغير، بأن أعبر عن سعادتي بالمشاركة للمرة الثانية، بشهادتي الخالصة، في حفل تكريمه. كما لا أنسى أن أوجه شكري، في شخص الأخ عبد الرحمن فهمي، إلى كل الجهات المنظمة لهذا الحفل الثقافي الرصين.
لقد تعرفت شخصيا إلي صديقي إدريس الصغير، قبل خمسة عقود، أي زهاء أواسط سبعينيات القرن العشرين، بعد استقراري في مدينة القنيطرة 1968، وإن كان تعارفنا قد حصل قبلا في سياق رمزي، من خلال نشر وقراءة قصصنا منذ سنة 1966. وإنني لأستحضر كيف مضت صداقتنا تتمكن من خلال إحداثيات متوالية، حيث نشرنا على حساب كل منا في وقت واحد، مجموعتينا القصصيتين سنة 1976، فقد أصدرت مجموعتي (أنياب طويلة في وجه المدينة)، بينما نشر هو مجموعة (اللعنة والكلمات الزرقاء) مشتركة مع الراحل عبد الرحيم مودن، مع ما عانيناه من متاعب، خلال تعاوننا على توزيع المجموعتين، وكنا أيضا نوالي حينئذ في دأب ومثابرة، نشر نصوصنا السردية، في مختلف المنابر الوطنية والعربية. كما أننا التحقنا في وقت واحد باتحاد كتاب المغرب، وحضرنا معا والمرحوم عبد الرحيم مودن، لأول مرة مؤتمره الخامس سنة 1976، وتقاسمنا مطلع الثمانينيات، رفقة محمد بنطلحة والمرحومين عبد الرحيم مودن ومبارك الدريبي، تأسيس فرع اتحاد كتاب المغرب بالقنيطرة، ثم انطلقنا نَنْشط ثقافيا بالمدينة، وأنجزنا صحبة المرحوم عبد الرحيم مودن والأستاذ أحمد بطا، كثيرا من التظاهرات الثقافية الوازنة، التي تركت صدى طيبا في الساحة الثقافية الوطنية، طيلة عقد الثمانينيات، وأيضا شاركنا في عدد من التظاهرات الأدبية والقراءات القصصية، أهمها الأيام الثقافية السنوية لجمعية الإمام الأصيلي بمدينة أصيلة، أواخر سبعينيات القرن الماضي، وكذا الأسبوعان الثقافيان المنظمان من لدن اتحاد كتاب المغرب، برئاسة الأستاذ أحمد اليبوري، في كل من ليبيا والعراق سنة 1986.
ومما كان يلفت نظري، في الصديق إدريس الصغير، إبان هذا المسار الثقافي المشترك، سمةُ الصراحة المستمدة من صدقه مع ذاته. ولكي أكون دقيقا، أقول إنه كان دوما يسمي الأشياء بأسمائها، نظرا لتميزه في علائقه بالحياة وبالآخرين، بصراحة وصدق مخلصين، في زمن هيمن عليه الزيف والتفاهة والتطوس. ومهما كان الأمر، فهو ما كان يتأخر بحس بناء، عن الإدلاء بتحفظاته، إذا ما ثارت في ذهنه أسئلة استنكارية، عند إدراكه اعوجاجا في شخص أو مجموعة أو جمعية وما أشبه، تارة بتسديد التفنيد والمناقشة المباشرة، وتارة باقتراف الكتابة الانتقادية في الصحافة.
وبما أنه من بين مظاهر الصدق الفني، تقمص الكاتب للتجربة الإبداعية المعالجة، ومعايشة مواقفها وأبعادها، بعمق ووعي واستيعاب، فكذلك لم يكن في وسع إدريس الصغير، خلال مساره الإبداعي المديد، إلا أن يبوح بمخزون غضبه الغيور في كتاباته، بما لابسها من حرارة وتوتر، متوسلا بوجهات نظر متطلعة. وفي الإمكان تعزيز هذه الملاحظة نصيا، بالتقاط بصمات هذا التساوق، بل والتماهي، فيما فاضت به أولى رواياته (الزمن المقيت)، انطلاقا من عنوانها، إذ عالجت وضعية البطل المتأزمة، في خضم هيمنة القيم المنحطة على حساب بقايا القيم النبيلة. لذلك اعتلت فيها نبرة السخط والاحتجاج، وفوران الغضب على قتامة واقع مترد، تضيع فيه آدمية الإنسان، مما خلق جوا زاخرا بالتساؤلات المصيرية، والنقاشات السياسية بين البطل وباقي الشخصيات. وربما لهذا تم التركيز في الرواية على البطل الغاضب المحتج أساسا، وبضمير المتكلم، الحاسم في التعبير الاستبطاني عن الذات المأزومة، وإن تنوعت الضمائر في الرواية بين الغائب والمخاطب أحيانا. بينما لا تحضر باقي الشخصيات في فضاء الرواية إلا كذكريات، أو عبر لقاءات تحدث مصادفة، لكون معظمهم شخصيات روائية ثانوية، ولا نتعرف عليهم سوى من خلال عيني البطل، الذي ينتقل بينهم أو يتذكرهم من حين إلى آخر، عبر تقنيتي الاسترجاع والاستباق. وقد ساهمت فضاءات الرواية المغلقة والمفتوحة، المشحونة بشعور البطل بالاختناق والتوتر، والمعاناة، والتنفيس؛ في تجسيد جذوة الغضب على الواقع المختل، بينما قام فضاء طاميدوزا بدور المحفز للتأمل والشكوى والتذكر، واستحضار الماضي، حيث يندمج البطل في حوار صامت مع طاميدوزا، التي لم تكن برمزيتها في الحقيقة سوى مكون جمالي لاستبطان ذات البطل، فبدا الأمر كما لو أن بطل الرواية قد جرد من نفسه ذاتا أخرى، ليدخل معها في مونولوج داخلي دائم لا يهدأ.
وأنا أرى أنه من هذا الصدق مع الذات، تمخضت قابلية إدريس الصغير الوطيدة لعلاقة متينة بمدينته القنيطرة، التي ولد ونشأ بها ودرس واشتغل، فقد تشكلت من حب يومي متمكن، نما مع كل مراحل حياته، وجعله يتمتع بصفة الحاضر الغائب فيها، رغم اضطراره للعمل خارجها في بعض فترات عمله الماضية، مما يؤكد مقولة إن عروج الإنسان إلى محراب حب الوطن في إخلاص، ينطلق أولا من عتبة حبه لتراب مدينته أو قريته. ومن ثم يمكن القول بأنه إذا كان هناك من يغار على مدينته هذه بإخلاص وصدق بل وانفعال، فلن يوجد من يسبق إدريس الصغير إلى المقدمة.
وقد ترتب على ذلك الارتباط بالمدينة، عبور إدريس الصغير، إلى الانخراط في عدد من الجمعيات الثقافية بها، كما شارك بحيوية في كثير من التظاهرات الأدبية، التي تشرّف المدينة، وتثري شأنها الثقافي ومشهدها الحضاري، علما بأنه قد رأس فرع اتحاد كتاب المغرب بها، من أجل تنشيط الفعل الثقافي فيها على صورة مشرفة. ولعل أسوأ ما كان يثير المواطن إدريس الصغير، من متغيرات سلبية تجاه مدينته، ويجرح إحساسه بمصيرها، كونه يتابع مثل الكثيرين، ما طرأ عليها من مسخ لمظاهر الجمال فيها، بفعل غابة الإسمنت الكاسحة، التي طمست معظم معالمها الحضارية، ومسحت ساحاتها الخضراء الفواحة، ومسخت طابعها المعماري المميز.
ولا يمكن الحديث عن شخصية كاتبنا، من دون التوقف عند فعله الأدبي، ذلك أن إدريس الصغير مبدع موهوب، ومن النوع المثابر أدبيا، فعلى النقيض من كثير من مجايليه الذين ترحلوا عن الكتابة، لسبب أو لآخر، ظل هو يصارع الوقت، ويدأب على القراءة، ويعكف على الكتابة إلى الآن، بل إن إنتاجه قد تطور نوعيا وأجناسيا، بين القصة القصيرة والرواية والمسرحية، فضلا عن المقالات النقدية، مع إخلاصه الملحوظ للقصة القصيرة، وممارسة معالجتها طيلة عمره الأدبي الحافل، متعهدا إياها بالتجريب والوعي النظري لتقنياتها المعاصرة، وحتى إن انشغل بغيرها، فإن بصماتها تظل حاضرة فيها، بل إنه سرعان ما يعود إلى إبداعها.
وهكذا أمكن لمنجزه الأدبي، أن يصير مفعما بمزيد من التراكم الخصب، الذي تجلى خاصة في إصدارات مجموعاته القصصية (اللعنة والكلمات الزرقاء، عن الأطفال والوطن، وجوه مفزعة في شارع مرعب، معالي الوزير، حوار جيلين). وربما كان هذا هو السر الذي يقف وراء نوعية رواياته، التي يمكن تصنيفها ضمن الرواية القصيرة، هذا الجنس الذي أعتقد شخصيا أنه يعد أكثر الأنواع الروائية كثافة، وملاءمة للمقروئية، وهو مثل القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، أكثر أحقية للتعبير عن واقع العصر، المتسم بضيق الوقت والسرعة المذهلة.
والحق، إن الوقوف عند حد ما بذله المحتفى به، الأستاذ والكاتب إدريس الصغير، خلال عمر أدبي طويل، من نشاط وتنشيط للفعل الثقافي المشرّف، مُدَعمَين بكم محترم من الإصدارات الإبداعية المميزة في القصة القصيرة والرواية والمسرح، وإن ما حرص على تحقيقه من مد للجسور الثقافية بين المغرب والقنيطرة بالذات، وبعض أقطار العالم العربي، يتقدمها العراق ومصر، قصد التعريف بالحركة الثقافية في المغرب، وفي هذه المدينة؛ أقول إن كل ذلك من شأنه أن يضفي على هذا الاحتفاء أحقية أكثر من لائقة، فلا أحد يمكن أن يجادل في أن الكاتب إدريس الصغير أجدر بكل اعتراف وتقدير وتكريم مستحق.

أمينة بنونة