” الموسيقى ألغت إحتمال أن تكون الحياة غلطة ” نيتشه
شعور غريب إجتاحني حين فكرت في كتابة بورتريه حول صديق عزيز، جمعتني معه لحظات ومحطات موشومة في ذاكرتنا المشتركة. شعور ممزوج بالخوف والتردد، لأن الأمر يتعلق بقامة فنية كبيرة، أخاف أن لا أنصفه بهذه الكلمات التي لا تسعف دائما البوح بما في الفؤاد، فأكون قد ظلمت نفسي قبل غيري، خاصة وأن المعني هو الفنان الوليد ميمون الذي كان مجرد ذكر إسمه في سنوات الرصاص كاف ليستنفر أصحاب الحال أجهزتهم العلانية والسرية التي تعسفت عليه أكثر من مرة، رغم أنه ليس بزعيم لتنظيم سياسي جذري…تهمته الوحيدة؛ إمتلاكه لسلاح محشو بكلمة وصوت ولحن يجعل السامع يناجي السماء كي تستمر أغانيه في تغذية سغبنا الروحي الذي هو بوابة العقل والفطنة في زمن أريد للعامة المسحوقة أن تساق وهي مجردة من أبسط شروط الآدمية، وتحمد الحامد على ما هي عليه!.
الوليد ميمون لم تستهويه يوما الشهرة ولا الإغراءات المادية، فهو بطبعه ميال إلى العزلة في شقها الإيجابي الذي يقوده نحو اكتشاف أنغام الطبيعة مع التنقيب عن تراث الريف الموسيقي المبعثر هنا وهناك قصد الإستفادة منه دون السقوط في التقليد الممل. وقد سطع نجمه إبان فترة السبعينات والثمانينات التي عرف فيها الريف عموما نهضة موسيقية موازية لباقي الفنون بفضل احتضان الجمعيات الجادة لهذه الطاقات الإبداعية خاصة جمعية الانطلاقة الثقافية بالناظور وجمعية البعث الثقافي بالحسيمة وجمعية إلماس فيما بعد، الشيء الذي يجعلنا نتحسر على ما مضى حين نقارنه بالحاضر وما يحتويه من تفاهات في الأغنية الريفية سواء تعلق الأمر بالأداء أو المضمون أو اللحن..والتي طغت على الرسمي إلى درجة جعلتنا نشك في حقيقة نواياه، فالترويج للأغنية الرديئة كمعيار للأغنية الريفية يحمل أكثر من علامة استفهام؟؟؟.
لذا،من حق الوليد ميمون أن يأخذ بينه وبين الإعلام الرسمي مسافة حتى لا يزكي العبث، فوحده السمك الميت من يساير التيار بلا مقاومة، علما أن الغالبية منا استبشرت خيرا حين تأسست قناة تلفزية تعنى بالهوية والثقافة الأمازيغيتين، لكن مع برامجها الباهتة،شكلا ومضمونا، بدأت تتضح لنا الصورة أكثر فأكثر،ولم تعد سياستها الرامية إلى تسفيه وتمييع الرسالة الفنية النبيلة للأغنية الريفية خفية. للتاريخ أقول: الوليد ميمون كان يحتاط منذ بداية الترويج لمثل هذه المشاريع وطبيعة الجهة الساهرة على إخراجها إلى الوجود. طبعا كنا نعاتبه على موقفه المبني على النوايا فقط! لكن الزمن أثبت أن قراءته للواقع كانت صائبة، أما نحن مجرد ضحايا للموجة التي ساقت الغالبية بشعاراتها المغرية.
لا أريد التطرق إلى الجانب المتعلق بنشأة الوليد ميمون ومحيطه العائلي ومساره التعليمي…فقد قيل فيها ما يكفي، كما لا أدعي أيضا الإلمام الذي يمنحني حق تقييم أغانيه ومدى إنسجامها مع الآلات الموسيقية المستعملة في الأغنية التراثية على سبيل المثال لا الحصر، لكن أزعم أنه بفضل أغانيه وأغاني التوفالي، وعلال شيلح، وبنعمان،وتواتون، وثيذرين، وحسن تيبرين، و…( المعذرة للذي ينامي إلى جيل رواد الأغنية الريفية الملتزمة ولم أذكره) بفضل هؤلاء الذين غنوا أغاني خالدة عن الهوية الامازيغية والتراث والمقاومة الريفية والفلاح والعامل…أدركنا أن الفن كلغة عالمية لا يرقى إلا بالخصوصية المحلية، واكتشفنا من نحن عندما اقتحمنا عالمهم المليء بالعواطف، عالم الأحلام الثورية والانكسارات التاريخية، ومع ذلك فهو عالم لا يخلو من الأمل في الغد الأفضل.
بقلم: خالد قدومي



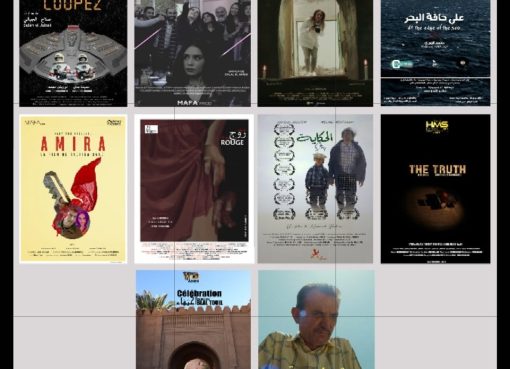

الأدب المغاربيالأدب المغاربي:
عرّف علماء الاجتماع الأدب بأنّه “كلّ شيء يمت إلى الحضارة بصلة”؛ وهذا التّعريف واسع بشكل كبير، لذلك نراه مرّة ينحصر في النّتاج الفكري الرّفيع؛ ومرة يختصر في الكتابات العلمية والأدبية والتّاريخية والتّشريعية وسواها؛ ما أوجد نوعا من الالتباس، وأوحى بتشابه المقاييس أو غيابها. ومن الواضح أن مفهوم الأدب اليوم قد صار أكثر تحديدا عما كان عليه في الماضي فمن المعاصرين من رآه “أحد مظاهر الفن المتعددة ووسيلة في الخلق أو التّعبير أو المحاكاة هي اللّغة، ومنهم من رأه “تعبيراً عن تجربة شعورية في صورة موحية” ، ومنهم من عرّفه بأنه “تعبير عن الحياة وسيلته اللغة ” ؛ لذلك يمكن القول: إنّ الأدب إنتاج فكري وجداني صيغ بأسلوب فني ، فجاء تعبيراً عن حال إنسانية مقدمة وفق تجربة شعورية خاصة، بل يكمن القول: بأنّ الأدب هو تعبير باللغة عن تجربة إنسانية شعورية بأسلوب فنّي خاص. وبهذا التعريف تظهر عناصر الأدب بعضها بمثابة المادة وهي التّجربة الإنسانية بمكوناتها، وبعضها يتحقق في بناء العمل الأدبي من هذه المادة يسمى المحتوى، والمادة ومحتواها مترابطان ترابطاً عضوياً. ومن هذا المنطلق تكون التجربة الإنسانية الشعورية هي صلب العمل الأدبي الذي يمكن أن نصنفه وفق جغرافية الحدود والمشاعة والخصائص المجتمعية.
أمّا مصطلح مغاربي؛ فهو أيضاً، مصطلح حديث على مستويين: الأوّل لغوي أثير في مجامع اللّغة العربية، حول نسبة الجمع بالياء، والثّاني مكاني متعلّق بجغرافية الأدب هناك وطبيعته. وهذا ما جعل الالتباس قائماً حول استعمال مفردتي “المغرب العربي” أو “الدّول المغاربية”. فالمغرب بفتح الراء ضد المشرق “بلاد واسعة، وقال بعضهم حدها أفريقية إلى آخر جبال السوس وتدخل فيها جزيرة الأندلس”(1) ، وقال بعض المؤرخين:”إنّ المغرب سمّي بجزيرة المغرب ويمتد من ليبيا إلى نواكشوط”(2).
والملاحظ في كلّ ذلك أنّ التّسمية لإستحداث جديد، عملت الدّول الغربية على “نشره في بداية القرن التّاسع عشر، بعدما تقاسمت كلّ من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا دول المغرب”(3)، وفرضت على مستعمراتها نمطاً خاصّا وفق سياسة المستعمر نفسه.
وهذا ما جعل موضوعنا شائكاً في معالجته لمصطلحات إصابتها الحداثة في بنيتها اللغوية ودلالتها المعرفية وأضفت عليها مفاهيم جديدة يختلط فيها الأدبي باللغوي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي. وهذا ما جعل الالتباس قائماً على غير مستوى، والتأثير متداخلاً في جوانب جمة، وهو ما سنحاول كشفه من خلال دراسة تأثير العولمة في الأدب المغاربي بين (1991-2001) متخذاً من الرّواية التّونسية أنموذجاً. فالدّراسة في هذا البحث تتناول المنظور الحضاري؛ لأنّه يمنحه رؤية واضحة في إدراك التغيرات. وهذا ما سنحاول كشفه انطلاقاً من جدلية التّأثر والتّأثير بين الأنا والآخر في الإبداع الرّوائي التّونسي بمدونتيه الفرنسية والعربية”(4)، لذلك فإنّ البوتقة الّتي انصهر فيها هؤلاء الأقوام هي مزيج من الأعراق كما هي مزيج من ثنائيات تتوزع بين:
– الصّحراء والسّاحل
– الخضرة والجدب
– التّرحال والاستقرار
– الجراد والجمال والتّيه // المزارع والحظائر.
ولكلّ هذه الخصوصيات أماكن لافتة في الأدب المغاربي، سواء كان مقاوماً للاستعمار، حاملاً جرحه ذاكرة وشهادة عبور لأكثر من زمن قادم كما في رواية رصيف الزهور لمالك حداد وذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، أو متمسكاً بالأرض الهاربة منه كما في سهل الغرباء لصلاح الدين بوجاه، أو تائهاً في الصحراء الإفريقية يبحث عن النّفط مع شركات الاستثمار الغربية كما هو الحال في معظم كتابات محمد القشاط وإبراهيم الكوني، أو يبحث عن رشفة ماء في رحلة البحث عن النبوة والخفاء والأحجية” لأن أبناء الصحراء كلّهم أبناء نبوة”(1)، بل يطارد كلّ شيء؛ لأنّ الإنسان في منظورهم “لا بدّ أن يطارد حتّى إذا لم يجد ما يطارد اختلق طريدة حتّى لو كانت هذه الطريدة وهماً أو أكذوبة أو خيالاً، مثله مثل كل أنوبي في هذه الصحراء”(2)؛ لأنّه في مختلف المطاردات في حاجة أن يعرف “من أنا”(3)؛ كأن المطاردة في حد ذاتها هي حالة بحث عن الذات والحقيقة التي تختزلهما مفاهيم الأبوة والأمومة.
كما أنّ جلّ الرّوايات الّتي سنتناولها شغفت بموضوعات الوطن والذّاكرة والأولويات الاجتماعية؛ وبين كلّ ذلك هجرة وعودة ورحيل وانتقال في مغرب غرب عنه الكثير من المعاني وبقي البحث وحده تائهاً في معاني الهوية والجذور؛ أعربية أم بربرية، طارحا الأصالة مرّة، وأخرى عازفا عنها محاولا مواكبة المعاصرة ليغرق في مساحة يحكمه نصّ على لون المغرب، تتجاذبه غير قومية وتميّزه غير ثقافة.
الدكتور الفاضل الكثيري- تونس-