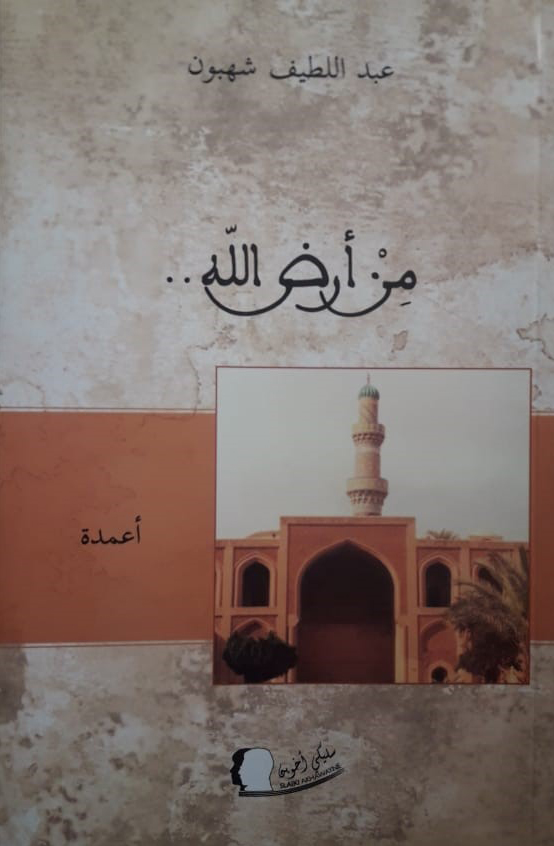في إطار “مشروع ابن خلدون” المثمر الذي حظيت بحمل مسوؤلية الإشراف على محور موضوعاتي من محاوره الثرية بمعية نخبة ممتازة من أساتذة الجامعة المغربية وباحثيها وطلبتها بعنوان ’’المغرب بعيون أجنبية / العالم بعيون مغربية‘‘ (كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان ـ جامعة عبد المالك السعدي، 2018ـ2019)، وهو المشروع العلمي الكبير الذي يرعاه بكفاءة “المركز الوطني للبحث العلمي والتقني” (CNRST) بالرباط ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي(المملكة المغربية)، جمعنا متنا أدبيا مهما من الرحلات والأعمال والكتابات السفرية المغربية والعربية والأجنبية يمتد على العقدين الأخيرين من تاريخنا الراهن (1999ـ2019). وفيما يلي قراءة ـ لا نريدها شاملة مستقصية بل جزئية محفزة ـ لمؤلَّف متميز براهنيته الفكرية المستفزة وجذاب بمتخيله الوجداني العميق وقّعه كاتب مغربي مخضرم لا يكف عن عشق الأسفار وممارسة الكتابة ـ يوميا ـ بشتى طقوسها الفنية في أصعب أجناس السرد الواقعي (نزار التجديتي / آداب تطوان).
يضم كتاب الأستاذ عبد اللطيف شهبون الأخير “من أرض الله.. ـ أعمدة” (طنجة، منشورات سليكي إخوان، 2019، 171 ص)، وهو من القطع الصغير، محكيات أسفار وملخصات جولات عدة، قام بها هذا الأديب الرحالة القلق عبر أرجاء العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من تسعينيات القرن الماضي إلى بدايات العقد الثاني من هذا القرن، باعتباره إما مناضلا حقوقيا أو باحثا أكاديميا أو عليلا يطلب الشفاء أو سائحا صوفيا يزور المقامات ويقف عند العتبات مستشهدا ومعتبرا ومتأملا في أسرار المكان ودلائل الزمان وحكمة الناس العاديين.
الكتاب أضمومة مختارة إذا من الزيارات والمقامات والسياحات الطويلة والقصيرة في آن واحد استعادها الكاتب الصحفي من الذاكرة النشيطة والمخيلة الحية على شكل “أوراق” سريعة و”شذرات” صحفية وجيزة و”نصوص” تأبى التجنيس والتنميط الجاهزين، تمتد من بلاد الغال مورد آماله إلى شفشاون موطن أجداده، نشرها في “عموده” الأسبوعي بـ”جريدة الشمال” (طنجة) على حلقات غير متصلة في الزمان: من قلب فرنسا، ومن جنوب إفريقيا ، ومن فنلندة، ومن العراق، ومن مصر، ومن البرتغال، ومن تونس، ومن لبنان، ومن سويسرا، ومن فنزويلا وجزر الكاريبي، ومن إسبانيا والفردوس المفقود إلى حمادات الصحراء المغربية، فحاضرة شفشاون الصغيرة مرقد الأولياء والفقهاء في أعالي سلسلة جبال الريف.
’’في وضعه الصحي الحرج يتجه بكليته إلى خالقه..
في أتون حياة باريسية تحكمها منظومة التهامية.. تلتهم الناس ويلتهمونها يجد نفسه منحشرا‘‘ (ص 16)
ليس الكتاب محكي أسفار بالطريقة التقليدية أو الصيغة السردية المألوفة تلك التي يتابع فيها الرحالة وصف مساره الرحلي من البداية إلى النهاية واستطلاععه الجغرافي والحضاري في الفضاء المزار عبر محطات فضائية محددة موقعة بأوقات السّاعات ودورة الأيام وتواريخ السنوات، بل هو باقة نثرية من المرويات المتحررة كليا من ضغط الزمن الآني أو السياق الظرفي الذي استدعاها (سفر علاجي، حضور أعمال مؤتمرات دولية حقوقية، دعوة للمشاركة في دورة علمية، إلخ) وإغراءات الدليل السياحي المعتادة (معالم شهيرة، حدائق خضراء، متاحف معروفة، أضرحة مرموقة، مؤسسات عظيمة، تماثيل عملاقة، شخصيات عظيمة، إلخ). إذ يؤكد المتلفظ، المحلق في أيقونات الحيز المتاح من العالم وأضوائه وأهوائه الوهاجة، لقارئه بأن:
’’السفر افتتان بالمجهول. هكذا كان منذ هيرودوتس اليوناني، مرورا بالمواطن العالمي ابن بطوطة إلى يومنا هذا… وأما زاد المسافر فهو التوقف بكل قواه عند الصور العالقة بالآخرين، بالتجارب الإنسانية، بالثقافات، بالروائح، بالأذواق الجديدة التي يضيفها إلى مخزونه الغميس… وقد يعود المسافر إلى المكان ذاته؛ يقف ويستوقف لاستكمال ما عاشه واستعادة لحظات…‘‘ (ص 58)
هذه الأوراق الصحفية ـ بالمعنى النبيل للكلمة ـ لُمَعٌ نثرية مكثفة جدا من الشذرات السردية والأوصاف والأقوال والنصوص والأسماء والإشارات والمعلومات والأخبار والأشعار، لا يؤطرها ـ في واقع الورق الأنيق ـ إلا منطق “اللحظات” السفرية الدالة (مقاطع من التجربة الزمنية تتعلق بالمكان لتترسخ في الذاكرة الانتقائية والمخيلة الخصيبة بفضل زخمها الرمزي الحاضن)، في جانب السرد والشهادة والاحتجاج والرفض، وبلاغة الانسياب، في جانب اللغة والأسلوب المعتمدين في التعبير والوصف والتصوير:
في رحلة العلاج بباريز ـ عاصمة الأنوار ـ مثلا، لا يقف الرحالة بعصا الراجي عند وهن الجسد وزيارة عيادة كبار الأطباء الفرنسيين والاستماع إلى تشخيصهم الدقيق لواقع الحال لحظة عسيرة ومريرة يتوجه فيها إلى الله في نهاية المطاف إلا لينقلنا بعد ذلك ـ على سبيل التعويض والإمتاع والإفادةـ إلى لحظة ذهنية أصفى وأحلى بمقهى “سان مالو” بحي “مون بارناس” يستعرض على “صفيّه” قراءات أدبية ومتابعات ثقافية ومواقف سياسية متواصلة “ينحشر” بها هذا “القاعد الماشي” ـ كما يصف السارد ذات المؤلف بين سرير التشخيص وحركة المريض المؤمّل ـ في سياق موجات “الالتهام العارم” التي يتميز بها الباريزيون للمقروء (جرائد، كتب، مجلات…). فتتغلب النصوص والإحالات والقراءات الجديدة على حاضر الألم معبرة عن قوة تناص ثقافي هائل ومتجدد لا يكف الكاتب الصوفيّ المؤمن عن الاندماج في أفقه المذهل هو “الأدب الجامع” بمعناه العام والرحب.
وفي دربان، بجنوب إفريقيا، لا يُنسي الموقف الحقوقي المناهض للتطبيع مع الصهيونية العالمية المتخذ من طرف المؤلف إلى جانب الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الدولي الثالث المناهض للعنصرية (2001) “مفارقات” المشهد الجغرافي الباهر (المحيط الهادي) والمشهد الإنساني البائس (السود البائسون) لهذه الحاضرة الإفريقية العتيدة رغم نهاية نظام الأبارتيد وعودة نيلسون مانديلا من غياهب السجن مكللا بالنصر وحكم حزب السود في هرم الدولة:
’’تنام وتصحو مرابع دربان في حضن المحيط الهندي. دربان هاجعة يقظى، يغرق سكانها البيض في نعيم مادي، ويعيش مواطنوها السود حياة ذابلة، يثنيهم القبض، ويلفهم العسف، ويعصف بهم الخسف‘‘ (ص 37)
وفي العراق أيام الحصار الظالم قبيل منتصف التسعينيات من القرن الماضي، سمحت المناسبة الحقوقية بتحويل الخطو الليلي العابر في الأزقة والحارات القديمة إلى مقام ومحج٫ فابتهالات وزفرات٫ آي الي مكاشفة روحية عجيبة عند بعض العتبات البغدادية الشهيرة مثل ضريح مولاي عبد القادر الجيلاني، و”حي المنصورية” (نسبة إلى مقام الحسين بن منصور الحلاج)، وضريح الشيخ معروف الكرخي. نتج عنها ارتقاء روحاني متصاعد في أرجاء النفس، تلاه حسرة الزائر في “شارع المتنبي” على الأحوال المزرية لأدباء بغداد وعلمائها وما يضطر إليه هذا الملأ في زمن الوجع والشح والأزمة من بيع خزاناتهم النفيسة بأبخس الأثمان، وشيء من الفضول الثقافي أسفر عن سلسلة مفاجآت واكتشافات ومقتنيات وقراءات في تفسير ابن عربي وديوان الحلاج بين محجات بغداد المجيدة وقاهرة المعتز.
’’أنفقت جهدي، يروي الكاتب بعد الأوبة إلى الديار، كي أستحضر ظلال أيام قضيتها في بغداد… في بغداد كان قلبي مملوءً بأمن روحي قوَّى لديَّ أملا أثيرا حبيبا لزيارة عتبات أولها ضريح مولاي عبد القادر الجيلاني‘‘ (ص 60)
وهلم حكيّاً… من رحلات خاطفة، ومقامات وزيارات دافئة، ولذائذ أسفار وجولات لا تُستذكر في آناء الليل وساعات النهار إلا برضى عميق أو يشار إليها بين الأحباب بأسى المريد الولهان، ولقاءات إنسانية متتالية لا تسجل في دفتر الأحياء إلا بحس حقوقي عال أو موقف سياسي ثابت أو مشهد رامز يلخص جوهر السفر إلى روابط المكان وكم فيه من عظة أو عبرة للعابر المتفاني، وصداقات جديدة تتشكل يوما بعد يوم علي مقاس القيم المشتركة٫ ومصاحبات إخوانية غالبا ما تقرن هنا وهنالك٫ في هذه المحطة الصاخبة أو تلك الهادئة٫ بالإيثار والمحبة والمكاشفة والمشاركة، هي خير ما يَنسخ به القلم السارد آثار المسافر ورفاقه الكثر ولقاءاتهم الوجدانية في أرض الله الواسعة.
أما اللغة السلسلة والعبارة الموحية التي يأخذنا بها الراوي إلى هذه العوالم الزكية فجأة أو بعد استعداد وترتيب ورياضة كاملة لموسيقى الكلمات الأثيرة ومعانيها ودلالاتها الخصيبة في صلب القاموس اللغوي المعاصر، فهي الحركة الانسيابية التي تميز السياحة الثقافية لهذا الرجل اليقظ أو هي بالأحرى الأسلوب الوسط الذي يخاطب الجميع بروح الوقت وبلاغة العصر، لا يزايد على متعلم ناقص أو يتطاول على متأدب متبحر، ولا يتغلب الأسلوب الجزل الرصين على الأسلوب الخفيف العذب، ذلك الأسلوب الإنشائي الحيويّ الذي يسم الصحافة الثقافية الحقة التي نفتقدها اليوم في معظم الجرائد والمجلات والمدونات الوطنية المنشورة.
كذلك، يحكي السارد، المستنجد بـ”ماء الذاكرة” وآبارها العميقة في صحراء الروتين اليومي، أسفاره القريبة والبعيدة في أصقاع المعمور بلغة ميسرة وسلسلة لا يتجشم فيها العسر، ولا يثقل على القارئ بتشدق معجم بدوي غريب واحتفال بصيغ الفصحى العتيقة ما دامت غايته ريادة الآفاق الرحبة للنثر السفري الراهن والتواصل المباشر مع عامة القراء الذين أصبحوا بفعل الضغط الرهيب لتقنيات التواصل الجماهيري من أيتام الزمن الأدبي وفقراء الله والكتاب.
وفي إطار هذا الإنشاء الواضح والبليغ معا، لا يأنف الكاتب المتماهي مع أصوات ولغات عالمنا المتغير ـ وهو أيضا شاعر له دواوين يرتقي فيها بالذات إلى الأعالي ويبتهل، وكم يتحسر ويدمع وينكشف إليكَ وإليَّ ـ من التعبير الشاعري الفائق كلما سنحت السانحة، وسرحت به المخيلة الخلاقة في زمان اللحظة السردية الآسرة وتعطش صاحبها إلى رونق الأمكنة التاريخية وعبقها الفوّاح بين أمهات الحواضر القديمة واستعصى الكلام العادي في المدائن الجديدة عن البوح الصريح بما هو سامي ومطلق ومتعال. حيث يستفسر السائح المتأمل على هذا النحو المتضامن مع سواد الناس:
’’كنا مندهشين إزاء ما تقع عليه أبصارنا، مصدومين أمام مظاهر بؤس الناس في القاهرة، قلب العروبة النابض.. ونتساءل، : إلى أين يصير هذا البلد؟ كيف استبدل ثراءه الحضاري وبدّده باقتصاد هجين تسيطر عليه الجماعات الأصولية؟ القاهرة قاهرة، وهي مهوى النفوس والقلوب لا تتيح لأبنائها سوى عيش نكد..؟‘‘ (ص 69ـ70)
بعبارة مختصرة، نجح عبد اللطيف شهبون في مسعى تحرير كتابه “أرض الله..” من الحشو المعيب والاستطراد القبيح والاختصاص المستثقل، فقدم لنا أكثر من أعمدة صحفية تقليدية ومقالات سفرية سريعة. صحيح أنه لا يدّعي في هذا السفر المُستَقطر من أريج التجربة الصوفية ورياضتها الذوقية نهجا وصفيا جديدا ولا يطمح في تدوين هذا العبور القلق خطا سرديا خاصا به، لكن محكيات جولاته الطبية والحقوقية والأدبية الحزينة تارة والمشرقة تارة أخرى في بعض بلدان العالم تمتطي ـ رغم تواضع صوت ساردها ـ الأجناس الأدبية والخطابات غير الأدبية بمرونة لغوية نادرة وإبلاغ وازن لتتقمص مجهول المتخيل السردي في تغيره الفيزيائي الدائم وتناصه الثقافي المتعدد، وتستخلص لنفسها “نصا جامعا” تتفاعل فيه الأنواع والأنماط الثقافية المتباينة وتتنافس وتتعايش الأجناس الأدبية إلى جانب بعضها بغير عنف ولا غرور (رحلة، فسحة، لمعة إخبارية، نكنة، تحقيق، استطلاع، نقد سياسي، ابتهال صوفي، إلخ)، حيث يكمل بعضها نقائص البعض في أفق أدبي مندمج، مما يحقق لدى القارئ صيرورة الحبكة ويؤجج متعة التشويق ويبعث على المتابعة المتحفزة، ويدفعه ـ في كل مكان يُدعى إليه من قبل السائح ويُستضاف هنيهة ـ إلى التساؤل والتأمل والاعتبار.
نزار التجديتي