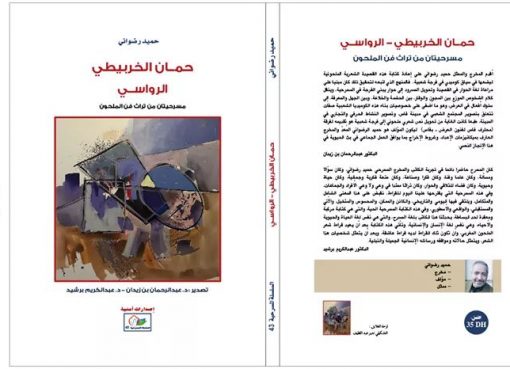أولا: الجائحات وعقدة الاتجاه المعاكس للدين
من الملفت للنظر ،وخاصة عند هذه الجائحة العابرة للقارات وفي الوقت المعاصر،تكثيف الحديث عن الدين والعمل الروحي ودور المعتقدات في مواجهة المصائب والعثرات التي تتعرض لها البشرية بين الحين والآخر.
وهذا التداول لمواضيع الدين،وخاصة الإسلام خاتم الأديان والشرائع وكمالها ومكملها وناسخها، قد يختلف بين فئة وأخرى ومعتقدين وغير معتقدين،ومستفيدين ومتضررين ،وبائعين ومشترين ،وراكبين ومركوبين…والكل يبدي ما في جعبته وينفث ما في حنجرته ويرشق بما في يده ومتناوله.
وحينما نتحدث عن الاستحضار فذلك يعني أن الأمر مستحدث وطارئ بحسب الطارئ الجديد،إذ الدين حاضر بالقوة والفعل في كل زمان ،وفي ظاهر وباطن الإنسان ،سلم بذلك البعض أم لم يسلموا شعروا أم لم يشعروا.ولهذا فقد يكون الاهتمام به في سائر الأيام العادية كما هو الأمر بالنسبة لعلاقة الإنسان أسود الرأس بالسماء الجميلة الزرقاء تتوسطها الشمس الساطعة نهارا،و المرصعة ليلا بالنجوم والكواكب والثريات،ومع ذلك فقد لا تثير اهتمامه حتى ترسل نحوه شهابا ساطعا ولهبا أو صخورا مدمرة.حينذاك يلتفت إلى السماء ويتوقع منها المزيد أو الانتهاء.
وهذا هو عينه معنى الاستحضار الديني ،وخاصة في حالة الجائحات كما هو الشأن حاليا مع فيروس كوفيد19 وغيره .وذلك لأن هذا الوباء بطبيعته يهدد الحياة وينذر بالفناء، في حين أن الدين يبشر بالبقاء وضمان استمرارية الإنسان في عالم الخلود وتحقيق السعادة لمن سلك طريقه، وعلى العكس من ذلك،فقد ينذر تخويفا بالشقاء ،والعياذ بالله ،من حاد عن مسلكه وكفر به وأنكره.فيكون المنكر أحد أكبر الخاسرين وأكثر القلقين والمتوجسين والمهلوسين ! .
حتى قد يدفع البعض رعبهم هذا إلى سلوك الاتجاه المعاكس والمشاكس، الذي يعني الانتحار الأبدي وتضييع فرصة الخلود، الذي هو من خصائص النفس الإنسانية وميلها الطبيعي نحو حب البقاء وضمان استمرار النوع . وفي هذا الشذوذ النفسي لدى المنكر للدين في زمن المصائب يقول الله تعالى في القرآن الكريم:” وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا”،”هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ”.
هذا هو حال الإنسان مع الدين ،فهو إما معاكس ومريض بمرض الصفراء التي تحيل مذاق العسل مهما كانت حلاوتها وطراوتها إلى مرارة زعقة، فترفضه النفس بالرغم من أنه فيه دواء وشفاء.وإما مخادع ولا يسلم إلا حينما يكون الخطر داهما إياه مباشرة ولا مفر منه ،فحينذاك قد يعمل على المناورة واستغلال العقيدة ،ليس من باب التسليم الإقناعي الطبيعي ولكن من باب الاضطرار والتحايل للعبور نحو الشاطئ الآخر ،ثم بعد ذلك ينسى وينكر ما كان عليه وما مر به وكأنه لم يكن شيئا مذكورا.
وموضوع الأوبئة ووظيفتها الدينية تحتمل هاتين الصورتين بالنسبة لغير المتدينين والمستغلين للدين: إما رفضا مطلقا وإما استغلالا سلبيا حتى اجتياز المرحلة ،ومن بعد قد تعود حليمة إلى عادتها القديمة.
وحيث إن الوباء له خصوصية الانتقاء وطلب أصحابه الذين هم من نصيبه ،وبما أنه غير مرئي في سرحانه وسريانه وجريانه ،فإن الغالب على كثير من المغفلين والحمقى هو توهم النجاة دون غيرهم، مع الخوف الدفين الذي قد يدفعهم للطعن في الدين أو الاستهزاء به وبالمعتقدين فيه.وهذا يعني عمق المرض وتجدره ورسوخه في نفوس هؤلاء ،حتى إنهم قد يرمون بأنفسهم في النار هربا مما هو أقل منها خطرا.أو أنهم يحومون حولها بغير علم بقوانينها كالفراش الذي يحرق نفسه بنفسه !.
ومن الأوهام التي قد تستولي على هؤلاء هو الحديث عن وظيفة الدين ودوره في الوقاية من هذا الطارئ المفزع.وكذلك دور دور العبادة ،من مساجد وزوايا للذكر والتربية ،في هذا الوقت مع الإغلاق والتعطيل من حيث التطبيق الجماعي،وكأن الدين في هذه الحالة لم يكن ولم يعد له دور عقدي ونفسي وتربوي أخلاقي ،وكذلك لم يكن له أي حضور اجتماعي واقتصادي أو حتى سياسي.أي بمفهوم هؤلاء القاصرين ذهنيا وعقديا وفكريا كأن الدين ومؤسساته لم تكن سوى سالب زائد سالب.وهذا قياس فاسد وقصور علمي وخلفية مريضة تريد أن تعضض اليد التي تمد لها لتنقذها وتكسر المحقن الذي فيه دواؤها ونجاتها من البتر والتعفن.
ثانيا: الوظيفة الرائدة للدين في ظروف الجائحات
بحيث قد كان الأولى بهؤلاء أن يضربوا في المؤسسات المادية قبل الروحية في هذه الحالة،كالنوادي الثقافية والمراكز الرياضية والجامعات العلمية والملاهي والمنتزهات الترفيهية ،بل كل تجمع بشري هو الآن معطل تعطيلا حقيقيا وعمليا.وعلى العكس من ذلك فالدين في الحقيقةلم يعطل ولم يلغ أصلا،بل ازداد حضوره إلحاحا ،وذلك لأنه عمل روحي قبل أن يكون مؤسساتيا جداريا، وهو عقيدة واعدة ومساعدة ومقوية للأمل ولوحدة الشعور بين البشر ،وفي نفس الوقت سبيل للشفاء ورفع الوباء بالتبتل والابتهال إلى الخالق سبحانه الذي بيده الأمر كله.ولولا بقاء سماع الآذان في الصوامع والمساجد وذكر الله عبر شتى الوسائل وفي الزوايا لكان حال النفس البشرية عامة خواء وخراب وسراب ورهاب لا يطاق ولا يحتمل !.لأنه لا صوت يمكن له أن يضمن الأمل والفأل الحسن غير حسن الظن بالله تعالى والرجاء فيه وتوقع استجابته لأدعية وتضرعات عباده الصالحين وأوليائه المقربين.
في حين أن تلك المساجد والزوايا هي عبارة عن مستشفيات قائمة بذاتها ،تشرح الصدور وتطمئن القلوب وتعالج النرجسية والغرور والتوحد والكبر والعجب وما إلى ذلك من فيروسات وكورونات لا ترى بأي مجهر ولا تكتشف عند مختبر !.كما أنها مطهرة صحيا بكل ما تحمل كلمة تطهير من كلمة ،حيث الوضوء المستمر والنظافة الدائمة والمشروطة والروائح الزكية المريحة.إذ المسجد مكان للعبادة وهو”أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ”.هذا إذا علمنا بأن العبادة في الإسلام ليست محصورة في المساجد المشيدة فقط ، وإنما كل الأرض هو مسجد ومقر لممارسة الصلاة والذكر وعلى جميع الهيئات والأعداد ،فرادى أو جماعات كما قال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:”و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل”حديث متفق عليه. و الصوم في رمضان أيضا له نفس الحكم مع إضافة جانبه الصحي البدني الذي يسلم به المؤمن والكافر ويعترف به الأطباء الصادقون في مهنتهم ودراستهم ،ومن أحكامه وأوصافه أنه وقاية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم:” الصيام جُنَّة” أي ما يُجِنُّك أي يسترك ويقيك مما تخاف.و” لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ”،ومع هذا فقد رخص الإسلام للصائم بالفطر عند وجود مرض يقدره بنفسه أو يقدره له الأطباء وليس السفهاء والسخفاء !.وأقول عند وجود مرض لا قبل وقوعه أو توقعه وتوهمه ،مع ترك الأصل قائما وهو :” وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ”، إذن فلن يعطل الدين أبدا وإنما العطل قائم في أذهان السفهاء والبطالين والفارغين من القيم والعلوم الصحيحة !
ومن السخرية أن تنسب القوة والفعل والفتك إلى كائن جزئي مجهري مجهول ولا ينسب قرار التأثير وحقيقة الداء إلى خالق ذلك الجزيء نفسه ومسلطه بوجه ما ،والذي بيده دواؤه وسببه .وهذا من ضعف الإنسان غير المعتقد في الدين وهزالة ونذالة تصوره حينما ينكر خالقه ومعه الدين الذي شرعه له حتى أصبح من أصغر الصاغرين في مواجهة أدق المرئيين، لا هو من الإنسيين ولا من الجنيين فيا للعجب العجاب !. ولقد كان من اللازم أن يوضع مثل هؤلاء في حجر صحي ،ليس بالمنازل فقط ولكن بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية حتى يعقلوا ويرشدوا!.يقول أبو العلاء المعري:
قالَ المُنَجِّمُ وَالطَبيبُ كِلاهُما لا تُحشَرُ الأَجسادُ قُلتُ إِلَيكُما
إِن صَحَّ قَولُكُما فَلَستُ بِخاسِرٍ أَو صَحَّ قَولي فَالخُسارُ عَلَيكُما
طَهَّرتُ ثَوبي لِلصَلاةِ وَقَبلَهُ طُهرٌ فَأَينَ الطُهرُ مِن جَسَدَيكُما
وَذَكَرتُ رَبّي في الضَمائِرِ مُؤنِساً خَلَدي بِذاكَ فَأَوحِشا خَلَدَيكُما
وَبَكرتُ في البَردَينِ أَبغي رَحمَةً مِنهُ وَلا تُرَعانِ في بُردَيكُما
إِن لَم تَعُد بِيَدي مَنافِعُ بِالَّذي آتي فَهَل مِن عائِدٍ بِيَدَيكُما
وعلى ذكر الطبيب والطب هنا كموضوع مادي في مقابلته مع الوظيفة الدينية وطب الأرواح يقول أبو حامد الغزالي في “الاقتصاد“عند المقارنة:” لو خلا البلد عن الطبيب والفقيه كان التشاغل بالفقه أهم؛ لأنه يشترك في الحاجة إليه الجماهير والدهماء. فأما الطب فلا يحتاج إليه الأصحاء، والمرضى أقل عددًا بالإضافة إليهم. ثم المريض لا يستغني عن الفقه كما لا يستغني عن الطب وحاجته إلى الطب لحياته الفانية وإلى الفقه لحياته الباقية وشتان بين الحالتين. فإذا نسبت ثمرة الطب إلى ثمرة الفقه علمت ما بين الثمرتين”.
وهذا هو المنطق السليم والأخذ بالأحوط النفسي الغريزي في التعامل مع الدين والمصير، وفي زمن الجائحات والمصائب التي لا تخبر بوقت حدوثها أو انسحابها.و قد لا أجد في هذه اللحظة لمعالجة هذا التصبْيُن في زمن “كورونا المربية للبشرية بامتياز” أجمل من برهان “اللطمة” كحدث موقظ للنوم ومنبه للغافلين فيما يحكي المفكر الأشعري الكبير فخر الدين الرازي:” : فقد كان بعض العقلاء يقول: إن لطمة واحدة تضرب على وجه صبي تظهر أن لهذا العالم إلها. وأن هذا الإله أمر بعض عباده بأشياء ونهاهم عن أشياء، وأن ذلك الإله أعد للمطيعين ثوابا وللمذنبين عقابا، وأنه بعث إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين، وهذه هي الأربعة التي هي أشرف المطالب وأعز المقاصد.
أما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الأول وهو إثبات الإله تعالى فنقول: ذلك الصبي إذا أحس بتلك اللطمة في الحال يصيح ويقول من الذي ضربني ومن الذي لطم وجهي؟ ولو أن أهل الدنيا يجتمعون عليه ويقولون إن هذه اللطمة حصلت بنفسها من غير فاعل فإنه لا يقبل هذا القول ولا يؤثر فيه هذا الكلام، وهذا يدل على أن صريح العقل يستبعد حدوث تلك اللطمة من غير فاعل. فحدوث جملة الحوادث في عالم الأفلاك وعالم العناصر كيف يعقل حدوثها بلا محدث وفاعل؟ فصار هذا الاعتبار من أدل الدلائل على دلالة حدوث هذا العالم، وعلى وجود الصانع المدبر، وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الثاني وهو كون الإله تعالى موصوفا بالأمر والنهي والتكليف. فنقول: إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الذي لطمه هو فلان فإنه في الحال يقول لم ضربتني وبأي سبب آذيتني؟ وهذا يدل على أن صريح عقله حكم بأن الخلق ما تركوا مهملين معطلين، بل التكاليف عليهم لازمة والمطالبات عليهم متوجهة، ولما حكم صريح عقل ذلك الصبي بأن تلك اللطمة الواحدة لا يجوز خلوها عن التكاليف والأمر والنهي، فأفعال كل الخلائق مع كثرة ما فيها من المصالح والمفاسد أولى بأن لا يجوز خلوها من التكاليف. وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الثالث وهو حصول ذات الثواب والعقاب فنقول: إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الإنسان لطمه بغير سبب فإنه يطلب منه القصاص فإن عجز عن استيفائه استغاث بمن يعينه على تحصيل ذلك المطلوب، وهذا يدل على أن صريح عقله حكم بأن هذه اللطمة لا يمكن إخلاؤها عن الجزاء أو القصاص. فكيف يمكن إخلاء أفعال كل الخلق عن القصاص؟ وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الرابع وهو بعثة الأنبياء عليهم السلام فهو أن الصبي إذا قرر أنه لا بد من القصاص فعند ذلك يطلب إنسانا يبين له ذلك القصاص بحيث يكون خاليا عن الزيادة والنقصان. وهذا يدل على أنه تقرر في عقله أنه لا بد في الخلق من إنسان يبين لهم مقادير المرغبات ومقادير الزواجر وذلك الإنسان ليس إلا الرسول، فظهر بهذا البيان أن هذه اللطمة الواحدة كافية في إثبات هذه المطالب الأربعة الشريفة العالية”[1].
ومن أعظم ما دل عليه التشريع الإسلامي وما نص عليه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله:” مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا”. بحيث جمع بين سعادة الدنيا وقيمتها و بين الشعور بنعمة القرار وكمال المتعة في المكوث بالبيت الذي هو دنيا مختصرة ومصغرة وجامعة للهمم والأسرة ووحدتها…وهذا ما جاءت به كورونا العنيدة وحققته وفرضته بالقوة على الإنسان المعاند والمماري والمجادل في الحق لعله يؤوب ويتوب ويراجع فكره وسلوكه وغروره وطيشه.يقول الله تعالى:” وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ”.والله الهادي إلى الحق والرشاد.

الدكتور محمد بنيعيش
شعبة الدراسات الإسلامية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة المغرب
[1] فخر الرازي: المطالب العالية من العلم الإلهي. ج 1 ص 274.