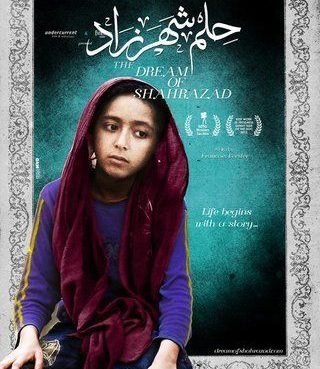ونحن نتخبط في مستنقع “كورونا” الرهيب ،ولا نرى منها إلا كائنا مجهريا ومسماريا يهدد الصحيح قبل السقيم، نجد أنفسنا محتارين ومستائين من أحوالنا النفسية والاجتماعية والروحية والمعرفية ،التي قد تكون أسوأ ضررا من هذا الفيروس الطارئ بسبب تهور البشر بالقصد أو بالتبذير وسوء التدبير.فكان لابد من مواكبة هذا البلاء الوباء بشيء من الجدية والعمق في الرؤية المعرفية، وبتوسيع قطر المجهر لاستكشاف الحقيقة الغالية والحكمة العالية وراء كل ما يحصل ،ولكن بنسبة نورانية هائلة الإشعاع تتجاوز حدود النيترون والإلكترون وترتقي نحو الآفاق وآفاق الآفاق :” وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ” .
أولا:التخصص العلمي الدقيق شرط أساسي للكشف المرضي
وحينما نستعرض أقوال كل من الغزالي وابن تيمية فليس كخصمين ذاتيين أو رجعية فكرية وانكفاء نحو الماضي المنتهي صلاحيته والخارج عن مقتضيات الواقع ،ولكن كنموذجين مستعارين باعتبار انقسام الفكر الإنساني عموما إلى شطرين لا غير وهما:إما متناقضين أو متعاكسين أو متقاطعين و متداخلين، كصحيح مع فاسد وصادق مع كاذب وعميق مع سطحي وحق ضد باطل وعلمي مع وهمي، أو كمشترك في حكم الاحتمال والظن الراجح وغير الراجح.
وحينما نستضيفهما في حقل المدرسة الصوفية الاستشفائية، باعتبارها ميدانا معرفيا وسلوكيا وروحيا إنسانيا بامتياز ،نجدهما يركزان دائما من حيث المبدأ على العلم والعمل ، ولكن مع ذلك فقد يبدو الفرق واضحا منذ الوهلة الأولى في إبراز امتيازات المنهج الصوفي وتخصيصه في العيادة الغزالية المخبرية ،كنموذج العيادات الصوفية دقيقة التخصص، وعلى العكس من ذلك في الحكم عليها ومساواتها وتعميم تناولها ومقارنتها بغيرها في العيادة التيمية التقليدية والمقلدة للمصطلحات الصوفية والموظفة لها بوجه أو بآخر.
لكنهما ومع هذا التفاوت فقد يلتقيان في الإقرار بمشروعية منهج الصوفية عامة، رغم ما لابن تيمية من انتقادات فردية ضد بعض رجال الصوفية المرموقين، والتي لم يعممها وإنما قد تعتبر استثنائية لأسباب لا يتسع المجال للخوض فيها الآن .
1) فالغزالي يقول تعريفا : “التصوف أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة فالعلم يكشف عن المراد والعمل يعين على الطلب والموهبة تبلغ غاية الأمل” .
وهذا العلم قد يتدرج في باب الاستكشاف إلى ثلاثة مستويات وهي :علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين،وهو بهذا يكاد يتوافق مع تطور العلوم المادية للكشف الدقيق من النظر المجرد إلى المجهر العادي ثم المجهر الإلكتروني الموظف للأشعة الدقيقة والمافوق بنفسجية وغيرها.أي معاينة الجزيء بشكل شامل ومكبر إلى درجات لا تقبل الشك أو التردد في الحكم.
2) ويقول ابن تيمية في نفس السياق ولكن بفارق :”فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة وإلا كان ضالا عن الطريق وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه ” .”ثم إنه -أي التصوف- بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم ” وأعلاهم مرتبة هم صوفية الحقائق،وإن كان صوفية الأرزاق والرسم يدخلون ضمن أهل الحق في نظره.
فهذان التعريفان قد يطرحان علينا سؤالا ملحا وهو:هل سلك الرجلان المنهج الصوفي عمليا ومخبريا كما أقراه نظريا أم أنهما اكتفيا بالنظر دون العمل ،وهل أن أحدهما كان سلوكه له نظريا وعمليا والآخر نظريا فقط حتى تكون سلفيتهما موضوعية أم أنها مجرد دعاوى ذاتية وأحكام بغير علم؟.
ثانيا:العيادة الصوفية بين التحليل المخبري والإخباري
1) بالنسبة إلى الغزالي فالمشهور عن موقفه من التصوف أنه امتاز بحركية علمية وعملية تميزت بالتطبيق الحرفي لبنود المنهج الصوفي،إذ أنه قام بتجربة شخصية وخلوة أو حجر صحي صارم دام مدة طويلة ،يذكر أنه قد شاهد فيها مالا يحصى من الكرامات والواردات المعرفية وأنه قد حصل له من اليقين والارتقاء الروحي مالا يستطيع وصفه ،كما أنه راجع وشاور طبيبا نائبا عن مختص عبر عنه بالمتبوع المقدم ذكره في “ميزان العمل”.
ومن هنا فقد كان موقفه من التصوف شعوريا مخبريا ومدرسيا قريبا من النازلة عبر عن أداته المعرفية بالذوق القلبي الكشفي ،بحيث سيعتبره كأسمى أدوات المعرفة عند الإنسان وأنه متخطي للمدارك العادية،وليس للعقل فيه رأي إلا من باب التوقف أو الوصف الشكلي لأحواله ،كما لا يمكن أن يستغل إلا بشروط ينبغي للسالك أن يلتزم بها، وهي:
“التجرد من علائق الدنيا والإكباب بجملة همته على التفكر في الأمور الإلهية حتى ينكشف له بالإلهام الإلهي جليها،وذلك عند تصفية نفسه عن هذه الكدورات،والوصول إلى ذلك هو السعادة والعمل هو المعين على الوصول إليه ” .
ويقول عن خصوصية المجهر والمسبار المعرفي للكشف عند الصوفية:” “اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفا بصحة الطريق،ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به،فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جدا ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات” .
ويدعم رأيه ومعتقده في صحة طريقة أهل التصوف وخصوصية الآلة المعرفية المجهرية لديهم:
“أما الشواهد فقوله تعالى: ” وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا “،فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام وقال صلى الله عليه وسلم : “من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة،ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار”. وقال الله تعالى: ” وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ” من الإشكالات والشبه ” وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ “،يعلمه علما من غير تعلم ويفطنه من غير تجربة ،وقال الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا “،قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج من الشبهات ” .
وهذه الآلة تقوم بدور الكشف المبكر للفيروسات والرعونات أو الأمراض الخفية القاتلة والمدمرة للقلوب ومسالكها الدموية والروحية ،كالعجب والكبر والغرور والرياء،والكذب والقذف والظلم والعنصرية والسخرية والغيبة والنميمة… ،وأيضا قد تعمل على سد مسالك ومنافذ الشيطان بتقوية المناعة ضده بالذكر والصحبة وملازمة الصمت والمحاسبة والمراقبة والرياضة والمجاهدة…
2) أما عن موقف ابن تيمية العلمي وكذا العملي من التصوف فيبدو أنه قدر يقر بالمعرفة الذوقية بوجه ما كما يقول: “وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : “قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر”وكان عمر يقول : “اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم فإنها تجلى لهم أمور صادقة” ،وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : “اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله” ثم قرأ قوله:”إن في ذلك لآيات للمتوسمين”…” .
فيكون السؤال : هل فعلا عاش ابن تيمية مخبريا هذا المقام أم أنه كان مقلدا فيه ؟ ونفس السؤال يطرح حول علاقته بالتصوف وهو: هل كان صوفيا بالفعل والتزم حجرا صحيا صارما وباختيار واستشارة شيخ طبيب،أم أنه كان مجرد متلق وسارد للمعومات حول هذا الميدان ولم يكن له منه نصيب إلا التصديق فقط بما يقال عن بعض الصوفية!؟.
ثالثا:العيادة الصوفية والتوافق المبدئي على ضرورة الطبيب
1) ظاهريا لم يكن ابن تيمية صوفيا بالمعنى الذي يتميز به الصوفية وذلك أنه لم يرد في ترجمته أن قد بايع شيخا كأستاذ وطبيب مختص في علاج أمراض القلب والنفس ،رغم ما يشاع من أنه كان يلتزم طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يكن له احتراما خاصا و يعترف به صراحة،ورغم أيضا أنه كان يقر بضرورة الشيخ كما يقول :
“وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون،وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان. فكما أن المرء له من يعلمه القرآن ونحوه فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر” .
وكذلك لم يرد عنه أنه كانت له أوراد خاصة علاجية وتدريجية إلا ما هو وارد في الأحاديث النبوية الشريفة صيغة عامة وبدعوى اتباع منهج السلف فيها ،والتي قد يسبقه في تطبيقها الصوفية أنفسهم،بالإضافة إلى هذا لم يؤثر عنه أنه سلك منهج الخلوة وشروطها كما هو عليه حال المنهج الصوفي العملي في بعض إجراءاته اللهم إلا ما تعرض له من سجن انفرادي مات فيه،وذلك بسبب مخالفته لأوامر السلطان وتهييجه للعامة نحو الخروج والمجابهة حيث تم اصطياده من خلال كتابه “العقيدة الواسطية” فأقاموا عليه الحجة.وإن كان يقر بالذوق الصوفي إلا أنه لا يعتبره أداة صادقة في حد ذاتها وذات أسس موضوعية تربطه بالسلفية المعرفية،وإنما هو مجرد ميل نفسي أو انجذاب عاطفي لا أساس له من الصحة إلا بقدر موافقته ظاهر النصوص الشرعية.
بحيث سيجعل الحاسة الذوقية مشتركة وشائعة بين أهل الهدى والضلال ، شبيها بما يفعل بعض مقلدي الطب بغير تجربة فيصفون للناس وصفات ليس لها بالخبرة أية علاقة،كما يقول:”فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه،وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد، فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان صاحبه متبعا لهواه بغير هدى” .
لكننا في مواطن أخرى نرى أن مفهوم الذوق وقصره على هذا الحد من المعرفة قد لا يستقر لديه على هذا الشكل “وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك وقوة الإرادة والحركة وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لها والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لها فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل وبالثانية يحب النافع الملائم له ويبغض الضار المنافي له.والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة النافع الملائم والمحبة له،و معرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة ” .
فهذا القول قد يبدو فيه بعض الغموض بالنسبة إلى النص السابق،إذ أنه إذا كان الذوق يعتبر شعورا وإحساسا ،وهذا مسلم به، فإنه طبعا سيكون إدراكا و به سيميز بين الحق والباطل،لأنه بقدر ما قويت حاسة الذوق الذي مر بنا بقدر ما كان الإدراك سليما. وهذه الفوارق عند اعتبار مدى مصداقية حكم الذوق عند الرجلين ناتجة بالأساس عن التزام المنهج الصوفي موضوعيا وعمليا وعدم التزامه. لهذا فقد كانت أحكام ابن تيمية حول الذوق الصوفي يشوبها بعض الغموض نوعا ما ،ليس المجال الآن للتوسع في دراستها.
2) وعلى الجملة فإنه قد يعترف بالتصوف كمنهج سليم في المعرفة وطب القلوب وذلك من باب النظر فقط،إذ لم يسلك تجربة في هذا الميدان تذكر أو تدون كسيرة ذاتية، ومن ثم نظر إليه من باب الظواهر دون أن يلامس مراحل الصوفية التي يقطعونها في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى،فكان حكمه على أذواقهم التي يتحدثون عنها من باب القياس العقلي والتهيؤات الذاتية حول ميدان لم يكن يمدانه بالتخصيص.
فهذا الحكم على ذوق الصوفية قد يبتعد نسبيا عن منهج السلف الموضوعي الذي يقتضي التثبت والسند المعرفي بوحدة الشهود والشعور كما في قول حنظلة الربيعي فيما خرجه مسلم:”نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين”!كما أنه لم يكن متكافئا والأداة التي يعبرون عنها.
لهذا فحكم العقل واللغة العامة على الذوق أو الشعور ومدى مصداقيته في المعرفة هو من باب المفارقات الجوهرية بين البنية العقلية والبنية الروحية الذوقية ذات الآفاق الواسعة بغير حدود.تماما كمن يحكم على حقيقة الفيروسات والكائنات المجهرية بمجرد رؤى ظنية وتوهمات وإسقاطات، قد تزيد الأمر تعقيدا وتورط العباد والبلاد في مخاطر لا تحمد عقباها إن هي وظفت أو تدوولت بغير رقابة !.
ومن هنا فيكون التساؤل حول: أي العيادتين أولى بالزيارة لكشف فيروسات القلوب وتحديد العلل وأسابابها الخفية والجلية ؟ومن له الحق في الحكم عليها وتقديم الوصفة العلاجية الفعالة، هل أهل العيادة الغزالية أم التيمية؟وللناظر حرية الاختيار والتمييز ،” وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا”.

الدكتور محمد بنيعيش
شعبة الدراسات الإسلامية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة المغرب