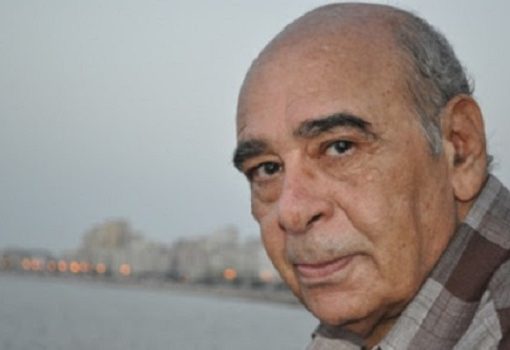صبيحة يوم الأحد من شهر سبتمبر، الذي عقب الحادثة المروعة التي أرعبتنا، كانت بداية أمل يوم جديد بالنسبة لي. استيقظت، جهزت نفسي، وسرحت شعري ثم حملت حقيبتي المدرسية، بعد أن أخذت وجبة فطوري بسرعة كالمعتاد. وبعدئذ ذهبت بخطوات متفائلة إلى مدرستي الجميلة. كنا في القسم ننتظر مدرس مادة التاريخ، الذي أخبرنا المسؤول عنا بأنه لن يأتي اليوم، وذلك بسبب بعض الطرقات المنقطعة من قِبل حرس “الحواجز”!
في الواقع لم نندهش يومها كثيراً من الخبر، لأنها ليست لا بالمرة الأولى ولا بالأخيرة التي نحرم فيها من مُدرّس. ففي الفترة الأخيرة وبسبب هذه الأحداث الجارية في البلد، حرمنا من كثير من المواد، وأصبح لدينا نقص كبير في مستوانا الدّراسي. ولكنني لا أصبّ اللوم عليهم وما ذنبهم يا ترى والحالة هذه ! في نهاية المطاف، إن هؤلاء الأساتذة المعذورين، يحاولون جهدهم أن يحضروا بانتظام، ويقدموا واجبهم المدرسي على أكمل وجه، كما يمليه عليهم ضميرهم، ولكن… ولكن…؟ لا بأس، يجب علينا أن نخضع للأمر الواقع.
بعد إن انتهى الدوام، كنت عائدة إلى المنزل بخطوات بطيئة، وكنت قد قطعت مسافة ليست بالهينة، وإذا بأحد أجهل من يكون، ارتمى علي من الخلف، وقام بدفعي على الأرض قائلاً “لا ترفعي رأسك يا بُنيتي”. لم أكن أعرف ماذا الذي حدث ولا الذي يجري، ولا من يكون هذا الرجل الذي قام بدفعي أرضاً. وللحظة انتهى لمسمعي ذلك الصوت المريب، الذي دوّى دويا هائلا، فتوضح لي حينها بأنها إحدى القذائف التي سقطت في نهاية الحارة.
“يا إلهي !”، كنت مغمضة العينين بشدة، لأني لم أكن أعرف مصدر ذاك الشعور الذي انتابني حينها، نعم لقد كان شعورا مخيفا ومرعبا في الوقت نفسه. لأن حالة الواقع المؤلم، وهو مع كل قذيفة تسقط علينا من السماء، أخسر فيها أحداً من أفراد حيّي.. أو يهدم منزل.. أو تحترق مدرسة. بل وربما، وهذا قد حدث مرارا، قد تسقط إحدى المباني العالية، بكل ثقلها الحديدي والإسمنتي على رؤوس أصحابها.
بعد أن رفعت رأسي من جديد وعاد لي توُازوني، رأيت دخانا متصاعدا من الجهة المقابلة لوجهة نظري، وجمّا غفيرا من الناس، متجهين بلهفة وحيرة إلى مكان سقوط القذيفة. لعلهم قد يصلون في الوقت المناسب، لإنقاذ أحدهم من تحت الركام قبل فوات الأوان. ثم سمعت صوت إنذار سيارة الإسعاف متجهة بدورها أيضاً إلى مكان وقوع الحادث.
كان يجول بداخلي ألف سؤال وسؤال. يا ترى ! أين وقعت هذه الكارثة السوداء؟
لكم كنت أود من أعماق قلبي، أن لا تكون هناك ضحايا وأشلاء ودماء. لكم كنت أود هذا التّمّني من كل قلبي يا إلاهي ! كان فضولي يدفعني إلى الأمام، بينما خوفي يدفع بي إلى الخلف. ولكن، يجب علي أن أعرف ماذا ولماذا وإلى متى وكيف وأين؟
بعد بضع دقائق حسبتها العمر كله، حزمت أمري وقررت أن أعود لبيتي. لم أكن أفكر بشيء سوى معرفة ما الذي جرى وكذلك معرفة بقية تفاصيل الحادث.
كان بداخلي دافع جنوني لم أعهده فيّ من قبل. بدأت بعيوني الممتلئة حيرة ودهشة، بمتابعة الدخان المتصاعد من مكان الحادثة، ولكني لاحظت، أني أتبع الخطوات نفسها التي كنت قد قطعتها قبل قليل عند عودتي من المدرسة. بدأ الخوف بالصعود في مُعَرّجًا، كلما اقتربت أكثر فأكثر من مكان الانفجار. وكلي رجاء أنه ليس ما أفكر به، وانتهت لمسامعي كلمات أحدهم وهو يقول “رابعة العدوية..”.. لا ولا .. ولا.. ! إنه اسم مدرستي الثانوية. بدأت الأفكار السوداء تستول علي وتلسعني. هل يعقل هذا؟ وبأي حق؟ إنها مدرستي كآخر ما تبقى لي في هذه الدنيا .. ألم يتبقّى لكم سوى ذلك المكان الطاهر؟ سوى بوابة مستقبلي والطريق الوحيد لتحقيق أحلامي؟ ألم يتبقى لكم سوى ذلك المكان اليتيم الذي كان يجمعني وصديقاتي؟
لم أستطع تصديق الحادث. حاولت الإقتراب من المكان أكثر فأكثر، حتى أتأكد من حقيقة ما قد سمعته، ولكن أحدهم قام بإرجاعي خوفاً علي من وقوع قذيفة أخرى.
ولكني كنت مصرة على معرفة حقيقة ما جرى. لا أريد أن أعود، بل أريد أن أعرف أولا، أين سقطت القذيفة وما علاقة “رابعة العدوية” بالحادثة. كان بداخلي الكثير والكثير من التساؤلات، وللأسف الشديد، لم يكن هناك أي جواب شافٍ يوضح لي حقيقة ما يحدث.
بقلم بتول الموسى 20-12-2019 بروكسيل – بلجيكا
( من روايتي السير ذاتية قيد الإنجاز ” لطالما سألت نفسي مراراً أين أنا؟)