عمد الروائي حسن أوريد إلى تحديد جنس عمله الأدبي الموسوم بـ”رواء مكة”،متوسلا بعنوان فرعي أثبته على الغلاف،يدرج العمل ضمن خانة السيرة الروائية،راميا بذلك إبرام ميثاق سردي بينه وبين المتلقي يؤطر حدود تلقيه،ويرسم له المسالك التي يمكن على ضوئها قراءة العمل وتأويله،بيد أن هذا التعيين الجنسي يدفع القارئ إلى تلقي العمل تلقيا مزدوجا،يتشابك فيه المرجعي بالتخييلي،وتلتبس خلاله الحدود الفاصلة بينهما،بالنظر إلى ٱنتماء السيرة إلى المرجع والتاريخ،وما يقتضيانه من نزوع إلى الصدق والحياد والواقعية وقول الحقيقة،بينما تجنح أشرعة الرواية وتميل إلى عالم الخيال،مانحة للمخيلة تراخيصها كي تلعب لعبتها الفنية،أملا في خلق عالم روائي متواشج ينحو نحو الاستيهام والاستقلال عن سلطة قوة المرجع.وأمام هذا “الغموض الأجناسي” يجد القارئ نفسه ، وهو على عتبة هذا العمل، يقف موقف ظن وحدس وٱرتياب إزاء ما سيروى له،لا موقف وثوق ويقين،وهو مما يزيد من شدة الإغراء والفضول لديه،فيقبل على قراءة النص قصد الكشف عن قضاياه وعوالمه وملابساته.
رتب حسن أوريد محكيه على سبعة فصول تحمل عناوين فرعية،مشكلة بذلك مجموعة من النوافذ والشرف التي يطل عبرها المتلقي على مشاهد وأحداث وفضاءات مختلفة. يحكي الكاتب عن بعض تجاربه الذاتية وجزءا من حياته الشخصية،مركزا على تجربة حجته الأولى التي غيرت مساره الفكري والروحي معا،مستدعيا ذاكرته القريبة والبعيدة،مشيرا إلى بعض الكتب التي درسها والمؤلفات التي تأثر بها،مستحضرا بعض الشخصيات العلمية التي ٱحتك بها أو تعرف عليها،متطرقا في الآن ذاته إلى بعض مظاهر حياته الروحية، قاصدا هذا الحكي حتى يتبين للمسرود له المسالك التي قطعها،والأشواط الفكرية الحاسمة التي مر بها،بغية ٱستخلاص الحق والاهتداء إلى السكينة والراحة والطمأنينة النفسية.
تبدأ نظرة الكاتب إلى الحياة بالتغير عند أول رحلة له لأداء فريضة الحج،مقدما عليها مضطرا وفاء لنذر نذره في حالة ضعف،وهو الذي كان يرفض في السابق هذا الحج،ويتندر بشؤونه،ويرى فيه “رسيس تربية ومخلفات ثقافة”(ص13) فحسب.لقد تبين للكاتب وهو يؤدي هذه الشعيرة،متذوقا لذتها الروحية الصافية،مستحضرا شقاء ذاته التي كانت تتخبط في متاهات اللذة المادية،وفرط العقلانية المحرضة على التحرر من قيود الدين وأغلاله،أن العقل الذي كان يؤمن به ويقدسه أداة غير كافية لتحقيق السعادة والمعرفة الحقة،وأن التجربة الروحية النورانية القائمة على تزكية النفس،وتهذيب الأخلاق،وتصفية القلب،هي وحدها القادرة على رد ما تشذر من شتات الذات،وعلى تخليصها من تعب الشك،ووطأة التشويش،ونصب الأوهام والخيالات الكاذبة.
إن محكي أوريد في “رواء مكة” دعوة إلى إعادة التفكير والتأمل في علاقة الإنسان بهذا الوجود، ومساءلة قدرات العقل على الإحاطة بجميع المطالب وتخطي كل المعضلات، فـ”هل يمكن أن تصرف الحياة بالعقل وحده؟”-يتساءل الكاتب-“هل حياة الإنسان مقاولة تخضع لمنطق الربح والخسارة، والحساب الدقيق(…)؟”(ص17).
إن بلوغ المعرفة اليقينية والكشف عن خبايا الوجود وأسراره،وتحقيق السكينة والطمأنينة النفسية،كلها غايات “تبدأ بإشراقة الإيمان،وعلى هديه يسير العقل، وتنتسج حياة المرء كلها من نور الإيمان ورفقة العقل.سدى ولحام.مسار يكون العقل فيها صاحبا لا سيدا فلا يشتط في الأمر أو يجور عن القصد.. ذلك الإشراق أو ذاك النور هو الذي يملأ حياة المرء فيزيح الغشاوات ويبدد الظلمات..”(ص47-48).
فالمحكي إذن صوت يدعو إلى تعديل السلوك وتقويم الأفعال،ويحض على ضرورة تعميق الإدراك وتوسيعه،مع وجوب تطهير النفس من شوائب الملذات، وتقويتها أمام المزالق والأخطار التي تحيط بها من كل جانب.
ولعل الراصد لأطوار هذا المحكي والمتتبع لمجرياته،يجد أن ناظمه الذاتي كان معرضا فيه عن اللجوء إلى التخييل الذي من قبيل العجيب والمستحيل،قليل التوسل بذاك الذي يحدث قطيعة مع الواقع والمرجع،أو يباعد بين عالمهما وعالم النص،اتقاء شك المتلقي في موضوعية هذا المحكي وٱرتيابه في حقيقة ومصداقية ما يروى،لكنه كان في المقابل لا يتوانى في تقديم إشارات وقرائن قوية تحفز على تلقي مسروده بٱعتباره كلاما صحيحا،صادرا عن ذات واعية عاشت أحداثا وخبرات ومواقف حصلت فعلا،فاتحة حوارا صريحا وٱعترافيا،ملتزمة بقول الصدق،متحرية الأمانة ما ٱستطاعت،غير مقصرة في تقصي الحقيقة أو التصريح بها،وذلك بدءا من إثبات لفظة “سيرة” على غلاف المؤلف وما يوحي به هذا الجنس من صلة بالعالم المرجعي ووفاء للتاريخ،مرورا بالتطابق التام والصريح بين أعوان السرد الثلاثة: الراوي الذي يرتبط به ضمير المتكلم،والشخصية موضوع السرد،والكاتب منتج النص ومؤلفه،وصولا إلى التدقيق في التواريخ وأسماء الأعلام والشخصيات والأمكنة،وهو الأمر الذي قد يجعل القارئ يجد في نفسه ميلا إلى ٱعتبار الاستعانة بالتخييل في هذه السيرة لم يكن إلا من أجل ترميم صياغة التجربة المستعادة وسد ثغرات الذاكرة وتصدعاتها، فالكاتب عن الماضي الشخصي عندما يعود من الزمن الحاضر،زمن الكتابة،إلى الزمن الماضي الذي شهد الوقائع والأحداث المزمع سردها، يتعذر عليه ٱسترجاع هذا الماضي بكل تفاصيله وجزئياته،ويشق عليه أمر إعادة بنائه وتركيبه بشكل محكم،فالنسيان ونقائص الذاكرة وترنح الأنا ما بين أنا راغبة وأخرى مراقبة، كلها عوائق تحول دون السيطرة على استعادة الماضي سيطرة تامة، وتحد من أمر الالتزام بشرط تحقيق الصدق “المجرد” الذي وضعه المهتمون بشعرية خطاب كتابة الذات.
ويزداد هذا الميل رسوخا عند الوقوف على بعض الشواهد التي تداخلت فيها الذاكرة بالخيال وٱندغما معا، كي ينسجا جنبا إلى جنب صورا حية ومشاهد معبرة تنقل بعض ما ٱنطوت عليه تجربة الكاتب الذاتية المستعادة في هذا المحكي ،مثل ما يوضح الشاهد التالي:
“ثم توجهت إلى السيارة،وما إن هممت بفتح الباب حتى نازعنيه وأراد أن يجالسني في المقعد الخلفي للسيارة. فصحت في وجهه:
– اغرب عني،لم لا تكف عن تعقبي…
– أنا ملازمك حيث رحلت.لن تفلت من قبضتي.
– ما أتيت إلى هنا إلا لأنأى عن ضربائك ، لقد كنت أعتقد أني خلفتهم ورائي ظهريا.
– أنت واهم.
– من أنت؟صرخت في وجهه.
– أنا أنت،أنا عقلك.
وعدت أدراجي والسائق يقودني إلى الفندق وأنا لا أنبس ببنت شفة.ولم ألتق الفتى بعدها(…)كنت في شغل عنه وكان هو في شغل عني” (ص137-138) .
لقد بدا واضحا في هذا المقطع السردي أن المؤلف أقام جسرا بين ذاكرته ومخيلته،يساعد على عبور بعض نوازعه وغوالبه التي ظلت ساكنة في أعماق نفسه، محاولا إحياءها بالكتابة من جديد،فقد أنشأ شخصية توهم بأنها من الواقع،تحاوره وتنازعه وتنتظم في منطق مطابق للعالم الممكن قصد المزيد من البوح والاعتراف، ورغبة في إضاءة جملة من الأفكار والأهواء والهواجس التي ٱستعصت على النسيان، وظلت راسخة في الذاكرة أو محفورة في الوجدان، سعى إلى كشفها والتصريح بها أملا في الخلوص إلى تمثل جيد للذات، وتطلعا إلى خروج القارئ بمعنى ما إزاء ما أفضى به الحديث عن التجربة المطروقة.
ومثله مقطع سردي من فصل “همزات” يحمل صورة تعكس بعض النداءات المنبعثة من نفس الكاتب، بعد أن عقد العزم على التخلص من مظاهر حياته السالفة، وقطع حبال الوصل بينه وبينها،فقد ٱستعان بشخصية تخييلية تترصده وتحدّثه وتتفنن في ٱستعمال مختلف أساليب الحجاج، كي تثنيه عن عزمه، وتصرف نظره عن قراره، معبرا عن ذلك قائلا:”هل غلبتُ ذلك الوحش الضاري الذي ترصدني بمنى؟ لقد انهزم ولم يدحر.لم يعد يداهمني كما فعل بمنى،ولم يعد يستعمل القوة وإنما يجنح إلى الحيلة والكلمة الرقيقة(…)
– هيا، ولم لا تنال حظك من متاع الدنيا ومتعها؟وما العيب في ذلك؟..لقد أقلعت عن شرب الخمر،ولا أفهم لمَ في حقيقة الأمر،وكانت لديك حصيلة من النبيذ المعتق(…)وأنا لا أفهم هذا العناد الذي يملؤك حتى ليفسد عليك أمرك،وهل تعيش بالكتب وحدها،وبالقراءة وحدها.وعما قريب ستنضب ذخيرتك،فما أنت صانع،ولك أولاد؟(…)لقد زعمت أنك هدمت الأصنام من فؤادك.حسنا.وهذا لا يمنع أن تتعامل معها.سم ذلك ما شئت،تكتيكا،أو تقية،لابد من شيء يعين على الدهر(…)
كان هذا الزائر يترفق في القول،وكان أحيانا يصطحب بعضا من معارفي وأقربائي(…)
كنت أسمع له أحيانا.كنت في حرب ضروس.حرب ٱستنزاف”(ص 147-149)
لقد ٱطلع التخييل في هذا المقطع السردي بمهمة إعادة تشكيل الانفعالات والهواجس المستبطنة، ومحاولة رسم صورة مقربة للتجاذبات والمواجهات الحامية التي كانت تعتمل في أغوار نفس الكاتب،وهو بصدد لَأم هويته الذاتية ، ولمّ شتات ما تفرق منها بين غوايات الماضي الممتد في الحاضر،ومشاق ٱستشرافه للآتي من المستقبل.
ولعل طبيعة التخييل المتوسل به في هذين المقطعين أو في غيرهما من المواضع الأخرى من الكتاب، يحفز على الذهاب إلى القول ؛ إن التخييل في “رواء مكة” تخييل شفيف،يجلي ولا يخفي،يدني ولا يبعد،يسد الثغرات، يبعث على التجدد، ويعين على الوفاء للذاكرة،أملا في الاقتراب أكثر من جوهر حقيقة الذات المسرودة ،كما أنه تخييل يجعل القارئ يتفاعل مع المحكي وهو يشعر بأنه إزاء نص واسع الآفاق،على قدر كبير من الخصوبة والتركيب،زاخر بحيل الكتابة وألاعيبها الفنية،يرتقي بذوقه ومداركه،ويحقق الرهان الذي على ضوئه تخير هذا العمل وٱنجذب إلى قراءته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامش:
1-العمل للكاتب المغربي حسن أوريد،منشورات المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،المغرب ،الطبعة الأولى،2019 .والإحالة إلى صفحات الرواية تتم داخل متن القراءة.
رشيد إتوهلاتي




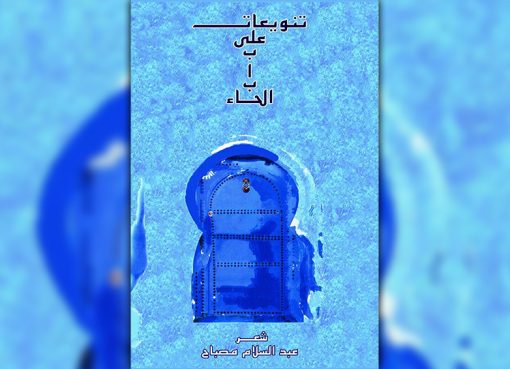
لم الروائي حسن أوريد، ما يمكن تسميته بأدوات الروي مجازا، أو شخوصه الأدبية الحاضرة، وهم إبداعيا، في إطار حكي جذري ملازم للرواية دوما، كالتالي:( المؤلف- والكاتب- والسارد)..ففي أي منهم يتموقع الراوي حسن أوريد، باعتباره الشخص المتوثر والمتأثر انفعاليا…؟ الحقيقة أنه هو السابق انطلاقا من الماضي أو الذاكرة نحو هؤلاء الشخوص الثلاثة أو الأدوات..وقد صبغهم بروحه التي اهتدت إلى ما اهتدي إليه..فكان الصدق، وهو اعتراف حاضر في زمن انفعاله، تفجر من الذاكرة ليعبر عنه إبداعيا بمغازلة تجربته العمرية…وهكذا تنتهي في الغالب كل رحلة سندباذية لكل إنسان يرنو إلى لملمة محصلاته..ويمكن أن نقول أنه هو المؤلف الناظم لكتابته وسرده بصدق متحدي..إنها رواية أسستها الذاكرة بامتياز..