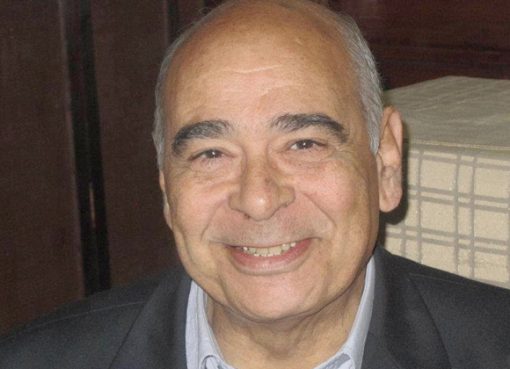في ظل الغياب والطمس الذي يحيط بالشعر ومسيرته، كأن يأتي الاحتفاء الرمزي به في يومه العالمي باردا؛ لأن لا أحزاب له، ولا سلط، ماعدا أرضه الخصبة التي تقتضي وضوءا شعريا لعبورها. إقرار هذا اليوم عالميا للاحتفال، شيء جميل، لكنه بقي عتبة لمسكن ظل غريبا دون امتداده في الإنسان والحياة. وهو الشيء الذي يدفع إلى الحلم مرة أخرى أو اللجوء للشعر.
أتوقع في اليوم العالمي للشعر، أن تفتح كل أسرة كتاب الشعر، وتذكر الموتى منهم بخير، وتحيي الباقين بروح عالية باعتبارهم أداة أو وسيطا نمسك به للغوص. وفي مقابل ذلك، على امتداد العين سيطرح الأهالي جدوى الشعر اليوم، ولما لا يألفونه ويألفهم، ولو في الدهشة التي لن تتحول إلى روتين. طبعا الشعر لا يؤكل من الكتف ولا يوضع إلى جنب الأشياء الثقيلة والثمينة؛ لأنه خفيف في الميزان ومتخفف من متاع الزبد كما الرعشات التي بإمكانهم أن تكرك أمة انطلاقا من نقطة في عمق.
أتوقع أن تخصص المؤسسات التربوية يوما خاصا للشعر وبه، ليس لقراءته
فقط؛ بل للتداول حول شؤونه، وأسئلته قصد تحبيبه للناشئة. وعليه يمكن أن نتنفسه في يوم آخر، يمكن أن يدفعنا للبحث عنه في الزمن وحواشي الحياة. آنذاك قد يتحول إلى أداة لتجديد اللغة والحياة، قصد شحذ الداخل ومواصلة المسير بحيوية وقوة التحدي.
أتوقع أن تخصص الجمعيات الثقافية في شأنه مناظرات وترفع توصيات، وتسعى إلى تفعيل ما ينبغي تفعيله من قبيل التربية على الشعر التي تقتضي الإنصات وامتلاك ولو حد أدنى من الثقافة الشعرية. في هذه الحالة، يمكن تقوية الصلات بالحياة وبالجسد. ولست أدري إلى ما يبقى التواصل معطلا بين الإطارات الثقافية، كأن لكل، ثقافته وشعيره، عفوا شعره؟
أتوقع التنسيق بين جمعيات المجتمع المدني بكافة التخصصات؛ لتمرير هذا الشعر في حلل مختلفة، لأنه ليس حكرا على إطار دون آخر؛ ولأن الشأن الإنساني يقتضي بناء شموليا. أكيد أن الشعر يطوي على معرفة متعددة بالواقع، بالتاريخ، بالفكر…لكنه لا يقول ذلك بكيفية تقريرية، بل يعجن المعرفة لتسري في رؤيا الشاعر للعالم وللحياة. طبعا لا يتحقق ذلك إلا في النصوص العميقة التي تدرك نفسها وما حولها في تجاذب خلاق.
أتوقع من الإعلام بأشكاله المختلفة أن يتجاوز ثقافة الإعلان؛ ويخصص بعضا منه للقول الشعري قصيدة ونظرا من مقالات وتصريحات وملفات؛ لنبدو مسؤولين أمام الشعر، لأنه وحده داخلنا، سيحاسبنا على ذلك إلى آخر ذرة في الحياة. طبعا يطرح هنا سؤال الإعلام الثقافي بإلحاح، وكذا مساحة الثقافي بالإعلام المتعدد. يبدو أن الغياب وتقليص المساحة الخاضع للمد والجزر هي الصفات الغالبة اليوم والتي تنعكس بمعنى ما على التلقي الشعري في الإيصال، والنشر، وكذا النقد.
أتوقع من الدولة أن تتصالح ولو لمرة واحدة في السنة مع الشعر، وتعلن قليلا نزوله للشارع والإنصات لصوته دون منصات أو علو متخشب. طبعا لا يمكن لدولة أن تنهض على الشعر وحده؛ لأن هذا الأخير اختار الامتداد والوجود، اختار تكسير المسطرة بكامل القيم المغايرة التي تقتضي تجددا يوميا. ولكن حين يتم الالتفات للشعر يعني الإستقواء من قيم المحبة كخلفية فكرية وليست إثيوبيات فقط أو «بوس الحناك» في خداع وحربائيات مكشوفة.
أتوقع الكثير، وتحت السقف العالي، ولا يمكن أن يليق ذلك إلا بالشعر وفيه. فشكرا له على هذا الفيض الذي لا راد له. قادر هذا الشعر، أن يخلص الشعراء من الأذران وجوعهم الغامض كلما اقتربوا من سلطة أو قرار. نعم القصيدة والكتابة تجربة فردية، ولكن ذلك لا يحول دون صداقات خاضعة للقيم النبيلة، وليس للمقايضة والتعضيد واللف والاغتيال الضاحك… الصداقات التي بإمكانها أن تخوض المسافات الطويلة تحت سقف الكتابة العالي …
عبد الغني فوزي: توقعات في أفقه …