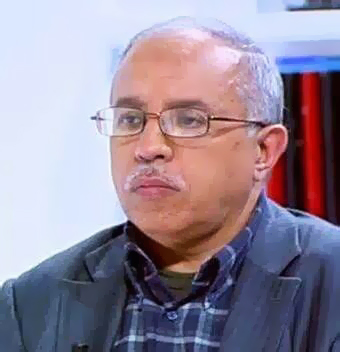لقد أشرنا في الحلقات السابقة إلى أن القياس الأصولي ينقسم، باعتبار علته، إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. وقد ردت كلها في القرآن الكريم. ونواصل حديثنا عن قياس الدلالة. ونريد، في البدء أن نقدم بعض التعريفات لهذا النمط من القياس. منها التعريف الذي قدمه القاضي أبوبكر الباقلاني لقياس الدلالة يقول فيه: (هو الجمع بين الفرع و الاصل بما لا يناسب الحكم ولكن يستلزم ما يناسب الحكم).
وهناك التعريف الذي أورده ابن قدامة، وهو: (أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا).(كتاب روضة المناظر).
وهناك تعريف لإمام الحرمين، يقول فيه: (هو الذي يشتمل على ما لا يناسب نفسه، ولكنه يدل على معنى جامع).(كتاب البرهان).
ويعرف الزركشي قياس الدلالة بقوله: (هو أن يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلة، أو أثرا من آثارها أو حكما من أحكامها). (البحر المحيط).
ونختم هذه التعريفات بالتعريف الذي قدمه ابن عبد الشكور الحنفي، في كتابه (فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت)، يقول فيه: (قياس الدلالة ما لم تذكر فيه العلة صريحا، ودل عليها بلازمها).
هناك تعريفات أخرى لنجم الدين الطوفي و أبي إسحاق الشيرازي و عبد الرحمن الشربيني و غيرهم. وإذا نظرنا في التعريفات السابقة، فإننا نجدها تشير إلى أن قياس الدلالة هو ما لم يصرح فيه بالعلة ولكن ذكر فيه لازم العلة أو حكم من أحكامها أو أثر من آثارها، أو أنه اشتمل على معنى جامع أو صف لازم أو دليل العلة، فالمضمون واحد وإن اختلفت ألفاظهم و مصطلحاتهم.
قد ورد هذا القياس في آيات عديدة من القرآن الكريم، أشرنا إلى البعض في إحدى الحلقات السابقة، وورد كذلك في الحديث النبوي، واستعمله الفقهاء والاصوليون بشكل كبير، ومثاله قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة الدالة على الإسكار، والرائحة هنا هي دليل العلة، وعلامة وجودها، وليست هي العلة، ويلزم من وجود الرائحة وجود الإسكار الذي هو العلة.
ومثل قياس قطع الجماعة بالواحد منهم على قتلهم به والجامع هنا هو وجوب الدية عليهم، أي الجمع بين قطع الجماعة ليد الواحد وقتل الجماعة للواحد في وجوب القصاص على الجميع بموجب الإشتراك في وجوب الدية عليهم. و الفرع هنا هو القطع و الأصل هو القتل، والعلة هي وجوب الدية على كل فرد. والحكم هو وجوب القصاص على الجميع، وقد ظف الله عز وجل قياس الدلالة في آيات عديدة من القرآن الكريم، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلا والنشأة الثانية فرعا عليها، ويعطى للفرع حكم الأصل بموجب القياس. فكيف ينكرون النشأة الثانية ويسلمون بالنشأة الأولى، والأولى هي نشأة من عدم و الثانية ليست نشأة من العدم ونجد هذا في قوله تعالى: (أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر الأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى؟).
وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالعشب و النبات. ونجد هذا في قوله تعالى: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون). ومنه أيضا قوله عز وجل: (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير). إن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على بعث الإنسان وإحيائه بعد موته، فقاس القرآن الكريم إحياء الإنسان بعد مو ته على إحياء الأرض بعد موتها، وهذا قياس أصولي وقياس عقلي، وهو بالضبط قياس الدلالة الذي يجمع فيه بين الأصل و الفرع بلازم العلة أو أثرها أو حكمها.
ونجد هذا القياس أيضا في قوله تعالى: (ويقول الإنسان أ إذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟). وقد اشتمل هذا الكلام الموجز والمختصر، وهذا الحوار على كل عناصر القياس: الأصل والفرع والعلة والحكم. فالإنسان المنكر الجاحد يتساءل مستغربا ومتعجبا هل هناك حياة بعد الموت؟ هل سنبعث من جديد؟ (أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟) فيجيبه القرآن الكريم بالجواب الشافي الكافي، ويقدم إليه الدليل العقلي المنطقي الدامغ، والحجة القاطعة الباهرة، موظفا القياس العقلي، والأصولي، وموظفا هنا قياس الدلالة. إذا كان هناك خلق أول، وهو خلق من عدم، فيلزم أن تقبل بإمكان حدوث خلق ثان، وهو بعث وإحياء، وليس خلقا من عدم. فالقادر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني، أي البعث، وإذا سلمت وقبلت أن الخلق الأول قد وقع وحصل، وجب أن تسلم بإمكان حدوث الخلق الثاني، وهذا يقتضيه العقل و المنطق و القياس.
أبوبكر العزاوي: الإستدلال والحجاج في القرآن الكريم (9)