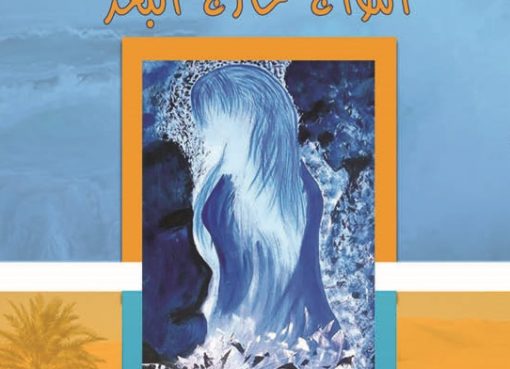وحين استقر بنا المقام بمكتبتنا المفضلة، وقد طابت نفسينا بهذا الاجتماع الثنائي في قلب السكينة الأبدية، باشرتها قائلا:
– أبلغك يا أيتها الفاضلة، بأن حكايتي الأحدية العجيبة لك اليوم، والتي انتقيت عنوانا مثيرا لها “آدميرة وآداميرو”، سأحكيها لك يا حبيبة الروح على لسان البطلة المعنية بالأمر، وأقصد “آدميرة” قائلة:
إنها رواية قصتي أنا آدميرة، بل أُفضِّل أن أدعوها بحكايتي، هذه التي سأرويها لكم، منذ اكتشافي لكهف “أَلْتَميرَة” لغاية النهاية. نعم أفضل هذه التّسميّة التي توحي لي شخصيا بتداخل ما هو واقعي بما هو خرافيّ وسحريّ وخياليّ، مع العلم أنها حصلت لي فعلا من لما كنت طفلة، وأنا الشاهدة والمعنية الوحيدة من لها القدرة والكفاية اللغوية والخيال الساحر وصدق الرؤية المستقبلية لسرد وقائعها العجيبة.
لقد عشت بداية أحداث هذه الحكاية العجيبة والخارقة للعادات الطبيعية ببلدي إسبانيا، في سنة 1876، آنذاك كان متوسطا بين سنيّ الثامنة والتّاسعة. وأذكر أني كنت يومها ماشية بخطى طفولية بطيئة خلف أبي مارسيانيو، حين توقف فجأة على رأس خادمة تنظف حاكة بلاط كنيسة “القدّيسة ماريا” الخارجي، بحجر أبيض مثلت الشكل. سألها أبي بافتعال وهو في حالة استغراب وذهول: “من أين لك سيدتي بهذه القطعة الحجرية المثلثة؟” وأجابته بدون أن تبدي أية دهشة لسؤاله” عثرتُ عليه عند مدخل المغارة..” واستقامت واقفة باهتمام، ثم استدارت كريشة في مهب الريح وأشارت بسبابتها جهة الغرب. ناحية بيتنا الكبير، الذي يقع هو الآخر بهذه الناحية، وطأطأ أبي برأسه شاكرا إياها وجذبني من يدي قائلا:
– ألم تنتبهي لصنف الحجرة التي كانت بيديها؟
– بلى.. أجبته، إنه من نوع حجر الصّوّان، الذي كان يستخدمه الإنسان البدائي منذ آلاف السّنين كما علّمتني.
– تماما، أجاب أبي، وهيا بنا الآن لاكتشاف أمر هذه المغارة أو الكهف الذي حدثنا عنه الخادمة.
أريد الآن، أن أتوقف عن سرد الحكاية مؤقتا إذا تفضلتم يا احبائي، لأطلعكم على شخصية أبي وعلاقتي المتميزة معه. لقد كان أبي يومها في الخمسين من عمره، رجل أسمر البشرة، طويل القامة، عريض الصدر والكتفين، عيون سوداء وجبهة عريضة توحي بذكائه وصفاء سريرته وأناقة ملبس لا تفارقه أبدا. كان ينحدر من أسرة أندلسيّة عربية نبيلة ثرية، تملك عدة ضيع وغابة وأراضي زراعية، بما فيها القطعة الأرضية التي سنكتشف المغارة عليها. وأهم ما ورّثني أبي، تربية علمية دقيقة قائمة على الحدس والمعاينة والتجربة. وبالرغم من صغر سني، فإنه كان يستصحبني معه في كل استطلاعاته الأحافريّة التفقديّة. فأبي كان له تكوين باحث أنثروبولوجي، أي عالم بالأحافير. وكان في كل خرجات مهام أبحاثه يأخذني معه ويطلعني على كل ما يعثر عليه في اكتشافاته، من حجارة وأدوات قديمة كان يسميها لي، ويحدد نسبيا صنفها وتاريخها وعائلتها الجيولوجية الجغرافية وطبيعة استخدامها.
أما أنا من ناحيتي فإني كنت فتاة متوسطة القامة لا بالطويلة ولا بالقصيرة، وجميلة بما فيه الكفاية في عيون نفسي كما كنت أتصور . ولكني قد ورثت عن ذكاء أبي بفضل ربي كل هذا . فعن أبي ورثت سواد عيونه وعن أمي ورثت شقرة سنابل شعرها الذهبي. ولكن الكنز الحقيقي الذي ورثته عن أبوايا بالإضافة لكل ما ذكرت، فضول أبي العلمي الذي لم يكن يؤمن بأن الإنسان وليد تقاليد طقوسية مسيحية تحصرها في بضعة ألاف من السنين، بل إنه كان في نظره أقدم من هذا بكثير، أي بعشرات الآلاف من السنين بل بالملايين. وعن أمي ورثت صفاء الذهن والبصيرة وصبر المرأة العاقلة.
إن أبي كان بالنسبة لي مدرستي الحقيقية، وبفضله كنت كغير الصبايا الذين كانوا في سني. فلم أكن لأومن إلا بما كان ي يفسره لي ويكشف لي عن مصدره بسعة اطلاعه وطريقة إقناعه، التي كانت تقوم على البرهان ومحبة المعرفة لذاتها. أما تعاليم مدرسة الكنيسة التي كنت مجبرة على متابعتها، فلم أكن أعرها أي اهتمام يذكر، فلطالما كانت تبدو لي سطحية وتقليدية وسوداوية اللباس والنوايا السوداوية.
والآن أعود لمتابعة سرد حكايتي. لقد كان أبي يمشي يومها أمامي مدفوعا بحيوية خارقة كعادته المتزنة. ومشينا لثلث ساعة تقريبا خارج المدينة الصغيرة التي نسكنها، باتجاه الهضبة الغربية التي تشرف عليها. وبالفعل كنا نعبر أرضا من ملكيتنا، حين تواجدنا وجها لوجه مع مجموعة من المزارعين يتقدمهم صياد وكلبه، عائدين لبيوتهم. وبعفوية تامة، سألهم أبي عما إذا كانوا يعرفون مغارة تتواجد بهذه الناحية، وكان الصياد “مانولو” أول من أجابه:
– نعم، لقد عثرت على مدخل كهف هنا عند الهضبة التي تقع خلفنا. لقد عثرت عليه، يوم تعقب كلبي أرنبا فرّ مختفيا خلف الشجيرة التي تغطي المدخل.
– هيا بنا، أريني إياه، أشار عليه أبي.
وصرنا من جديد خلف الصياد، الذي تقدمنا وصار بنا لغاية شجيرة تقع عند قاعدة الهضبة. وعندها توقف وأشار بيده:
– هنا.. !
ولم يتمالك أبي نفسه فاندفع نحو الشجيرة المنبطحة أغصانها راكضا، وأزاح بعض أغصانها اللاصقة بالأرض وأنا عالقة به، ليتبين لنا مدخل أقل من فوهة بئر صغيرة. اقتلع أبي بعض الأغصان ونبش التربة عن جانبي الفوهة، وأطل برأسه نحو الداخل المعتم ثم استدار واستوى واقفا، وصار في حديث طويل مع الصياد مانولو، في حين تسللت أنا في غفلة منه، بدافع فضولي من خلفه إلى داخل المغارة. وكان أول شيء قمت به أن نبشت تربتها الداخلية، وإذا بيدي تعثر بقطعة فخار سميكة بسعة يدي، سرعان ما مسحت الغبار عنها بكم كنزتي لتقع عيني بانبهار على صورة ليد بشرية محناة مرسومة عليها. وبانفعال طفلة تحفل بأجمل هدية، دسست القطعة في جيب تنورتي المدرسية وعدت مسرعة للخارج لاجتلاب المصباح، الذي كان لا يفارق حقيبة أبي اليدوية. ومن جديد، عدت نافذة إلى المغارة بحقيبة أبي على كتفي، أخرجت منها المصباح وعود الثقاب، ثم أولعت المصباح الغازي وصرت شاهرة إياه أمام عيوني، وهالة ضوء المصباح تبدد شيئا فشيئا رقع الظلام أمامي، والمغارة تكبر تدريجيّا في عيوني المبهورة حتى صارت كهفا. وكمن يكتشف عالما جديدا، تابعت مغامرتي التفقدية ناظرة أمامي وعن اليمين وعن اليسار، حين تعثرت فجأة بحجرة نابية فوجدت نفسي منبطحة على جانبي الأيسر، والمصباح بعده عالق نحو الأعلى بأصابعي التي تمسك بقوة على عروته النحاسية. وتابعت بعيوني الحائرة، يدي المعلقة في دائرة الهالة، وضوء المصباح المتجه نحو الأعلى الذي صعد نافذا كسهم ناري نحو السقف الواطئ، فكانت الصدمة… صدمة معجزة جمالية طفولية وبريئة مثلي، ما زالت بعدها وإلى يومنا هذا تسري شحنتها الحيوية في روحي وتجري في دمي. وبقيت مشدوهة كطفلة بالغة عاجزة عن الكلام، حين سمعت وقع خطى أبي في اتجاهي، يسبقه صوته الجوهري خائفا “آدميرة.. آدميرة.. هل أنت بخير..” ثم إذا به قد حنى رأسه مائلا عليّ ويده تطبطب علي.. “بخير.. أنت بخير..” وكالعالقة بحبال حلم ساحر، أشرت بيدي نحو السقف:
– مكيل آنج..ج..ج.. لو…! مشاهد سفر التكوين… آدم وحواء، قلت منفعلة.
واستدار أبي وهو بعده منحنٍ بوجهه إلى الأعلى:
– إلاهي… ما هذا…!؟
ولم يكتف أبي بسرقة نظرة خاطفة للسقف المتدلي علينا مثل شاشة سينمائية متحركة، بل استلقى بكليته على ظهره بجانبي، وراح هو الآخر متلاشيا في مسلسل الرسوم المتوجهة بألوانها المتموجة مازجة كل من الأسود فالأحمر القاني الصارخ والأبيض البدائي الدافئ. وبعد قطيعة كلامية دامت ما دامت، إذا بصوته يعود مرتفعا ليملئني كما فراغ الكهف:
– إنها رسوم قد تعود إلى العصر الحجري… إنها…
وحين تطلعت إليه، كانت الدموع تجري بدفء وحرارة على خشونة ذقنه الحليق بلا عناية كباقي العباقرة والمتفلسفة. وكالمجنون المصاب بأرواح المهلوسين الأبرياء الحيارى، خطف المصباح السحري من يدي وراح متنقلا به، وقد زاده أكثر قربا من رسوم السقف التي بدت أكثر وضوحا وتوهجا وتلقائية منا كشاشة سينمائية بانت لنا في منتهى الوضوح والصفاء والجمال السنيمائي. وهذا العالم العجائبي والخرافي الغريب، الذي بدا بفعل الضوء المسلط على سواده القاتم في أسرار المغارة، قد نطق فجأة بمعجز العبارة ليكشف لنا عن لقطات لصور نحتية على الصخور تعود بذاكرتها الوشمية الرسمية لأكثر من أربعين ألف سنة إلى الوراء، من قبل ظهور ومن بعد خروج المخلوق البشري الذكي، من الحلم العقلاني الوهمي إلى حواس ذاكرة العظمة لثيران وحشية سمراء من فصيلة “البيزون”، مرسومة بعبقرية فنية كبيرة، وبدقة عالية على رقعة سقفيّة بلون بنّي صلصالي أمغر باهت، تتخللها خطوط رسمية سوداء وبقع حمراء. باسم الغرابة البدائية، وهو، وأقصد أبي الغالي، ما يزال يردد بصوته الجهوري مالئا كل فراغات المغارة الصامتة… إلاهي…! بحياتي لم أر معجزة أجمل من هذه. وسالت دموعه على وجنتيه، وأنا أيضا لم أكن أقل منه تأثرا، إذ فطنت بدموع الفرح تجري من عيني أنا الأخرى، وبإحساس غريب يسري في جسدي.
ولم نكتفِ بهذه الاكتشاف الفجائي، إذ مشينا كلانا يتقدمني أبي، متفقدين لباقي مجاهل الكهف الأسطوري البدائي العجيب، مكتشفين معا رسوم ورقع أخرى ملونة لحيوانات من جنس الثيران والغزلان وحصان غير مكتمل الشكل، وسبعة وخمسون يد مصورة على هيئة بصمات على الجدران الواطئة. ولقد كان السقف ينحني في بعض التّجويفات الرّكنية مما كان يجبر أبي على الانحناء. أما أنا، فكأن المغارة قد قُدّت على مقاسي، وكانت في انتظاري منذ آلاف السنين حسب تقدير أبي الأولي، والذي اتضح تقديره فيما بعد ب (35.000) ألف سنة من قبل خبراء علم الأحافير.
وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتوافدت الزوار وتقاطرت من كل ركن من المعمورة، على الكهف الذي كان من ملكيتنا الخاصة. وقدم رجال الصحافة والخبراء والرسامون وعلماء الأحياء والأحافير، والهواة والفضولين، حتى أمسى الكهف وكأنه قبلة مزار للقديسين.
ولكن الحدث الحقيقي والخارق، الذي حدث بعد كل هذه الضوضاء البشرية، حدث لي أنا شخصيا حين عدت في اليوم التالي لتفقد كهف “ألتميرا” كما أصبح يُسمّى لدى الجميع، ولكني عدت بمفردي هذه المرة مدفوعة لا بفضولي وبحب اطلاعي، ولكن بالرؤيا التي حصلت لي ليلتها. رؤية أيادي وردية محمصة بلون القهوة بالحليب، كانت تارة تمتد نحوي كمن تسعى إلى مس وجهي، وطورا تدور حولي مثل فراشات تحوم حول نار في ظلمة الكهف.
وتسللت بنفسي الخائفة من الفتحة الدائرية، كشبح غير مرئي متوارية داخل الكهف. ومن جديد جهّزت مصباحي الزيتي، وتوجهت بحذر شديد نحو الجدار المنحني، الممتد من الأعلى نحو الأسفل. وحين صرت أمام واجهة الأيادي البنية المشربة بمسحة بيضاء على حمرة باهتة، استرجعت نفسي ووجهت مصباحي لبصمات رسوم الأيدي المطبوعة هنا وهناك. وتقدمت بخطى وئيدة وبطيئة لغاية ما صرت بمحاذاة الرسوم، فنقلت المصباح من يدي اليمنى إلى يدي اليسرى، ثم وضعت يدي اليمنى على رسم أول يد بدت لي في انتظاري. شعرت بالرطوبة تلمس يدي وقد اختفت اليد المرسومة تحتها وكأنها قالب لها. قالب يد مجهولة على قياس يدي. ومرة أخرى رفعتها خفيفة يدي، ووضعتها من جديد عليها وإذا بقشعريرة غريبة تسري في شرايين جسدي. وبدا لي شعوريا بأن اليد المجهولة قد دبّت فيها الحياة، وبدأت تتحرك تحت ملمس يدي… وإذا بسطح الجدار قد صار أجلى وأصفى كمرآة. وعوضا من أرى نفسي منعكسة في المرآة، رأيتها بكل تفاصيلها صورته. شاب في الخامسة عشر من عمره على ما يبدو، شاب في تمام خلقته البشرية آنذاك. أعني له خلقة آدمية مثلي تماما، غير أنه متستر بفروة “بيزون”، وعلى شفتيه ارتسمت شبه بسمة، شبه كلمة ودعاء طلب رحمة. وعلى وجهه الوضاء تقاسمت وجنتيه بعض الخطوط الحمراء والسوداء: ثلاثة حمراء على الخد الأيمن وثلاثة سوداء على الخد الأيسر. لربما سبب هذه الخطوط المصبغة يرجع إلى تقاليد ومراسيم طقوسية مغرقة في قدم تاريخ البشرية البدائي.
إلاهي…! ونزعت يدي من يده فسقط بشكل تلقائي سواد ليلي حالك واستعمر كلّ المغارة.
وتوالت الأيام، وأنا بتفقدي المعتاد لغرابة اكتشافي، قد كنت في غفلة مطلقة عن أبي الذي لم أطلعه بعد، ولم أكن أرغب فيما بعد، عن سرّ رقصة يدي في اليد الغريبة.
ولكن حدثا لا طبيعيّا ولا سببيّا، قد قدم فجأة فزاد الأمر غرابة. والأمر يتعلق هذه المرة بالحلم الرؤيا، وليس بواقع الكهف وأسرار المغارة. وهذا المسلسل الحلمي الرؤيوي، قد أصابني لأول نظرة مني للوجه الغريب، ثم راح يتوافد عليّ باستمرار، لغاية ما بارك إله المحبة في تآلف روحينا وبوتقتهما في بلّور جوهر روحه الجوهرية.
كنت ماشية على غيوم من فضة، فوق مدينة لا خيالية، حين بدت فجأة، قبتها الذهبية كحبة قمح ذهبية في أرض يبابية قاحلة. ثم انقشعت الغيوم وصفت، وتدلّى سلّم عاجي من خالص مادة الوهم، وإذا به نازل من علياء الثّريّا، صبي مصبّغ الوجنات، مادّا يده نحوي عبر مرآة رمادية. ابتسم لي صدفة، وتفانى ما فيّ فيه لا شعوريا، وتربع الشعور وما فوقه على صفحة البداية.
وكانت الغابة جد قريبة. وكانت عند مشرق الأرض مغارة عجيبة، بها نجوم وأقمار وشموس ذهبية، فمددت يدي وجنيت منها ما جنيت وكأنني ألمس أجساما شفافة لا ملموسة… واستيقظت من حلمي، شبه مسحورة وشبه مهمومة بالوجه الغريب الذي تجلى لي.
وتوالت السنين وأنا محتفظة بسري لنفسي، وتوفي أبي وأنا في الثلاثين من عمري. وخلفته في مهامه الأحفورية وإدارة المتحف المغارة بعناية منقطعة النظير. لقد كنت عانسا في عيون العالم الخارجي. وكانت الشائعات عني تجري على مستويين: امرأة كارهة للرجال حسب ما يقول بعضهم، وامرأة قد تزوجت بالمغارة حسب قول البعض الآخر.
ومن الغريب في الأمر، أن بعضهم كان قريبا من الصواب. لأن المغارة في نظري أو الكهف حسب تسميتهم له، كانت تنطوي على أسراري وعن حياتي السريّة الحقيقية، التي لم يعلم بها أي مخلوق لغاية لحظات توثيق هذه المذكرة الشخصية.
إن لمسات أيادينا على جدار المغارة، وأعنيني أنا وصبي المغارة، قد أصبحت حقيقة بحكم قوة غيبية أجهلها. لقد تحول هذا التماس المتكرر بيننا، إلى علامة من علامات التواصل بيننا، ليصبح مع مرور الأيام ألفة روحية ولقاء واقعي ملموس. وحدث هذا في إحدى المرات حين بَصمتُ يدي على يديه، فتوهج الجدار العازل بيننا بإشعاع نوري مضيئا كل نواحي المغارة، واختفى لحينه لأجد نفسي وجها لوجه مع الفتى المعجزة. تطلع إلي وتطلعت إليه مشيرة إلى نفسي:
-أنا آدميرة” ووجهت سبابتي نحوه وقلتُ واثقة من حدس حواسي “وأنت آدميرو”، وقد انمحت مختفية بيننا كل الحواجز التي أسمح لنفسي بنعتها بالسهلة الممتنعة.
ومشى بخطوة واثقة منه نحوي ومشيت بالمثل خطوة نحوه. ومد يده نحوي ومددت يدي نحوه. وكلمني بعيونه الناطقة وكلمته بعيوني المتفهمة. ومسكني من يدي وراح بي عابرا غرفة قاتمة، وصعد بي عبر درج حجري والضياء يكبر ويكبر من حوالينا، إلى أن وصلنا آخر درج وتواجدنا في حديقة بدائية لا شبه لحضارة معمارنا بها.
ومن يومها ونحن نعيش معا في عالمين مختلفين إلى هذه اللحظة، ولغة تفاهمنا وتجاوبنا وتغازلنا وتحابنا هي لغة بدائية حواسية خاصة بنا، لا نطق فيها ولا أبجدية. روحية تعتمد على التواصل النفسي، وإشارية حسية تعتمد على حواسنا الحسية الخمس. وعالم الحديقة البدائية، التي أطلقت عليها اسم حديقة عدن”، كانت تختلف عن عالمنا الدنيوي في نضارة عشبها الندي الذي لا يعرف الذبول، والحيوانات المختلفة كالبيزون، الثور الوحشي والحصان والنمر والأرانب، والطيور والفراشات من أغرب ما تكون في اختلاف ألوانها وخفة وشفافية أجسامها. ولكن الأكثر إثارة في هذه الجنة البدائية، دنو سمائها القزحية من أرضها، وقرب كواكبها الملونة بالحمرة والزرقة والخضرة، السابحة في هذه السماء القريبة كبالونات هائلة. أما أشجارها فكانت تشبه البيوت والأكواخ والمنازل. فمنها الطويلة الباسقة كباقات أغصان الصّبّار، ومنها الكبيرة كالسنديانات الوارفة الأغصان، ومنها المتوسطة الحجم كأشجار السرو الباكية، ومنها الصغيرة كالمظلات الشمسية، وأخرى من فصيلة سميتها بالمتنقلة، لأنها كانت كل ليلة تنتقل من مكانها المتواجدة فيه، وتصبح مع إشراقة شمس الصباح في أماكن أخرى. أما الأنهر والبحيرات ومجاري المياه، فكانت مياهها في تنوع وتبدل باستمرار، من ذهبي إلى فضي فرصاصي ولؤلؤي وصحاري وأخضر غامق. وكانت لها موسيقى أشبه ما تكون بالموسيقى الكلاسيكية، في تناغمها وانسجام إيقاعاتها ومحاكاتها لكل الأصوات التي تزخر بها الطبيعة.
لقد أصبح هذا الكوكب الغريب، هو الدنيا التي أتقاسم نصف حياتي مع آدميرو فيها، والنصف الآخر كنت أعيشه في قريتي كالمنسية. ولقد اكتشفت سر التنقل بين العالمين المختلفين، بفضل القطعة الحجرية التي كنت قد عثرت عليها بمدخل المغارة. لقد كان عليها رسم يد محناة بالحمرة، وكنت أتأملها ذات يوم، فساورتني فكرة وضع يدي على صورة اليد وإذا بي في جنة آداميرو. وحين جربت وضع يدي على الجهة الملساء، أي الخالية من الرسوم، وجدت نفسي من جديد في غرفة بيتي. ومن يومها أصبحت أستخدم هذه الوسيلة السفرية بين العالمين.
وقاطعتني آنستي الفاضلة:
– من أين تأتي بكل هذا الخيال العجيب يا أستاذي الفاضل؟
– من الوهم المتوقع مستقبلا يا آنستي الفاضلة.
– يعني؟
– يعني… حين نبتكر شخصيات حبرية ونجريها على الورق، تتحول بفعل سحر التأليف الروائي إلى حقائق تكاد تكون واقعية إن لم تكن.
– بمعنى؟
– كاتب مثل بلزاك ابتكر بوهمه أكثر من ثلاثة آلاف شخصية. كانت في البداية مجرد شخصيات حبر على ورق، ثم أصبحت بعد تداول الناس لرواياته، شخصيات حقيقية متداولة، لها قيمتها وشخصيتها وأسلوبها ودورها التاريخي. وهذا بالذات ما أسميه بالإبداع، مقاومة الموت بهذا التوقيع الروائي الذي يخلد صاحبه فيصبح في مصاف الخالدين.
– فخلدني يا شقيق روح بحبرك كيفما تشاء.
– أما يكفيك أن تكوني ساحر أو لُنْجَة أو آدَميرة؟
– أريد أن أكون غاليتك زنوبيا بالإضافة لهن وأكثر… نعم أريد بحبرك الخلود في قلبك كما في رواياتك، لقد قطعت عليك سردك المشوق فسامحني حبيبي.
وتابعت آدميرة من مذكراتها قائلة: ” لقد عشت مع آدميرو منذ التقيت به، وعمري آنذاك تسعة سنين، وهو ما بين الرابعة والخامسة عشر. وكبرنا من يوم لقائنا معا، وما زلت أعيش مقسمة بين عالمي وعالمه، بكل توازن نفسي وانسجام روحي وهدوء بال. بالطبع، إن القاسم المشترك بيننا هو الحدس البدائي الخالص، ولغة الحواس والحاسة الجمالية السادسة. وليس بيننا أية علاقة جنسية مادية، بل تواصل روحي يتجاوز في نشوته، كل شهوة وكل الملذات البشرية السريعة الزوال.
فنحن في كل لقاءاتنا قد نتجول يدا في يد، وقد نجلس جنبا لجنب، وقد ننام أو نستلقي على ظهرينا، متأملين في الكواكب السيارة بأعيننا، وبالأنجم المشعة كمصابيح شجرة عيد الميلاد الملونة. وهذا الكون المثالي وبكل ما حوى من عجائب بديعة الخلقة والصنع، جار بأعيننا وبأنفسنا، ولا حاجة لنا لعلوم بشرية ولا معرفة ولا كلام.
وأكبر تحول حصل لي في هذه المغامرة المنقطعة النظير، ما حصل لي عشية أمس. لقد كنت مستلقة إلى جانب آداميرو، حين أخبرتني حواسي بحضور روحاني غريب، وفجأة وجدت نفسي محاطة بدائرة بشرية، تتألف من بنات وأولاد ونساء ورجال، شديدي الشبه بآداميرو يرتدون ملابس من جلد البيزون لا غير. لقد كانت أسرة آداميرو حسب ما أخبرتني لغة حواسي. وتقدمت نحوي امرأة عليها وقار وهيبة، وكلمتني بلغة الحواس تدعوني فيها الالتحاق بعالمهم والتخلي عن عالمي بصفة نهائية.
ولم يبد على محياها أية علامة للتعجب حين تلقت جوابي بالإيجاب. بل خطت نحوي بتؤدة ومسكتني من يدي، ومشت بي متوسطة الحلقة الدائرية في موجة من التهاليل الروحية المنبعثة حسا من حاشيتها، وباركت انتمائي لأسرتها بمسحة من يدها البيضاء على جبيني. وفجأة انقطعت الاتصالات الحسية، وغمرت السكينة كل ذرة من هذا المكان، فسرّحَت يدي ودست يدها في جيب سترتي، وأخرجت منها القطعة الحجرية الأثرية، فمسحت اليد المرسومة عليها، وأخذتني بالأحضان فتوارينا عن النظر في أقل من رمشة عين.
ومن مصادفات الأحداث العجيبة في هذه الأثناء العجائبية الرهيبة، أنّ آدميرة وجدت في اليوم نفسه مسجاة على سريرها، ومذكرتها بيدها وقد فارقت الحياة. وكانت مساعدتها في شؤون متحف المغارة، ميموزا، هي أول من عثر عليها قبل الآخرين. وبدون علم من أحد، احتفظت بالمذكرة التي اكتشفت من بين أغراضها الشخصية، بعد وفاتها ببضعة سنين.
وبخط مختلف عن خط آدميرة، في آخر صفحة من المذكرة، أضيف هذا المقطع المكون من بضعة أسطر: “لقد كنت بمتحف المغارة كعادتي كل يوم ثلاثاء، وخيل لي بأن الأيادي المرسومة على الجدار قد بدأت تتحرك. وتأملت فيها لغاية ما استقرت حركاتها. وأول ما لفت نظري تبدل أماكنها التي كانت مرسومة عليها، بالإضافة إلى يد جديدة أضيفت إليها فأصبحت ثمانية وخمسون يدا عوضا من سبعة وخمسون… ألف ميم ياء”.
– لقد سحرتني… فلست أدري ماذا أقول يا شقيق الروح.. !
– حتى أنا أشعر يا حبيبة، بجوهر نفسي الحساسة واقعة بكل فضاءاتها الواقعية كما الوهمية الافتراضية تحت سحر هذه الموسيقى العتيقة، الموغلة في تاريخ طينة البشرية البدائي.
– وهذا التوقيع المكون من “ألف ميم ياء” ماذا يعني يا ترى ولمن هو؟
وملت نحو آنستي الفاضلة التي كانت متمددة قبالتي، وأخذتها بالأحضان برفق وحنان، وطبعت قبلة معسولة على شفتيها الظامئتين، ثم قلت لها:” هو ذا التوقيع… وهذا ما يعني يا حبيبة الروح…! ”
فؤاد اليزيد السني