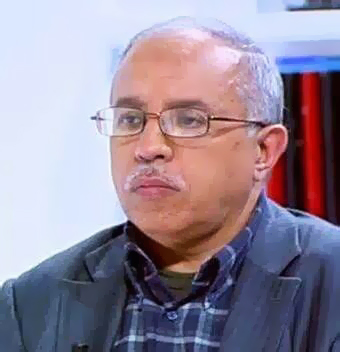العنوان أعلاه يذكرنا بالحزب السياسي المنشق عن جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية،وقد تزعمه الدكتور سعيد السعدي. بحكم موقعنا الجغرافي القريب من الحدود (الناظور) كنا نتتبع بحماس ما يحدث في الجزائر بعد الانتفاضة الشعبية أواخر الثمانينات على سياسة العسكر والحزب الواحد( جبهة التحرير الجزائرية ) ودخولها تجربة تعددية توجت بعودة المنفيين والمغتربين وعلى رأسهم حسين أيت أحمد،والافراج عن المعتقلين السياسيين بما فيهم أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية، بالإضافة إلى سماحهم لأول مرة بولوج الحركات الدينية إلى الحياة السياسية العلانية، خاصة جبهة الإنقاذ الإسلامية التي استغلت العمل الخيري في الأحياء المهمشة، ونالت إعجاب الغالبية بدورها التنظيمي في إسعاف ضحايا الزلزال الذي ضرب الجزائر، مما جعلها تستقطب شرائح مهمة من المجتمع الجزائري التواق إلى القطع مع النظام العسكري الحاكم حتى ولو كلفه الأمر التحالف مع الأسوء!! إذاك، كنا نأمل أن تصيبنا رياح التغيير للقطع مع سياسة الصناديق الانتخابية الخشبية التي كان إدريس البصري يتقن فبركتها وفق ما يؤتمر به.ما زلت اتذكر، إلى يومنا هذا، المناظرة التي جمعت عباس مدني زعيم الإسلام السياسي بالدكتور سعيد السعدي الذي برع في تعرية الفكر الأصولي المبني على الحلول الغيبية كجواب مطلق لجميع مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية… حين قال:” ياشيخ عباس، لا تقل لي أنك تمتلك مفتاح الجنة، فذاك شأنك.ما يهمني هو أن كانت لك مفاتيح للقضاء على الأزمة. ” طبعا الشيخ ناور، بلا فائدة،لتجاوز هذا السؤال الذي هو جواب ضمني. وكان إلحاح سعيد السعدي على الأولوية الثقافية، في نظرنا، ردة على الفكر اليساري الذي انتمى إليه، بل كنا نراه مجرد ليبرالي يستخدم الثقافة الأمازيغية على الخصوص، لما لها من أهمية في الوجدان الجزائري لبلوغ مأربه السياسية. ومع الإنتكاسة الذي عاشته هذه التجربة الديمقراطية أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، وما نتج عنها من عشروية سوداء راح ضحيتها الالاف بعد ما رفضت المؤسسة العسكرية الحاكمة العودة إلى الثكنات، وأيضا ما تلاه من سيناريوهات مزيفة للديمقراطية من خلال استعمال شخصيات مدنية كواجهة، متوعدة كل من سعى إلى تقليص دورها بمصير كمصير بوضياف( الرئيس المغتال).مرة أخرى، يعود سؤال أولوية الثقافة إلى الواجهة، خاصة مع فشل جميع التجارب الديمقراطية، أن لم نقل غيابها،في مجتمعات تعشعش فيها نسب الأمية المرتفعة. وبالعودة إلى واقعنا المغربي الذي شهد سلسلة من الخيبات للقوى التواقة للديمقراطية الحقيقية بسبب خطابها النخبوي الذي لا يمس الوجدان الشعبي الذي لا يفقه لغتهم، وزاده عزلة تواري شخصيات قيادية مخضرة بما لها من رمزية تاريخية إبان حقبتي الإستعمار وصدر الاستقلال. وفي العهد الجديد القديم، استحوذ بشكل مباشر أصحاب الثروة على الحياة السياسية نتيجة الزواج مع الدولة العميقة، علما أن جميع الديمقراطيات تحرم الجمع بينهما،وبات ينظر إلى المواطن المغربي مجرد رقم أو خزان يقتنى بثمن بخس أثناء كل محطة انتخابية عملا بمبدأ ” من لا قوت له،لا صوت له “.مما يجعل بعض الساسة يربطون المسار الديمقراطي الصحيح والنزيه بتحسين مستوى المعيشة للغالبية الفقيرة، لكنهم يتناسون أن الديمقراطيات الناجحة مبنية على الوعي الذي تفرزه الثقافة مثلما يفرز التعليم الجاد هذه الأخيرة. ولنا في تجارب الأمم المتحضرة دروس، لذا يستحيل الرهان على مشروع ديمقراطي في وسط أمي. وللأسف أضحت الأمية في وطننا العزيز بالشواهد ولا خجل ان تزعم اليوم المشهد السياسي البعض من رموزها.إننا في أمس الحاجة إلى ثورة ثقافية يعهد إلى الشباب،قاطرة المستقبل، بنشر أهدافها التنويرية من خلال الاحتكاك بالجماهير،وعبر تأسيس الجمعيات في الأحياء المهمشة والهامشية، واعادة الإعتبار للقراءة التي أضحت مستهدفة بسبب تبخيسها والتقليل بدورها الأساسي في توعية المجتمع.أن الوعي الذي تنتجه الثقافة المتنورة المنفتحة على الثقافات الإنسانية سيشمل منافعه كافة المستويات بما فيه الاقتصاد المعقلن الذي له أيضا أهميته في بناء الإنسان الكامل( ليس بمنظور التفوق النتشوي نسبة للفيلسوف نيتشه)،وإنما الكمال في المواطنة المبنية على الكرامة والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان.
بقلم: خالد قدومي