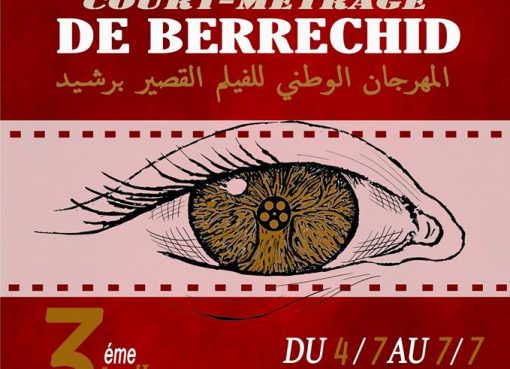الدكتورة سناء الشعلان، أديبة وكاتبة مبدعة، حرّة، جريئة تكتب قناعتها المزيّنة بلغة تغنيها ثقافة واسعة، وإنسانية عابرة لكل الحدو؛ نتاجها الأدبي والفكري يفيض ذوقاً وإحساساً، فكرتها ملكها؛ فهي لا تكتب إلَّا ذاتها، وكيانها القويّ المشروح الذي لا يعرف لليأس بابًا، كاتبة متفائلة وحالمة برغم ما يسود العالم من قبح. وبرغم ما تعانيه البلدان العربية من حرب وانتهاك وقمع. ما زالت د.سناء تقّف على خشبة مسرح الحياة، متحسسة آلام الناس ومعاناتهم، وتخوض مع قلمها ثورة على المسكوت عنه، وتصارع وتعطي للأشياء والمسميات قيمتها الحقيقية؛ فهي بذلك قد دأبت على تحدّي الواقع المتزمّت وفكّت القيود السياسية والاجتماعية والثقافية، ودأبت على أن تغدو كما الشّمس لأجل التغيير المستحق والوصول إلى الهدف السامي المنشود، فهي بركان من الأمل وشلال يذيب براثن اليأس، وفارسة تمتطي درب الكتابة لتقهر بحرفها الضغينة والجفاء والكراهية.
د. سناء كاتبة لا تضيع الكلمة بين يديها، فالكلمة تفوح من قريحتها كما العطر الذي يُعطر الزمان والمكان بشذاه النّديّ. صريحة وشفافة؛ فإنّ تحدّثت بدبلوماسية يزداد إيقاع كلماتها وضوحًا، فهي لا تخشى مطلقًا لومة لائم فيما تكتب، حيث تُوغِل في المناطق المجهولة، والأماكن القصيّة التي لم يطأها أحد من قبل بهذه الجرأة النادرة التي تناولت فيها الموضوعات المحظورة، والقضايا الخفيّة المسكوت عنها، مُعرّية إيّاها أمام الملء بحجج دامغة من دون خوف أو وجل. بدون حتّى أن تتوارى خلف أقنعة لا تناسبها. الواقع هو المادة الخام لأيّ عمل فنيّ مهمّا كان فانتازيًا. وواقعنا اليوم في العالم العربيّ أكثر سيرياليّة وخيّاليّة من أيّ مخيّلة، تلك هي رؤية الكاتبة الروائية الدكتورة سناء الشعلان، التي صدرت لها مؤخراً رواية “أدركها النسيان” وتبحث فيها الكاتبة عبر لغة إبداعية ثرية بإيحاءاتها وجمالياتها ضمن مغامرة تجريبية مضنية وجبارة واستثناء في الطرح والشكل واللغة البناءة التي تعاين المآسي البشرية وأزمة الإنسان المعاصر لا سيما في عالمنا العربيّ الذي يعيش في صراع على جميع الأصعدة سواء السياسية أم الاجتماعية أم الفكريّة.
فالكاتبة هنا تميّزت بعمق نظرتها وبتجلّي رؤاها، وكانت بارعة في تلخيص النّدوب والأوجاع بلغة سردية وشعرية جزلة وأنيقة. فقدمت خيبات الإنسان المكسور، في حال اختلاط الديني والسياسي والمجتمعي، من أجل صياغة مشهدية تدمي، وتحيل على أفق المفارقة، فمن جهة التطور الذي أحرزه الطب وسائر العلوم، ومن جهة مقابلة هذا الانحطاط العقلي المكرّس لسلطة الماضوية أو الرجعية التي يعشش فيها الدجل وتلبسها وصايا الشعوذة. ولأن “الأدب هو الدليل على أن الحياة لا تكفي” كما يقول فرناندو بيسوا، فقد جاءت الرواية سوداوية بأحداثها، وبما ما يحيط بشخوصها، ومفعمة بالحيوية والحركة ونجوم الحب “الأوريغامي” وهي نجوم تم اختيار كلماتها من أسطورة وثنية تعتقد أن النجوم هي أرواح من رحلوا عن الحياة ممن نحبهم، فهم يروننا من أماكنهم العلوية، وينيرون دروبنا ويضيئون سماواتنا. هي حتمًا مقولات زاخرة فلسفيًا وبمنظوراتٍ روحية أو روحانية دقيقة التصوير الذي يروم الإحاطة الدقيقة باللحظة العاطفية الصادقة، المفعمة بالعمق الفكري والرهافة الوجدانية. كأن الضجر اليومي المدبب يدفع بالكاتبة إلى شحذ الخيال بحثاً عن لغة خاصة تنجح في جعل الحياة جديرة بأن تعاش، وتستشرف أفقاً أبهى يعوّض أعطاب الوجود وخساراته. نجوم لا نملك إلَّا أن نقرّ بقدرتها على أسر قارئها منذ الوهلة الأولى.
وهذا ما كان جلّياً من الصفحة الأولى للرواية. تضع الكاتبة قارئها في مواجهة صور مرعبة وواقع إنساني مأزوم مصوّرة إيّاه بجرأة صادمة، متحدّية كلّ المقاييس باجتراح منحنيات تعبيرية مثيرة بسيرياليتها تارةً وبمزجها بين الخيال والواقع تارةً أخرى، مستندةً على تنوّع مدّها الإبداعيّ وعلى وقائع حقيقية ذاتية وغيرية، نعايشها ونعاين أبطالها ما بين الحين والحين الآخر، بحيث تجلّت متعة السرد في الحبكة الأساسية للرواية من حيث المضمون، فهي حبكةٌ واقعية إلى حدٍّ كبير، ونقصد هنا قصة الحب العادية بين بهاء والضَحّاك، وتقلباتها وأحداثها ونتائجها، لكن الرواية في مجملها عكست مهارة الكاتبة العالية في دمج الواقع بالخيال، هذا الدمج الذي تمثل في خلق شخصيات موازية تم توظيفها في بنية الرواية بصورة تدعو للتأمل والاجتهاد في التحليل.
وتتمحور حقيقة الحاضر، وتأخذ من الزمان والمكان والشخصيات والأحداث ما يناسب نسقها السردي الذي بدا سلسًا وعفويًا ومُقنِعًا إلى درجة كبيرة يؤكد تمكّنها من أدواتها الفنية بطريقة لا تقبل الجدل، ولعلَّ سرّ النجاح يكمن في إقناع القارئ بأنّ الوقائع والأحداث التي تجري أمامه كأنها حقيقية وليست من صنع الخيال. “عندما تحترق الأوطان يصبح العشق محرّما” “إنه اليتم في كل مكان” ثالوث العشق والوطن والـمَيتم: هي محاورُ متعالقةٌ، مترابطةٌ بُنيت عليها الرواية “فمن حُرِم الوالدان حُرّم عليه الوطن والعشق”.
ولأن رواية “أدركها النسيان” قدمت صورة الوطن الجحيم المنقلب على أبنائه، ولأن بطل الرواية “الضَحاك” وبطلة الرواية “بهاء” قد مرّا بظروف وتعرضا لانتهاكات داخل الوطن، ومن مؤامرات يتحمل وزرها المثقفين والمتدينين المذهبيين وتجار وفئات أخرى من طبقات مختلفة، من الذين شيّدوا لشعوبهم قصورا في الهواء، ملأوا جدرانها بالشعارات عن الحرية والعدالة الاجتماعية ومكافحة الإرهاب والفساد، وهي في الحقيقة قبض ريح. تتكئ الرواية على شخصيتين أساسيتين وهما:”بهاء والضحاك” فشخصية “الضحاك” الذي تاه في مدن الصقيع والثلج، لم يحتفظ فيها بحرارة الوطن داخله. فنراه مجدّدًا في مناسبات متعدّدة يصف الوطن بأقذر الأوصاف وأسوأ النعوت في ردّة فعل على حالة الضياع التي عاشها نظير حرمانه من والديه، ومن ملجأ آمن ومن وطن دافئ: “فمن حُرِم الوالدان حُرّم عليه الوطن والعشق، فالضحاك لفظه وطنه الوحش منذ أن كان قطعة لحم حمراء ملفوفة بغطاء قديم قذر، ليدفع به إلى دروب الضياع والتيه فقيراً يتيماً معدماً ومضطهداً. فقد استقرّ به المقام في بلاد الغربة والصقيع: كان عندها يشعر بالخوف والغربة التي تنخر عظامه فزعاً، أما الليلة في بلاد الاغتراب فلا يشعر بأيّ خوف وهو يسير وحده في هذا الدرب الضيق المعتم. فها هو يحدث نفسه على لسان السارد: الليلة لا يريد أن يتلو على نفسه سوى أحزانه التي اسمها ذكرياته والاغتصابات المتكرّرة في الميتم والشارع والمعتقل.
ثمّ نراه مرة أخرى يعيد التأكيد على أحقية الوطن الذي يستحقه والذي يسمه وطناً على الرّغم من أنه لم يولد فيه: فالوطن عنده هو الاحتضان والحب والاكتفاء، وهذا المكان قد احتضنه وأحبه؛ ولذلك فهو وطنه، أمّا تلك الخرائب القاسية في الشرق حيث يرتع اللصوص والقساة، فهي ليست أوطانا في نظره، بل إنها ليست أكثر من خرائب تاريخية قد سطا عليها لصوص عابرون للتاريخ. وإمعانا في براءته من الوطن ها هو “الضحاك” عندما استيقظ ذات صباح ومر طيف بلاده في قلبه: ثمّ تذكّر وطنه القديم الذي سلخه منذ زمن حيث عاش فيه حياة دون ملجأ أو مأوى، فبصق مراراً على الأرض تقززاً من هذه الذكرى التي شطبها منذ زمن من ذاكرته”.
ويتكرّر الفعل في مناسبات أخرى في الرواية: “أما تلك الجغرافيا القميئة التي تنكرت له منذ زمن طويل، فهو قد هدم صنمها في روحه، فالأوطان عندما تقسو على قلب المحب، وتتواطأ مع اللصوص والأفّاقين تصبح خائنة رخيصة لا تليق بالنبلاء”.
ويُعاد نفس الحدث في الرواية، ولكنّه جاء بصور مغايرة تصبّ في منحى واحد وفي نتيجة واحدة ومطلقة: “لا شيء سوى الموت والجعجعات والنقيق الموصول دون فائدة أو تحسن”. نلمس ذات القسوة والغربة والحدة فيما تقوله “بهاء” فهي قد تكون أشد حنقا وأقوى قسوة وأعمق مأساة عندما يتعلق الأمر بالوطن، “بهاء” التي بقيت رهينة الوطن لعدة عقود على عكس “الضحاك” الذي غادر الوطن في عمر مبكر. فتقول بعد أن تعرف عليها معلم اللغة العربية في الميتم “أفراح الرملي” : “منذ أن أصبحت لقمة سائغة مشتهاة في فم أفراح الرملي لم يعد يعنيني أيّ شيء حول الأوطان والمواطنين أو الأحداث أو المصائر. بل حتى لم يعد يؤرقني من أكون، أو إلى من أنتمي”. وبعد أن استقرّ بها المقام في بلاد الصقيع في رحلة العلاج، كان الوطن بالنسبة إليها مجرّد خبر خال من أيّ حنين أو اهتمام: كان الشرق يحترق برمته، وحواضره تتهاوى في النّار والمدن ترحل عن نفسها وعن أهلها.. القيامة قامت هناك منذ سنين طويلة.. لكني لم أكن أبالي بذلك كله، فتلك المدن قد رحلت عني منذ زمن، ولا قلب لي فيها ولا أمل، وما لها من محبة في قلبي حتى أبكيها، فأنا نبت شيطاني لا علاقة له بشيء هناك، لست أكثر من لقيطة ربيبة ميتم سرعان ما أدركت أن أوطان الشرق جميعها مياتم كبرى، لا كرامة فيها ولا حنان ولا أمل.
ما بعد النهاية صحيح أن الأوطان ليست كلها طيبة، وليست كلها جميلة وليست كلها ترحب بأبنائها أو تمنحهم الدفء والحضن الآمن، لكن على الأبناء أن يخلقوا الإيجابيات كي يبقوا فيها أو يعودوا إليها مهما طال الغياب، أوطاننا نحبها كثيراً، لكن لا نستطيع الجزم إن كانت تحبّنا أم لا؟ الكتابة عند الدكتورة سناء الشعلان، لا تنساق وراء الجاهزية في الكلام والقول، بل تجعل القارئ متورطاً وصانعاً للحدث في الآن نفسه، فضلاً عن تحميله المسؤولية المصيرية في الوجود والكينونة. كلّ التحية لأميرة الكلمة بهذا النور الذي يغمر الأرجاء، فهي روائية مؤهلة لأن تحتل مكانة مميزة في هذا العالم. فرواية “أدركها النسيان” رسالةُ اللّاغفران التي تُرسلها الدكتورة سناء الشعلان إلى عصرِنا، حول جحيمنا الأرضيِّ وضحاياه، وشقائِنا البشريِّ وصانعيه.
منذر اللالا/ الأردن