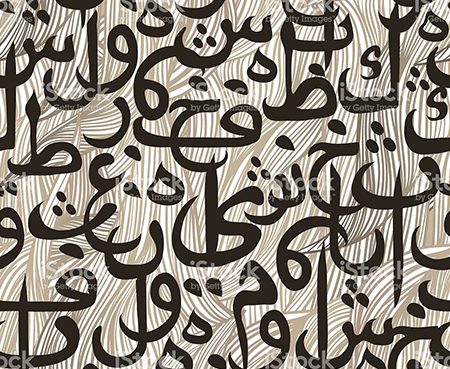«أتحدث عن المدينة .. أمنا التي تنجبنا وتفترسنا وتنسانا»
أوكتافيو باث
أرافقه إلى حيث يتسكع ويدخل في متاهة من الوجوه والطرقات ويخرج من متاهة أخرى. أنتظره في المقهى العتيقة الرابضة عند عتبة باب الفندق الرث الموحش الشرفات حيث يسكن في غرفته الباردة شتاءً اللاهبة صيفا. وما أن أفرغ من تناول الشاي حتى ألفاه قبالتي بشعره الأشعث وهو يعلق على إحدى كتفيه حقيبة سوداء مقشرة الجلد حاشرا فيها كيس المقبلات والزجاجة والكراس والقلم.
يبدو الانطلاق بمعية شاعر أشبه بالانطلاق مع الريح فكلاهما يتنافسان في التوغل في أعطاف المدينة، اختراق أزقتها ومن ثم التنزه على ضفاف النهر، وهو التقليد الذي اعتدته مع صاحبي الشاعر الصامت العصي على الفهم الذي لا تنقطع عيناه عن تأمل مشاهدة تمايلات الشجر وخصور الغزلان المنقوعة بمسك النظرات وترقرق مويجات النهر.
وصاحبي الشاعر تتملكه في بعض الأحيان خفة في الروح تجعله أمْيل إلى اقتراف المرح المداف بسخرية هادئة لاسعة في آن معا:
– الأشياء المضيئة ..
– ما بها؟
– إنها ترانا ..
أتساءل بإلحاف متعمد:
– ترانا أم نراها؟
– لا أدري .. اسأل مختصا بالفيزياء الضوئية!
كل واحدة من نزهاته المتكررة تختلف عن سواها. زار يوما محلا للانتيكات وعاد ببوق نحاسي أعطاه لمتشرد بارع في العزف طالبا منه ان يعزف بلغة العشب والأقحوان، للمتوحدات في ظلام الغرف، للشحاذين الذين يتوسدون العشب، للمتقاعدين ولجنود كراج بغداد، للعائدين من القتال او الذين لم يعودوا ..اذ ذاك سيمسون أكثر سعادة من قبل ..
وصادف يوما ان التقى عازفا أعمى فسأله ان يعزف للمدينة التي توشك على الاندثار، المدينة التي نحلم بها والتي نصنعها وندمرها، المدينة التي لا نغادرها الا لنسقط في مدينة أخرى مطابقة لها ومختلفة عنها..
يلتفت الشاعر نحوي وهو يقول مغمغما:
– المدينة امرأة .. تتفتح مثل وردة ثم ما تلبث ان تذوي ..
كان من الواضح ان صاحبي كان عاشقا للنزهات. يختمها في بعض الأحيان بقضاء ساعة في مخزن التحفيات، ركنه الأثير علّـه يعثر على لقية او كنز يجعل منه كائنا ثريا يهرب من مدينته الى مدن الدنيا ويعود الى أحضانها بعد طول سفر. لقد بدا الأمر وكأن قدميه لا رأسه هما اللتان تمليان عليه الترحل لهذه البقعة او تلك، فمرة في ساحة كانت فيما مضى دارا للسينما وتارة في بيت من بيوت الشناشيل بالبصرة القديمة، واجده بعد طول بحث مغادرا مكتبة (باش اعيان) وقد تعفرت اهدابه بغبار الزمن او متجولا في متحف الأحياء المائية او في قاعة القبة السماوية في الجامعة وكان وما زال زائرا مترددا على سوق الجمعة عله يظفر بديوان او مخطوطة شعرية.
شاخ الجميع.. المدينة والشاعر وأنا: المدينة توقفت عن أن تكون مثلما اعتدنا .. الشاعر بات اسما منسيا وانا الكائن الضائع بينهما ..
تبدلت عادات صديقي الشاعر .. صار يكتفي بمتابعة الأخبار من تلفاز المقهى، ولكنه عافه بعد ان اكتظت شاشته بدوي الانفجارات وقرع الطبول وبعد ان هرست سرفات الدبابات ما أخضلّ من العشب وما ينع من الأحلام وما شهدته المدينة من مشاهد قتل ونهب وتخريب في كل مكان. هجر المقهى وتلفازها المثرثر مقتنيا جهازا خاصا واتى بمجموعة من افلام المغامرات والرسوم المتحركة وأدمن عليها.
لم انقطع كغيري من الاصحاب عن زيارته .وقد أخذت الحظ، في الآونة الأخيرة ،أمرا مؤسفا انه أمسى كثير النسيان لأدرك جازما انه دخل المراحل المبكرة لمرض الزهايمر.
علق واحد من رواد المقهى حين اعلمته بوضعه الصحي الحرج:
– ما هذا؟! ان المدينة تفقد ذاكرتها!
في زيارتي الاخيرة فوجئت به جالسا عند طاولته وقد ارتدى أعطر ما لديه من ثياب وحلق لحيته وسرح شعره.
ما ان أبصرني حتى بادرني بالقول:
– كنت في انتظارك .. نخرج اليوم ..
– لكن ..
– لا تسأل كثيرا .. انها نزهتنا المؤجلة ..
سرت خلفه مكتفيا بالصمت اصطخابا. اكترينا سيارة أجرة عبرت شوارع وجسورا وتقاطعات مبللة بماء المطر تحت سماء رصاصية ملبدة. سمعته يشير للسائق:
– ننزل هنا .. أمام مقبرة الأطفال ..
لبثت صامتا ومندهشا لهذه النزهة المباغتة. تضاعفت دهشتي حين سألني ان انتظره عند باب المقبرة:
– سأقوم بزيارة اختي الصغرى .. ماتت في أحد التفجيرات ..
اخذ مطر غزير بالهطول فيما ازدادت الغيوم كثافة. دفعت بوجهي أسفل ياقة سترتي ملقيا نظرة على القبور المبثوثة على سفوح التلة محملقا في الأفق الخلفي حيث سور المقبرة الجنوبي باحثا عنه .. دونما جدوى. كان صاحبي الشاعر قد توارى خلف القبور.
انتظرته طويلا لكي يعود ..
لكنه لم يفعل .. !
عند البوابة
ما زلت انتظر
حتى هذه الساعة
أن يعود!
محمد سهيل أحمد