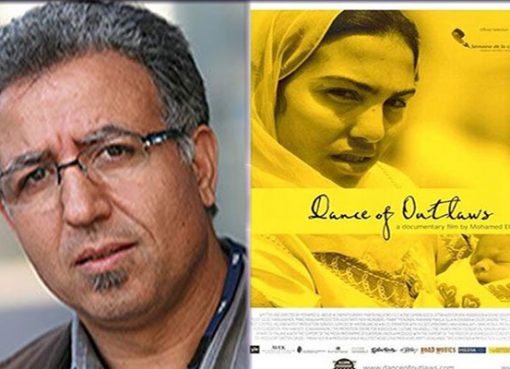بدأت شهرة المفكر والروائي باسكال بروكنر وأصبح يتدخل في وسائل الإعلام بشكل مكثف بعد نجاح ثالث كتبه الصادر سنة 1983 تحت عنوان مثير: «نحيب الرجل الأبيض / العالم الثالث، الشعور بالذنب، كره الذات» الذي هاجم فيه الشعور بالذنب المترسب حسبه لدى الغربيين تجاه بقية العالم والعالم الثالث على وجه الخصوص. وقد عاد إلى نفس الموضوع في كتاب آخر سنة 2006 عنونه «طغيان الكفارة /بحث في المازوخية الغربية» وقد نال الكتاب جائزة مونتاني. يعتبر باسكال بروكنر اليوم من المفكرين الذين يسبحون ضد التيار كما تبين أعماله الكثيرة الناقدة للإيديولوجيات المهيمنة في فرنسا كنقده للفكر الإيكولوجي السائد في كتابه «التعصب لفكرة نهاية العالم / إنقاذ الأرض، عقاب الإنسان» ونقده اللاذع لمفهوم السعادة المفروضة في الغرب في مؤلفه «الغبطة الدائمة /أبحاث عن واجب السعادة» وتحليله لزواج الحب في «هل فشل زواج الحب؟» وغيرها من العناوين الصادمة للوعي اليساري المسيطر في فرنسا كان آخرها «حكمة المال» الصادر في بداية أبريل 2016.
أصدرت منذ 33 سنة «نحيب الرجل الأبيض» هل كف عن النحيب أم لا يزال ينتحب؟
لا زال الرجل الأبيض ينتحب ولكن بطريقة مغايرة وذلك حسب جنسيته فلا ينتحب الفرنسي مثلما ينتحب الأمريكي أو البولوني.. فلم يعد هناك عالما ثالثا مخلصا كما كان الأمر منذ أكثر من 30 سنة، بل يوجد اليوم بلدان صاعدة بعضها كالهند والصين والبرازيل ونيجيريا أصبحت تنافسنا بشكل مباشر وترتقي إلى مصاف الأمم الكبرى. وما يمكن قوله باختصار هو أن المرحلة ما بعد الكولونيالية تركت شعورا عاما قويا بالذنب في أوروبا الغربية أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.
في كتابك «طغيان الكفارة»، ترفض أن تجعل الغرب مسؤولا عن بؤس العالم. هل هو برئ تماما؟
لا طبعا، الغرب مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي ارتكب في حق غيره و ليس المقصود من كتابي طغيان الكفارة تبرئة ذمته مما ارتكب من شرور وجرائم. ولكن أن ننسب إلى الغرب كل ما هو شر في العالم، من الاحتباس الحراري إلى الفقر والبؤس في إفريقيا فذلك لا أكثر ولا اقل إطلاق للكلام على عواهنه ورفع كل مسؤولية عن الشعوب الأخرى. وفي المحصلة هو جعل الغرب كبش فداء سهل ومريح.

أنت من المفكرين القلائل الذين يثنون على الغرب جهرا في وقت يعتبره أغلب المثقفين الفرنسيين امبراطورية الشر. هل هم مازوخيون؟
المازوخية هي أيضا امبريالية معكوسة، هي وسيلة لتضخيم حجمنا الهزيل ليضاهي كوكب الأرض. والحقيقة أن قدرة تدخل الأمم الغربية قد باتت ضئيلة جدا، فلم نعد أسياد العالم، وهذا ما لم يستطع الكثيرون هضمه وقبوله. نحن لا نفرض إرادتنا لا في موسكو ولا في بكين ولا نيودلهي ولا لاغوس ولا برازيليا ولا أنقرة ولا إسلامباد… ولكن يبقى أن العالم الأوروبي هو الذي أبدع الحداثة، بمعنى مشروع انعتاق الإنسانية. وما يمكن أن يعلمه بشكل جيد للمجتمعات الأخرى هو واجب التفكير ضد نفسها عبر انتشار الأنظمة الديمقراطية والإعلام الحر والتعددية السياسية…
تكمن مأساة الغرب اليوم حسب الفيلسوف مارسال غوشي في أنه أصبح عاجزا كليا عن التفكير في الدين، لقد أصبح الدين غير قابل للفهم كبنيان لكل المجتمع. ما هو تحليلك؟
الفكرة، في الحقيقة، ليست من ابتداع مارسال غوشي وإنما جاءت في أول كتب المستشرق برنار لويس كما نجدها أيضا لدى المستشرقين الشهيرين لويس ماسينيون وحتى جاك بيرك، وهما من أكبر المختصين العارفين بالعالم العربي. وبغض النظر عن مصدر فكرة عجزنا عن تعقل الدين اليوم في الغرب، فهي صحيحة تماما إذ كنا نعتقد في الغرب و ربما لا يزال معظمنا وإلى هذه الساعة يعتقد أن الدين قد بات متجاوزا في حين أنه يبقى دائما هو المهيكل لمعظم المجتمعات الإنسانية. أصبحنا كالصم البكم بسبب جهلنا للمجتمعات الأخرى غير الغربية.
هل تتفق مع الباحث في الإسلام أوليفييه روا حينما يقول بأن الأمر ليس تطرف الإسلام وأنما أسلمة التطرف؟
يحاول أوليفيية روا وأحيانا بذكاء كبير أن يتملص من ضرورة ممارسة العقل النقدي تجاه الدين الإسلامي. في هذا المجال يبدو لي أن نظرة جيل كييبل أكثر أهمية لأنه معرب وذو معرفة كبرى بالعالم الإسلامي. لننظر إلى مسألة التطرف من زاوية أخرى مخالفة لنظرة أوليفييه روا إذا سمحت؟
نعم.. تفضل
إذا اتجه التطرف نحو الإسلام، ألا يعني هذا أنه مناسب لذلك وأرض خصبة لمثل هذا النوع من الظواهر وأن فيه ما يجذب ويغوي العشرات من الشبان من مختلف أنحاء العالم ليتخذوه أساسا للسلوكات التضحوية العنيفة؟
والجواب؟
لا الدولة الإسلامية (داعش) ولا القاعدة تدعيان أنهما ينتميان إلى عدمية القرن التاسع عشر الروسية على سبيل المثال! لكليهما نظرة تدميرية مستمدة من قراءة معينة للقرآن. لا أحد من أنصارهما أشار يوما إلى روايات تورغينيف أو دوستوفيسكي. للعثور على وجه تشابه ينبغي بالأحرى البحث من جهة البدع المسيحية التي انتشرت في القرون الوسطى. وربما يمكن إيجاد صلة للعنف الإسلاموي اليوم مع عنف الملل والطوائف البروتستنتية بالأمس. ونلاحظ لدى داعش أيضا التأثير المزدوج، الفاشي والشيوعي. فاعتبار التطرف الأصولي عدمية هو في الحقيقة رد المجهول إلى المعلوم. ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن ننكر أن هؤلاء الشبان المتطرفون الغربيون هم أيضا مفتونون بالاستهلاكوية ومن ضحاياها. الأديداس والرسول، هوليود وإرهاب الجماهير.

هل لديك فكرة عن الفكر العربي المعاصر وهل تعتقد بأن المثقفين العرب يقومون بدورهم على أكمل وجه في مواجهة التطرف؟
أعرف وأقرأ لبعض المثقفين من العالم العربي الإسلامي الذين يحاولون بشجاعة ونفاذ بصيرة التصدي للأصولية الزاحفة على مجتمعاتهم. ولكن ما يحزنني حقيقة هي تلك الدرجة من اللامبالاة والازدراء التي تلاقي أعمالهم من طرف انتليجنسيا اليسار في كل البلدان الأوروبية.. هذه الانتليجنسيا التي تركع أمام مجانين الله وتتجاهل أو تحتقر المفكرين المتنورين الأحرار. فما حدث للروائي الجزائري كمال داود أخيرا، بعد ما جرى للروائي الشهير سلمان رشدي وكذلك أيان هيرشي علي، إرشاد مانجي، وتسليمة نسرين هو ذو دلالة في هذا الصدد.
هل يندمج الإسلام في رأيك يوما في الثقافة الأوروبية؟
السؤال بصفة عامة هو هل يمكن للإسلام أن يسير على خطى المسيحية، بمعنى المرور بذلك الإصلاح الداخلي الذي بدأته الكنيسة في روما زمن النهضة والذي استمر مع الإصلاح البروتستنتي، الأنوار، الثورة والوصول أخيرا إلى قوانين الفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا سنة 1905؟
وهل هذا ممكن في رأيك؟
لقد لجمنا في الغرب جماح المسيحية وأخذ منا ذلك من الوقت قرابة أربعة قرون كاملة. فكم يلزم من الوقت للإسلام ليصحح نفسه، ليتلاءم مع الحداثة، هذا إذا فرضنا أنه سيسلك طريق المسيحية. لكن ما أثار دهشتي هو أمر مر عاديا جدا ولم يثر تساؤل أحد في الغرب إذ بينما ترجمت كل الثورات في أوربا أو أمريكا اللاتينية إلى تهديم الكنائس أو المعابد وقتل رجال الدين، رموز القمع الممقوتة، لم يهاجم ولم يحرق المتظاهرون مسجدا واحدا أثناء الربيع العربي. إنه فرق ثقافي يسترعي الانتباه في مقاربتنا للثورة.
هل تعتقد، كما يرى كثيرون، أن أوروبا هي في طريق الانتحار إذا لم تعد النظر في فهمها للخطر الإسلاموي الذي يحدق بها؟
لقد أبان الخطر الإسلاموي نقاط ضعفنا، هو كاشف لعوراتنا بقدر ما هو تهديد لمجتمعاتنا. و هو ليس أشد خطرا من الهجرة ولا سبب هو مشكلاتنا. من بين مشكلاتنا بعض الغطرسة، والاعتقاد أن أوروبا تمثل مرحلة التاريخ النهائية وأن على العالم كله أن يحذو حذوها ويقلد مثالها. وهو تعبير فصيح عن المركزية الإثنية العمياء. وعلى عكس ما هو حاصل في الولايات المتحدة الأمريكية المدفوعة دائما بمشروع وطني- ديني يضمن تلاحمها وتماسكها كأمة «مختارة»، استسلمت أوروبا كلها إلى مسرات الاستهلاك الواسع والرفاهية ورغد العيش.
وأين دور الاتحاد الأوروبي من كل هذا؟
الإتحاد الأوروبي هو مجرد سوق ضخمة بدون مشروع سياسي ولا حكومة ولا جيش ولا حدود ثابتة. على الأورو، العملة الأوروبية، نجد أقواسا وجسورا وأبهاءا تعبر ولو بشكل غير مقصود عن هذا الإتحاد المجرد البعيد عن الواقع. ما يحرك هذا المجموع الواسع المكون من 500 مليون نسمة، هو إيديولوجية التسامح التي تستقبل كل الناس بما فيهم ألد أعداء التسامح والمساواة وحرية التعبير…
هل يمكن أن تترجم الفكرة إلى لغة سياسية؟
نحن نسبح اليوم، في الغرب وفي أوروبا بصفة خاصة، في تناقض تراجيدي: نحن نتأرجح بين يسار مغتبط سعيد يريد أن يحمي كل الاختلافات باسم مناهضة العنصرية ويمين متطرف شعبوي يدعو إلى التقوقع وغلق الحدود.
«نحن الحضارات، نعرف الآن أن مصيرنا هو الزوال». يتفق الجميع مع عبارة فاليري الشهيرة، يقول ميشال أونفري ولكن لا أحد يريد استخلاص النتائج. هل الغرب في طريقه إلى الزوال؟
نعم، يمكن أن تموت الحضارات أو تدخل في مسار واسع من الانحطاط قد يدوم قرونا طويلة. في بعض الأحيان ينتابني شعور بالخوف جراء ما ألاحظه في فرنسا من أهوال: بلد يسير على غير هدى، تنخره الفوضى، الإضرابات، البطالة، غياب السلطة، نخبة سياسية بلا طموحات، جماهير ضائعة، متروكة لحالها، لف النسيان تقاليدها. في الحقيقة، يحزنني ملاحظة الإمكانيات الهائلة الضائعة في فرنسا. يمكن أن تكون أوروبا كاملة قد فقدت العزم والإرادة والرغبة في صنع التاريخ. في هذه الحالة، فإننا سوف نختفي من المشهد العالمي لصالح إمبراطوريات تعيش في صحوة كاملة مثل روسيا، الولايات المتحدة، الهند، الصين دون أن ننسى قارة إفريقيا التي ينتظر أن تقوم بدور أساسي خلال القرن الحادي والعشرين. «لا يمكن لأية قوة أن تدمر روح شعب سواء من الداخل أو من الخارج، يقول الفيلسوف هيغل، إذا لم يكن هو ذاته قد فقد الحياة، إذا لم يكن قد هلك فعلا».
حاوره بباريس حميد زناز